يعيش الإنسان في الحياة الدنيا وهو بحاجة إلى كثير من الأمور التي يؤديها ليحسّن معاشه وعيشته وتطييبها، وهو مطلب استراتيجي يسعى وراء تحقيقه الإنسان لاحتياجه الدائم إليه، فهو مطلب في غاية الأهمية، لأنه يشتمل على أصول وقواعد صناعة الحياة، وهو أمر مصيري يبنى على سلوكيات الإنسان التي تعني أعماله وردود أفعاله في الموضوعات المختلفة والتي منها صنع تاريخه وتاريخ أمته، ومن هنا لا يمكن إهمال هذه الأصول والقواعد، فأسباب الرقي والتطور والتقدم مرهونة بها.
وليس فقط هذا هو سبب الاهتمام، بل أن سبب الاهتمام أيضاً هو يكمن في أن صورة الحياة الدنيا هي نفس الصورة التي تنعكس وتتجسد في الحياة الآخرة وهي الأهم على الاطلاق، فقد قيل عن الدنيا أنها مزرعة الآخرة[1]، فهي ((... خلقت لغيرها ولم تخلق لنفسها)) كما يقول الإمام أمير المؤمنين(عليه السلام)[2].
وسبب أهميتها على الإطلاق ذكر في سؤال يزيد بن سلام الذي وجهه إلى رسول الله الأكرم محمد(صلى الله عليه وآله) قائلاً: لم سميت الدنيا دنيا؟ فقال(صلى الله عليه وآله): ((لأن الدنيا دنية خلقت من دون الآخرة، ولو خلقت مع الآخرة لم يفن أهلها كما لا يفنى أهل الآخرة))[3]، قال: فأخبرني لم سميت الآخرة آخرة؟ قال(صلى الله عليه وآله): ((لأنها متأخرة تجئ من بعد الدنيا، لا توصف سنينها، ولا تحصى أيامها، ولا يموت سكانها))[4].
لذا ومن هذا المنطلق كان سعى الإنسان العاقل دائماً في أن تكون صورة حياته الدنيا بأحسن وجه لتكون آخرته بأحسن وجه، وتكون أفعاله وردود أفعاله حسنة فيها لتكون نتائجها حسنة أيضاً، وهي مرضية لله تبارك وتعالى لا لهوى النفس ولا الناس، وهذا هدف يجب وضعه نصب أعيننا، (العمل لإرضاء الله تبارك تعالى وليس الناس بناء لشكل وصورة آخرته)، إذ يقول سبحانه وتعالى: {وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّٰتِ عَدْنٍ وَرِضْوانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}[5].
وقد جاء عن النبي الأكرم محمد (صلى الله عليه وآله) في ذلك الموضوع: ((من كانت نيته الدنيا فرق الله عليه أمره وجعل الفقر بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت نيته الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمه))[6]، فالمكان الجزائي في الآخرة يمثل رضا الله تبارك وتعالى.
كما ورد فيه أيضاً عن الإمام جعفر ابن محمد صادق عترة آل محمد(عليه السلام): ((من أراد الحديث لمنفعة الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب، ومن أراد به خير الآخرة أعطاه الله خير الدنيا والآخرة))[7].
ومما مضى يفهم أن نيل الآخرة المرضية عند الله تبارك وتعالى، ومصداقها أن نكون مع النبيين(عليهم السلام) والشهداء والصالحين يتوقف على عنصرين مهمين، هما:
1- إحراز رضا الله تبارك وتعالى عن الأعمال المؤدات.
2- صحة الأعمال في الدنيا بالاستفادة من الأسباب المحللة، وسلامتها وصحتها بتحقق نتائجها المثمرة التي تنفع الفرد نفسه وتنفع الناس.
وكلاهما مهمان، لكن الرضا أهم، إذ لا تنجز الأعمال بدونه، حيث يمكن استشعاره في الأعمال التي ننجزها في حياتنا الدنيا بكثرتها ووسعة أدائها في المساحة الزمنية والقدرة المكانية بالإضافة إلى جودتها ومتانتها ووسعة تأثيرها، وهذا كله يتم تحت مسمى التوفيق لأداء الأعمال.
وهنا يلزم النظر في جملة من الأمور المساعدة على الفهم والتوضيح في كيفية اختيار الأعمال والأفعال المنتجة الصالحة والتي تصنع تاريخ الإنسان المزهر وتبني آخرته الخالدة ونتفكر فيها، وهي:
أولاً: ما هو التوفيق
التوفيق: كلمة اشتملت على الحروف الأصلية التالية: (الواو والفاء والقاف): وهي حروف تشكل كلمة تدل على ملائمة شيئين[8]، ومعناها أن يُعينك الله تبارك وتعالى على ما تقصد، ويعينك على ما ترغب، ويعينك على الوصول إلى ما فيه صلاحك، إذ شُرِط في هذا التطابق، التطابق بين إرادة الفاعل ونيته وإرادة الله تبارك وتعالى وحبه لما يريد فعله الفاعل من الأفعال والأعمال، وقيل في معنى التوفيق أنه: الإصابة والنجاح والرشاد والإصلاح[9].
أما التوفيق اصطلاحاً فهو: لطف من الله للعبد والذي يعني تسهيلُ طريق الخير، وبعبارة اُخرى: جعل الله تعالى قول العبد وفعله موافقين لأمره ونهيه، حيث قال الامام جعفر ابن محمد الصادق(عليه السلام) في قوله تعالى على لسان نبيِّ الله شُعَيب(عليه السّلام): {... وما تَوفيقي إلاّ باللهِ}[10]: ((إذا فعَلَ العبدُ ما أمَرَه اللهُ عزّ وجلّ به من الطاعة، كان فعلُه وفْقاً لأمر الله عزّ وجلّ، وسُمِّيَ العبد به مُوفَّقاً.. ))[11]، وبخلافه يكون الخذلان، لذا قالوا أن التوفيق كلمة تُطلق في مقابل الخذلان.
ثانياً: من يعطي التوفيق
يتبين مما مضى أن التوفيق ضروري في الأعمال في الحياة الدنيا، لذا يلزم الحصول عليه، فمن أين نأتي به ومن الذي يعطيه؟
إذ أن كثيرٌ من الناس يعتقد ويتوهَّم أنه بذاته مهديٌّ برشده وعقله، أو أنَّه إنَّما حصل على هذا المال مثلاً بجهده وعنائه وكدِّه وكدحه، وأنَّه إنَّما وصل إلى هذا الموقع لأنه قد بذل ما يحقق الوصول إلى المطلوب فوصل، وهو أهلٌ لذلك، ولكن بالالتفات إلى ما سبق من بيان معنى التوفيق نلحظ أن التفكير بهذه الطريقة قد غفل عن هذه الحقيقة، وهي: (أن الأفعال والأعمال التي أُديت لا تتيسر لنا إلَّا بعونٍ خارجي من صاحب القدرة والسلطة المهيمنة، وهو: الله(عزّ وجلّ)، وشاهدنا على ذلك قول الإمام موسى ابن جعفر الكاظم(عليه السلام) في حديث مع واحد من الناس: ((قد يكون الكافر أقوى منك، فتُوفَّق للعبادة، ولا يُوفِّق هو لها))[12]، وواضح أن التوفيق من الله(جل وعلا).
ثالثاً: أُس التوفيق
إذا لاحظنا الأعمال التي نوفق لها وفيها وحللناها نكتشف ما يلي:
(أن التوفيق في هذه الاعمال يرجع سببه إلى أن الإنسان لا يعتمد على الأسباب الظاهرية والمادية فحسب، إذ لا يمكن إنكار قانون العلية فيها، بل يعتمد على سبب آخر يلزم اكتشافه، وهو ببساطة: (الدعم الغيبي من الله سبحانه وتعالى)، ففي حديثٍ كان بين الإمام الكاظم(عليه السلام) وبين أحدٍ من الناس خير شاهد على ذلك:
تقول الرواية: سأل رجلٌ الإمام موسى ابن جعفر(عليه السلام): (أليس أنا مستطيع لما كُلِّفت؟)، فقال له الإمام(عليه السلام): ((ما الاستطاعةُ عندك؟ قال: القوة على العمل، قال له: لقد أُعطيت القوة إن أُعطيت المعونة، فقال الرجل: وما المعونة؟ قال له: التوفيق))[13].
ومن هذه الرواية نستكشف أن التوفيق في الأعمال يستند إلى إس ثاني هو المعونة الإلهية، وعليه يكون أس التوفيق ثنائي القطب هما:
1- أن يعتمد الفاعل على الأسباب الظاهرية والمادية المحكومة بقانون السبب والمُسبب.
2- أن يعتمد الفاعل المعونة الإلهية.
رابعاً: فلسفة التوفيق
إن النتائج النهائية الحتمية التي يصل إليها الإنسان في الأعمال من حيث العلة والمعلول لإدارة حياته اليومية، غير كافية وغير مستوعبة للحياة الدنيا بحسب القدرة والجهد البشري الذاتي، وقد لا تحدد الأعمال المنجزة بحدود الشخص الذي قام بها، بل تتجاوز دائرته الشخصية، فقد تكون نافعة له، وقد تكون نافعة له ولغيره، أو نافعة له وضارة لغيره، أو تكون ضارة له ولغيره، فتكون عند ذاك مصائب قوم عند قوم فوائد، أو المصيبة واحدة، وهو ما لا يرضى عنه الله تبارك وتعالى بعدله، لذا ولكي نتفادى هذه النتائج نسعى لتجاوز ذلك بمعونة خارجة عن قدرتنا، فقدرنا هي التي سببت الضرر بنسبته ونوع العمل المؤدى، ولا يمكن أن تكون الخصم والحكم في آن وحد، وسعينا يتركز على كسب التوفيق لاختيار الاسباب المنتجة الصحيحة وتطبيقها بأفضل وجه يؤدي المطلوب، وهذا لا يتم إلا بحصول الرضا الإلهي بالأعمال المنجزة والذي يفتح لنا الأبواب في العلل وجودتها ودقتها وحسن آثارها، من خلال فتح أبواب لأعمال أخرى تستوعبها الحياة الدنيا، وبذلك يكون عمر الإنسان مليء بالعمل الصالح النافع والذي يتجاوز مدته الزمنية وحدوده المكانية وقدرته وقوته.
خامساً: التوفيق لا يخرج عن قانون العلية
لا يخفى أن العلاقة التي تحكم نظامَ الوجود، هي علاقة العلة والمعلول، وهي: الأسباب والمسببات، ولولا مبدأ العلية وقوانينها، لما أمكن إثبات الواقع الموضوعي الخارجي، ولا أي نظرية من نظريات العلم وقوانينه، ولما صح الاستدلال بأي دليل كان في مختلف مجالات المعرفة البشرية ومنها الموضوع الذي نحن بصدده(التوفيق)، فأعمال الإنسان المادية والمعنوية لا تخرج عن حاكمية قانون العلية وهو قانون الفطري، والذي يعني توقف العلة على معلولها، أو السبب والمُسَبب، وهذا القانون ساري في كل شيء، في القضايا والأعمال المادية والمعنوية، ومنها المعونة الإلهية أو التوفيق، الأمر الذي يعني أن للتوفيق أسباب توجب الحصول والمنحة من الله سبحانه وتعالى، لذا فإن من يرغب في تحقق المعونة في أعماله المنجزة عليه أن يهيأ أسبابها.
سادساً: الأعمال التي توجب التوفيق الإلهي
بناء عل النقطة الرابعة ولأجل الحصول على الفائدة المرجوة من الأعمال المنجزة، لابد لنا من تقصي الاعمال التي توجب التوفيق من الله تبارك وتعالى وتعد سبباً لحصولها، لأنه الجهة الوحيدة التي تختص بهذا الامتياز، وهي:
1- تجنب مجموعة العوامل التي تسلب التوفيق، وهي: عدم تصور الذنب، عدم التفكير بالذنب، عدم فعل الذنب.
2- إيكال ما لا يقدر عليه الإنسان إلى الله تبارك وتعالى.
3- عدم الانغمار في الدنيا المحللة، فالانغمار يبعد عن التوفيق.
4- بر الوالدين، وهو من أهم الأسباب.
5- الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون موفقاً.
6- الارتباط بالنبي وأهل البيت(عليهم السلام)، خصوصاً الإمام الحسين(عليه السلام) والإمام الحجة(عجل الله فرجه الشريف).
7- دفع الصدقة المستحبة.
8- أن يصل الإنسان رحمه وهي من الأسباب المهمة للتوفيق.
9- العيش مع الناس الموفقين وترك غير الموفقين والعيش معهم بقدر الضرورة.
10- قضاء حوائج الإخوان ومساعدة الآخرين خصوصاً إذا كانوا مؤمنين.
11- المطالعة والقراءة في تاريخ الموفقين.
12- التصميم على أن نكون من الأفراد الموفقين.
وخلاصة الأمر أن التوفيق حاجةٌ دائمةٌ في كلِّ الأمور، وبه أكون موفقاً في الحياة، إذ أن في كثير من الحالات يغفل فيها الإنسان فيها عنه، وبسبب ذلك يبتلى بكثير من الأمراض التي تسبب له تعاسةٌ في الحياة: كالكِبْر وهو من أسوء الأمراض النفسية، والعجب وهو من أسوء الأمراض النفسية أيضاً، وعدم استشعار التوكُّل على الله سبحانه وتعالى، وعدم استشعار الحاجة إلى التوفيق، وكلُّ هذه الأمور تُنتج البعد عن الله(عز وجل) فيقل التوفيق ويتلاشى، حيث يقع فيها الإنسان نتيجة الغفلة عن الحاجة إلى التوفيق الإلهيّ.
لذلك يجب أن يستشعر المؤمن، ويلقِّن نفسه بشكل دائم أنه بحاجة إلى المعونة الإلهية سواء كان ذلك في عظائم الأمور أم في صغائرها ومحقَّرَاتها، من أجل الاعتياد على تهيئة الأسباب لجلبها وتحقق وقوعها، فقد ورد عن رسول الله محمد(صلى الله عليه وآله): ((سلوا الله عز وجل ما بدا لكم من حوائجكم، حتى شسع النعل فإنه إن لم ييسره لم يتيسر))[14]، وجاء فيما أوحى الله إلى النبي موسى(عليه السلام): ((يا موسى، سلني كل ما تحتاج إليه، حتى علف شاتك، وملح عجينك))[15].
الهوامش:-----------------
[1] بحار الأنوار، محمد باقر المجلسي، ج ٦٧، ص: ٢٢٥.
[2] نهج البلاغة، الحكمة: ٤٦٣.
[3] بحار الأنوار، محمد باقر المجلسي، ج57، ص: 356.
[4] نفس المصدر.
[5] سورة التوبة: 72.
[6] مجمع البيان ج ٩ ص ٢٧.
[7] أصول الكافي، محمد ابن يعقوب الكليني، ج1، ص: ٤٦.
[8] معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: محمد هارون، ج6، ص: 128.
[9] الفروق اللغوية : ابو هلال العسكري : ص 464 .
[10] سورة هود: 88 .
[11] التوحيد : الشيخ الصدوق : ص 242 .
[12] بحار الأنوار – العلامة المجلسي – ج ۵ ص ۴۲٫
[13] بحار الأنوار – العلامة المجلسي – ج ۵ ص ۴۲٫
[14] بحار الأنوار، محمد باقر المجلسي، ج 93، ص: 295 و303.
[15] نفس المصدر.







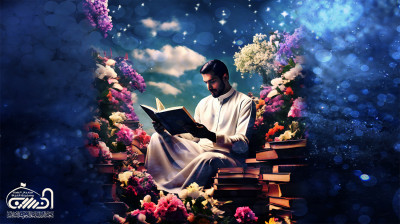













اترك تعليق