لتشملنا العناية الإلهيّة يتحتم أن نكون دائماً في حالة تأهّب وترقّب وحالة من اليقظة
العلاقة مع الله تعالى لابُدّ أن تكون وفق ما يريد الله جلّ شأنه
النص الكامل للخطبة الاولى
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على محمد وعلى آله الطيّبين الطاهرين، الحمد لله المعروف من غير رؤية، الخالق من غير رويّة، الذي لم يزل قائماً دائماً إذ لا سماء ذات أبراج، ولا حجبٌ ذات أرتاج، ولا ليلٌ داجٍ، ولا بحرٌ ساج.. إخوتي أبنائي آبائي زادكم الله إيماناً وتقوى، أخواتي بناتي أمّهاتي ألبسكنّ الله تعالى لباس الحياء والعفّة، السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته.. أوصيكم ونفسي الآثمة بتقوى الله تبارك وتعالى واليقين أنّ وراء ما نحن فيه موتٌ يُفرق به بين الخليل وخليله، وقد أوضح الحقَّ أميرُ البلاغة وسيّدُها إذ يقول -من جملة ما قال-: (وَاعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّكُمْ وَمَا أَنْتُمْ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا عَلَى سَبِيلِ مَنْ قَدْ مَضَى قَبْلَكُمْ مِمَّنْ كَانَ أَطْوَلَ مِنْكُمْ أَعْمَاراً وَأَعْمَرَ دِيَاراً وَأَبْعَدَ آثَاراً أَصْبَحَتْ أَصْوَاتُهُمْ هَامِدَةً وَرِيَاحُهُمْ رَاكِدَةً وَأَجْسَادُهُمْ بَالِيَةً وَدِيَارُهُمْ خَالِيَةً وَآثَارُهُمْ عَافِيَةً فَاسْتَبْدَلُوا بِالْقُصُورِ الْمَشَيَّدَةِ وَالنَّمَارِقِ الْمُمَهَّدَةِ الصُّخُورَ وَالْأَحْجَارَ الْمُسَنَّدَةَ وَالْقُبُورَ اللَّاطِئَةَ الْمُلْحَدَةَ الَّتِي قَدْ بُنِيَ عَلَى الْخَرَابِ فِنَاؤُهَا وَشُيِّدَ بِالتُّرَابِ بِنَاؤُهَا فَمَحَلُّهَا مُقْتَرِبٌ وَسَاكِنُهَا مُغْتَرِبٌ بَيْنَ أَهْلِ مَحَلَّةٍ مُوحِشِينَ وَأَهْلِ فَرَاغٍ مُتَشَاغِلِينَ لا يَسْتَأْنِسُونَ بِالْأَوْطَانِ وَلَا يَتَوَاصَلُونَ تَوَاصُلَ الْجِيرَانِ عَلَى مَا بَيْنَهُمْ مِنْ قُرْبِ الْجِوَارِ وَدُنُوِّ الدَّارِ وَكَيْفَ يَكُونُ بَيْنَهُمْ تَزَاوُرٌ وَقَدْ طَحَنَهُمْ بِكَلْكَلِهِ الْبِلَى وَأَكَلَتْهُمُ الْجَنَادِلُ وَالثَّرَى وَكَأَنْ قَدْ صِرْتُمْ إِلَى مَا صَارُوا إِلَيْهِ وَارْتَهَنَكُمْ ذَلِكَ الْمَضْجَعُ وَضَمَّكُمْ ذَلِكَ الْمُسْتَوْدَعُ فَكَيْفَ بِكُمْ لَوْ تَنَاهَتْ بِكُمُ الْأُمُورُ وَبُعْثِرَتِ الْقُبُورُ «هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إلى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ»).
بِدْءً إخواني أسعد الله أيّامكم بولادة الصدّيقة الطاهرة الراضية المرضيّة فاطمة الزهراء(سلام الله عليها) وهي بضعة المصطفى(صلّى الله عليه وآله) وأمّ الأئمّة، سائلين الله تبارك وتعالى أن نكون من زوّارها ومن شفعائها يوم نَفِدُ على الله تبارك وتعالى.
لا شكّ أنّ أمير المؤمنين(عليه السلام) هو سيّدُ البلاغة، وقد بيّن (صلوات الله وسلامه عليه) في مواطن كثيرة وظيفة الإنسان في الدنيا، وأيضاً حذّر من مغبّة أمورٍ لو الإنسان تراخى عنها فإنّه سيقع في شراكها، وأمير المؤمنين عندما ينظّر بين حالةٍ وأخرى يريد أن يبيّن أنّ المقادير تجري علينا جميعاً والإنسان العاقل هو الذي يعتبر بمن قبله، وهذه الكلمات منه (صلوات الله وسلامه عليه) تزيد الإنسان موعظةً أو تزيده عظةً، لأنّ هذا الكلام –واقعاً- يدخل الى شغاف القلب، وأميرُ المؤمنين يضع الأمور في نصابها دائماً، ولعلّ من جملة ما بيّن (سلام الله عليه) ما رواه الإمام أبو جعفر الباقر(عليه السلام)، وهذه الرواية التي أقرأها على مسامعكم الكريمة أيضاً تبيّن نحواً من الملازمات ما بين فعلٍ وآخر، وهذه الملازمات من الأمور التي لابُدّ منها، فنحن نعيش ونحن مكبّلون ومحدودون بحيث لا يُمكن أن نتخلّص من بعض الأمور التي نحن مقهورون عليها شئنا أم أبينا، الموت –مثلاً- من الحالات التي سنواجهها قطعاً ولا يُمكن أن ندفعه عن أنفسنا، بالنتيجة نحن لابُدّ أن ننتقل بعد طول مدّة أو قصرها، يتحدّث الإمام الباقر في هذا الحديث يقول: (قال أمير المؤمنين(عليه السلام): من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ)، هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها أمير المؤمنين(عليه السلام) على نحو أن يعلّمنا طريقة السلوك، فالإنسان في بعض الحالات يحبّ أن يعيش عيشةً جيّدة لكنّه لا يعرف، فتراه يدخل من هنا ويخرج من هناك ويتدخّل في هذا الأمر ويعطف عنانه على أمرٍ آخر، وإذا تجده كهذه الحشرة التي تلفّ نفسها بنفسها ثمّ بعد ذلك لا يستطيع أن يخرج من مشكلة هو من أوقع نفسه فيها، بعض القضايا قضايا سلوكيّة عامّة فقد ترى الإنسان يصلّي ويؤمن بالمعاد لكن طريقة تعاطيه لبعض الأمور قد يكون فيها نوع من التشويش، هناك حالة من التوازن وحالة من التعقّل، والمؤمن كلّما كان أكثر تعقّلاً أو أكثر عقلاً لا شكّ كان أكثر إيماناً، والتعقّل من الأمور الممدوحة، أنّ الإنسان يتعقّل ويستخدم عقله فهذه من الأمور الممدوحة التي ندب الشارع اليها، والتنافس هو تنافس العقلاء، والعقل هو الذي يأتي بالدين، فالإنسان إذا كان عاقلاً وهذه الجوهرة وهذه الموهبة والرحمة التي رحمنا الله تعالى بها -رحمة العقل- إذا كان الإنسان متعقّلاً واعياً ويستخدم عقله دائماً أي يجعل عقله أمامه ولا يجعله خلفه يصل الى مكامن الحقّ لا شكّ ولا ريب.
أمير المؤمنين في مقام أن ينظّم هذا الأمر، والعاقل هو الذي يؤمن أنّ هناك مسيرة لابُدّ أن تنتهي، وهناك جزاء لابُدّ أن نقف عنده في يومٍ ما، وهذه الملازمات يستثمرها الإنسان المؤمن لكن عليه أن يستخدم أيضاً هذا التعقّل، يقول(عليه السلام): (من أصلح ما بينه وبين الله...) لاحظوا عمليّة الإصلاح، الله تعالى يرانا دائماً ونحن مع الله علاقتنا ونسبتنا الى الله نسبة ربٍّ مع مربوب ونسبة عظيمٍ مع حقير ونسبة سيّدٍ مع عبد، علاقتنا مع الله تعالى نسبة محيي مع مميت ونسبة باقٍ مع فانٍ، الإمام(عليه السلام) يقول هناك علاقة لابُدّ أن تكون بمقتضى هذه الحقيقة، وهي أنّ الإنسان بينه وبين الله لابُدّ أن تكون حالته حالة صلاح، المكمن هو هنا.. عندنا جهةٌ لابُدّ أن تكون علاقتنا به أو بها علاقة صلاح، في مقابل علاقة الفساد أنّه الإنسان إذا أصلح ما بينه وبين الله، كيف يُصلح الإنسان ما بينه وبين الله تعالى؟! أوّلاً نحن نؤمن أنّ الله تعالى مطّلعٌ علينا والله تعالى ينفذ الى أعماقنا والله خلقنا وهو أقرب الينا (وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ)، الله تعالى أقرب الينا من أنفسنا، فإذن نحن دائماً في إحاطة الله تعالى في الرّضا وفي الغضب، في الفقر وفي الغنى، في الخلوات وفي الحضور، الله تبارك وتعالى لا تفرق عنده الحالة في النهار أو في الليل، أن أنطق بعبارة أو أضمر هذا المعنى، الله تعالى لا تفرق عنده هذه الأمور فكلّها شيء واحد بالنسبة اليه، الله تعالى مطّلع، إذا كان الأمر كذلك -وهو كذلك- فإذن لابُدّ أن نوقع أنفسنا تحت هذه العناية الإلهيّة، ولنوقع أنفسنا تحت هذه العناية الإلهيّة لابُدّ أن نكون دائماً في حالة تأهّب وترقّب وحالة من اليقظة، لأنّ الله تعالى لا ينام ولا يغفل ولا يسهو ولا يحجبه عنّا حاجب.
الإمام(عليه السلام) يقول: النقطة الأولى لبداية التوفيق تبدأ من إصلاح هذه العلاقة، أن الإنسان إذا أصلح ما بينه وبين الله، يعني هناك لله حقوق عليّ وهناك واجباتٌ منّي تجاه الله تعالى، فهذه الأمور لابُدّ أن أصلحها لابُدّ أن أكون أنا في موضع الرضا الى الله تعالى، وأمري وشؤوني شؤون صلاح، ولذلك عندما نريد أن نمدح إنساناً نقول هذا من أهل الصلاح، أنّ المظهر والكلام والسمت والمحضر الذي يحضره دائماً هو محضر صلاح ودائماً هو محضر خير، هذا المعنى مع الله تبارك وتعالى هو المطلوب في الدرجة الأولى، نقطة التوفيق أنّ الإنسان يُصلح حاله ما بينه وبين الله تعالى، لأنّ الله تعالى مطّلع والله تعالى -كما ذكرنا مراراً- لا يستعجل بعجلة العباد، حتى لو فرضنا أنّ الناس لا تُصلح أمرها مع الله فالله تعالى لا يستعجل وينتقم منها ابتداءً، شيءٌ آخر أنّ الفائدة المجنيّة هي فائدةٌ لنا، الإمام(عليه السلام) كأنّه يقول هذا الشقّ الأوّل أن الإنسان يُصلح أمره مع الله تعالى، ولا شكّ أنّي لا أستطيع أن أُصلح أمري مع الله إذا لم أعرف ماذا يريد الله تعالى منّي، أنا لا يمكن أن أُصلح نفسي مع الله إلّا أن أعلم ماذا يريد الله تعالى منّي فأنا قد أرتكب فعلاً وهذا الفعل لعلّه فيه سخط الله تعالى، فلابُدّ أن أعلم ماذا يريد الله منّي حتى أُصلح هذه الحالة، الله تعالى كما يريد منّي أن أُحسن الظنّ به ويريد من قلبي أن لا يكون فيه غلّ ولا يكون فيه سوء ظنّ بالآخرين فهو أيضاً يريد منّي أفعالاً خارجيّة، يريد منّي بعض الأعمال التي لابُدّ أن أعملها في الخارج، فهناك التزامات قلبيّة وهناك سلوكيّات خارجيّة، فإذا لم أعلم الأولى والثانية كيف أُصلح العلاقة بيني وبين الله تعالى؟!!
الإنسان الآن في حياتنا اليوميّة يقول إنّ علاقتي –مثلاً- مع أبي جيّدة، لماذا؟؟ لأنّه يسمع كلام الأب ويطيع الأب ويعرف ماذا يريد منه والده فينفّذ ما أراده الوالد منه، لتكون العلاقة طيّبة لابُدّ أن أعرف مشتهيات الوالد هذا يريده وهذا لا يريده، الإنسان مع الله تبارك وتعالى لابُدّ أن يعرف ماذا يريد منه ربّه وما لا يريده منه، ولذلك إخواني في بعض الحالات الإنسان يفعل فعلاً خلاف رغبته لكنّ الله يريده، فالله هو الذي يريد هذا الفعل، قد يكون الفعل خلاف رغبتك لكن تقدّم رضا الله على هذا الفعل، ولاحظوا الأنبياء والمصلحين والمعصومين كان همّهم الأوّل هو هذا، أن الإنسان مشتهياته الخاصّة قد يتركها لأنّه يريد أن يُصلح العلاقة بينه وبين الله تعالى، وهذه العلاقة مع الله تعالى لابُدّ أن تكون وفق ما يريد الله جلّ شأنه، وإلّا الإنسان سهلٌ على لسانه أن يقول علاقتي مع الله صحيحة لكن واقعاً عندما نتأمّل نرى أنّ هذه تحتاج الى دراية وتحتاج الى تفكّر وتحتاج الى علم، كيف تكون العلاقة بيني وبين الله تعالى صحيحة؟! لابُدّ أن أعرف ماذا يريد الله تعالى منّي، ولعلّنا ضربنا مثلاً سابقاً في قضيّةٍ وهي أنّه في بعض الحالات الجوّ العام الذي يعيشه الإنسان هو خطأ، هذا لا يكون له مبرّر أن هو يرتكب الخطأ أيضاً حتى وإن كان وحده، لو فرضنا الآن عندنا صفّ من الناس وفرضنا أنّ هؤلاء يقفون وقفةً غير مؤدّبة –مثلاً- لم يلبسوا تمام الملابس، أفرض عندنا الآن مائة صفّ من الرجال وكلّهم يلبسون هذه الملابس غير المحتشمة باستثناء شخصٍ واحد مميّز، لا شكّ ستقع العين على هذا المميّز لأنّ هذا هو الذي يجلب النظر، وعندما تسأل تقول هذا شذّ عنهم أو هذا اختلف عنهم، والواقع الخلل فيهم وليس فيه فالجوّ العام قد يُعطي انطباعاً فيه تشويش.
أمير المؤمنين(عليه السلام) يقول ليس هذا هو المقياس وإنّما المقياس الأوّل والملازمة الأولى ليست مع هؤلاء إنّما مع الله، لأنّ الله هو مسؤولي هو ربّي هو خالقي هو المفيض عليّ فلابُدّ أن أحسن العلاقة بيني وبينه ثمّ بعد ذلك الله يتكفّل، ما الذي يتكفّل به؟ قال: (أصلح الله ما بينه وبين الناس) يعني إذا الإنسان أصلح ما بينه وبين الله أصلح ما بينه وبين الناس، ولكي لا تختلط عندنا المفاهيم فعبارة: (أصلح ما بينه وبين الناس) لا يعني ذلك أنّ الناس لا تكذّبه وأنّ الناس لا تعاديه!! ليس المعنى هذا وإلّا لو كان كذلك يُفترض أنّ الأنبياء لم يُحارَبوا لم يُكذَّبوا، والأنبياء هم أفضل طبقةٍ أصلحت ما بينها وبين الله تعالى، التكذيب ينشأ من عدوٍّ لا يُريد الله تعالى، هذا خارج عن سياقنا وخارج عن مطلبنا، نعم.. الله تعالى يجعل محبّةً لهذا في قلوب المؤمنين، وفي بعض الروايات أنّ المؤمنين إذا أجمعوا أو اتّفقوا أو الأغلب على مدح شخص قد يدلّ هذا على أنّ علاقته مع الله جيّدة، إذا كانت العلاقة جيّدة مع الله أجرى ذكره على لسان المؤمنين أو على خيار خلقه، هؤلاء يثنون عليه لأنّ الله يريد لهذا العبد الذي علاقته مع الله جيّدة أن يكون مثالاً للآخرين، ولا شكّ نحن حريصون على أن تكون العلاقة الأمتن والأفضل هي العلاقة مع الله تبارك وتعالى، ماذا يريد الله تعالى منّي لابُدّ أن أعرف ثم أبدأ وأعمل حتّى أُصلح هذه العلاقة، والله تعالى لرحمته ورأفته بنا يقبل منّا القليل، يا من يقبل القليل أو يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير –كما ورد في الدعاء-، لكن الخطوة الأولى مهمّة إخواني أن الإنسان ينفض عن نفسه بعض القيود ويكسر بعض القيود وهذه النقطة هي المهمّة أن الإنسان يبدأ.
أمير المؤمنين(عليه السلام) يقول هذا هو المقياس أنّه لابُدّ أن تُصلح العلاقة مع الله وبقيّة العلاقات ليست مهمّة فهي علاقات عرضيّة علاقات غير مهمّة فالأولى هي هذه والأساس هو هذا، وطبعاً سيؤثّر هذا إيجاباً على السلوكيّات، فالإنسان إذا أصلح ما بينه وبين الله سيصلح حاله مع أبيه مع أمّه مع أولاده مع زميله مع ربّ العمل وسيكون مورد ثقة عند الناس، الله يأمره أن لا تخون، الله يأمره أن لا تسرق، الله يأمره أن لا تفحش في الكلام، هذه علاقة مع الله تعالى كلّما أراد أن يتقدّم خطوة تذكّر أنّ هذه ليس فيها رضا الله، هذه العلاقة ستفسد علاقته مع الله وهو حريص عليها فسيبتعد عن ذلك، ودون ذلك ما شئت من الأمثلة، هذه العلاقة هي التي تفتح كلّ العلاقات، إذا أصلحنا الأمر مع الله تعالى وكنّا لا نكذب ولا نسرق ولا نفحش في الكلام ولا نخون، الناس قطعاً ستحبّنا والناس تذكرنا بالخير والناس تتشوّق إلينا، فطرة الناس تريد الصادق غير الخائن البشوش الذي يتفقّد الناس ويتفقّد أحوال الناس، الناس تريد هكذا أحد وهذا ينشأ من العلاقة بينه وبين الله تبارك وتعالى، وهذه العلاقة إخواني لها مجالٌ واسع، فمن جملة الرّحمات الإلهيّة فينا أنّ الله في كلّ مكانٍ وزمان، لا يحويه زمان ومكان لكنّ الله حاضر في كلّ زمان ومكان، ففي أيّ وقتٍ وأيّ زمان وأيّ مكان نستطيع أن نناجيه ونستطيع أن نصلح الأحوال، ونستطيع أن نقف بين يديه في كلّ الأحوال وهذه من رحمة الله تعالى بنا، أنّنا لا نتجشّم عناءً أن نذهب الى مكانٍ خاصّ ففي كلّ وقتٍ الله معنا، نعم.. هناك بعض المواطن حثّنا الله تعالى عليها هذا شيءٌ آخر لزيادة الفائدة ولزيادة الكمال، وإلّا فالله تعالى في كلّ مكانٍ وزمانٍ وهو حاضرٌ معنا، فإذن لابُدّ أن نحسن هذه العلاقة مع الله تبارك وتعالى، ما هو الأثر المترتب على ذلك؟! هو أنّ الله تعالى يُحسن ما بينه وبين الناس، فيكون محضره جميلاً وسمته وسمعته وأخلاقه ممدوحة، لا يوجد أحد يحبّ أن تذمّه الناس إلّا الذي أسقط كرامة نفسه، ولا يوجد من يريد أن يستهزئ الناس به إلّا من أسقط كرامة نفسه، والذي له علاقة قويّة مع الله تعالى فهذه منتهى الكرامة مع الله تعالى وقطعاً أنّ الله سيُكرمه، وهذا هو الشقّ الأوّل من الحديث قال: (من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس)، لاحظوا القضيّة الأولى هي قضيّة عباديّة خاصّة بينك وبين الله تعالى والأثر الآخر الذي ترتّب عليها هو الأثر الاجتماعيّ، الإصلاح بينه وبين الناس مطلوب فالإنسان -كما يقول أهلُ الفلسفة والمنطق وعلم الاجتماع- مدنيٌّ بالطبع، الإنسان يحبّ أن يتعايش مع الآخرين والله تعالى جعل هذه شرطاً لإصلاح هذه، وهذا الجانب الذي نُريده ونعيشه بيننا يترتّب على الأوّل، وهذه نكتةٌ مهمّة اجتماعيّاً –إخواني- أنّ الإنسان تراه غير محبوب لأنّ عنده مشكلة مع الله تعالى، قل له: أصلح الحالة مع الله تعالى هو سيعرف كيف يُصلح الحال مع الله تعالى إصلاحاً حقيقيّاً، يعرف ماذا يريد الله تعالى منه، الإنسان الذي لسانه ذرب مع الآخرين لا يرضون به، علاقته مع الله غير جيّدة لأنّ الله لا يحبّ هذا الذي يستعمل لسانه في أذى الآخرين، أو هذا الذي يُحاول أن يهتك أعراض الناس الله لا يريد ذلك، ولذلك الإنسان إذا صرّح وقال: أنا أقبل أن تغتابني الناس –مثلاً- الشارع المقدّس لا يجوّز له ذلك، يقول: هذا الحقّ ليس حقّك فقط، الله لا يرضى أن نعيب الآخرين، لاحظوا المشكلة تكمن في العلاقة مع الله تعالى إذا كانت ضعيفة لابُدّ أن تستصلح.
(ومن أصلح أمرَ آخرته أصلح الله أمرَ دنياه) لاحظوا إخواني -عسى أن يسعفنا بعض الوقت- إصلاح أمر الآخرة ليس بالأمر المستحيل، لكن إصلاح أمر الآخرة يحتاج الى تأمّل، تُنقل روايةٌ -أعرضها بخدمتكم- عن النبيّ(صلّى الله عليه وآله) مع مجموعة من الأصحاب، أنّه كان يشوّقهم الى الجنّة، -التفتوا لهذا الأمر- قال رسول الله(صلّى الله عليه وآله): ((من قال: سبحان الله غرس الله له بها شجرة في الجنّة، ومن قال: الحمد لله غرس الله له بها شجرةً في الجنّة، ومن قال: لا إله إلّا الله غرس الله له بها شجرةً في الجنّة، ومن قال: الله أكبر غرس الله له بها شجرةً في الجنّة) فقال رجلٌ من قريش: يا رسول الله إنّ شجرنا في الجنّة لكثير! قال: (نعم.. ولكن إيّاكم أن تُرسلوا عليها نيراناً فتحرقوها، وذلك أنّ الله عزّ وجلّ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ)) استشهَدَ النبيّ بهذه الآية الشريفة، فإصلاح أمر الآخرة ليس أمراً مستحيلاً لكنّه يحتاج الى تأمّل ويحتاج الى تروٍّ، أنّ الآخرة ماذا تريد؟ أو بمعنى آخر الله تعالى ماذا يريد؟ عندما نقول: هذا من أهل الآخرة فماذا يعني أنّ هذا من أهل الآخرة؟؟ هذا يعني أنّ العمل الذي يعمله يريد به وجه الله تعالى، يُصلح داره الأخرى ويرتّب أثاثه من الآن، يأمل ويرجو من الله ما أَمَرَ الله تبارك وتعالى به، يُصلح ذلك الأمر فإذا حدث هذا يتكفّل الله تعالى بأمر الدنيا، لاحظوا الأولى شيءٌ عليّ والآخر على الله، في الأولى قال: (من أصلَحَ..) أنا الفاعل (مَنْ أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله...) ذهب الفعلُ الى الله، أي أنّ الله يتكفّل بالإصلاح، الثانية كذلك (من أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه) لاحظوا هناك فعلٌ منّا وهناك جزاءٌ من الله تبارك وتعالى، كأنّ الله يقول يا عبدي أنت تفعل هذا الفعل وأنا أُكمل، وعادةً الجزاء شرط، هنا تغيّر الفاعل تارةً تقول: إن نجح زيدٌ أُكرمْهُ، النجاح منه والجزاءُ منك، يعني هناك مؤونة عليك هو ينجح وأنت تكرم، الفاعل مختلف، هنا القضيّة أخرى أنت أصلحْ والباقي على الله تعالى، الذي يصلح أمر الآخرة الله تعالى يتكفّل بإصلاح أمر الدنيا، يُهيّئ له الله تعالى رزقاً من حيث لا يحتسب (وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا)، الإنسان إذا اتّقى الله فالله تعالى يرزقه من حيث لا يحتسب، ويخفّف عنه بعض البلايا ويرزقه القناعة، وكلّنا جرّبنا أنّ لذائذ الأطعمة والأشربة -مثلاً- نستطيع أن نُمسِك عنها لمدّة أربعة عشر ساعة، الإنسان يُعطى قناعةً على طول السنة أنّه أنا أتنافس على شيء أستطيع أن أعيش بلا أن يكون، بالإصلاح يُهيّئ الله تعالى لك نفسيّةً تقتنع، كنت تسعى وتسعى لأمر الدنيا والآن صرت تسعى وتسعى لأمر الآخرة، الله تعالى رزقك الكفاف ورزقك القناعة ورزقك ما لم يكن في حساباتك، رزقك إنساناً صديقاً يذكّرك بالله تعالى وهي أفضل نعمةٍ أن الإنسان يُرزق بمجموعةٍ من الناس معه يذكّرونه بالله تعالى، وهذا الصديق الذي يذكّرك بالله هو نعمة، إذا أراد الإنسان أن يُصلح أمر آخرته بعد أن كان في عبث، فبدأ بالتوبة ثمّ جاء الى الصلاة ليصلّي جلس بجانبه إنسانٌ ذو خبرة وشيبة فتعلّم منه الكثير، هذا هو الإصلاح الذي يتكفّل الله تبارك وتعالى به أمر الدنيا.
(ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ) الواعظ –إخواني- هو من يعظنا ومن ينبّهنا، ولعلّه (كفى بالشيب واعظاً) أنّ الإنسان إذا شاب وأصبحت لحيتُهُ أو كريمتُهُ بيضاء فكفى بهذا واعظاً، أنّه لابُدّ أن تبدأ بدايةً أخرى، (وكفى بالموت واعظاً) أيضاً إنسان إذا كان يتّعظ فالله تعالى يجعل له حافظاً يحفظه من بين يديه ومن خلفه، ما دام أنّه مع الله يكون الله معه وما دام أنّه لم ينسَ الله تعالى تداركه الله في وقت الحاجة، هذه المطالب إخواني قد لا تصبّ في القضيّة الفقهيّة الحرفيّة لكنّها تصبّ في السلوكيّات العامّة التي يدعو لها الفقه، وإلّا فالغنيمة كلّ الغنيمة هي ماذا؟؟! هي الآخرة. الإنسان مهما حصل في الدنيا تبقى الغنيمة الحقيقيّة هي الآخرة، فإذا لم يحصل على الآخرة تعساً لهذه اللذّات بأجمعها، لذلك ورد (وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ) أنّ الإنسان يفعل ما يفعل لكن تكون العاقبةُ للمتّقين، وهذه الأشياء كلّها تصبّ في خدمة الإنسان المؤمن، فيا أيّها الإنسان عليك أن تتّخذ التوازن -كما بيّنه أمير المؤمنين(عليه السلام)-.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يُصلح لنا آخرتنا وأن يجعلنا من الواعظين لأنفسنا قبل أن نعظ الآخرين، اللهمّ أصلح ما بيننا وبينك اللهمّ أصلح آخرتنا اللهمّ اجعل لنا واعظاً من أنفسنا وصلّ اللهمّ على محمد وآله... ونسأله تبارك وتعالى أن يعفو عنّا في زلل اللّسان والأقدام، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على محمد وآله الطيّبين الطاهرين.
لتشملنا العناية الإلهيّة يتحتم أن نكون دائماً في حالة تأهّب وترقّب وحالة من اليقظة
العلاقة مع الله تعالى لابُدّ أن تكون وفق ما يريد الله جلّ شأنه
النص الكامل للخطبة الاولى
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على محمد وعلى آله الطيّبين الطاهرين، الحمد لله المعروف من غير رؤية، الخالق من غير رويّة، الذي لم يزل قائماً دائماً إذ لا سماء ذات أبراج، ولا حجبٌ ذات أرتاج، ولا ليلٌ داجٍ، ولا بحرٌ ساج.. إخوتي أبنائي آبائي زادكم الله إيماناً وتقوى، أخواتي بناتي أمّهاتي ألبسكنّ الله تعالى لباس الحياء والعفّة، السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته.. أوصيكم ونفسي الآثمة بتقوى الله تبارك وتعالى واليقين أنّ وراء ما نحن فيه موتٌ يُفرق به بين الخليل وخليله، وقد أوضح الحقَّ أميرُ البلاغة وسيّدُها إذ يقول -من جملة ما قال-: (وَاعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّكُمْ وَمَا أَنْتُمْ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا عَلَى سَبِيلِ مَنْ قَدْ مَضَى قَبْلَكُمْ مِمَّنْ كَانَ أَطْوَلَ مِنْكُمْ أَعْمَاراً وَأَعْمَرَ دِيَاراً وَأَبْعَدَ آثَاراً أَصْبَحَتْ أَصْوَاتُهُمْ هَامِدَةً وَرِيَاحُهُمْ رَاكِدَةً وَأَجْسَادُهُمْ بَالِيَةً وَدِيَارُهُمْ خَالِيَةً وَآثَارُهُمْ عَافِيَةً فَاسْتَبْدَلُوا بِالْقُصُورِ الْمَشَيَّدَةِ وَالنَّمَارِقِ الْمُمَهَّدَةِ الصُّخُورَ وَالْأَحْجَارَ الْمُسَنَّدَةَ وَالْقُبُورَ اللَّاطِئَةَ الْمُلْحَدَةَ الَّتِي قَدْ بُنِيَ عَلَى الْخَرَابِ فِنَاؤُهَا وَشُيِّدَ بِالتُّرَابِ بِنَاؤُهَا فَمَحَلُّهَا مُقْتَرِبٌ وَسَاكِنُهَا مُغْتَرِبٌ بَيْنَ أَهْلِ مَحَلَّةٍ مُوحِشِينَ وَأَهْلِ فَرَاغٍ مُتَشَاغِلِينَ لا يَسْتَأْنِسُونَ بِالْأَوْطَانِ وَلَا يَتَوَاصَلُونَ تَوَاصُلَ الْجِيرَانِ عَلَى مَا بَيْنَهُمْ مِنْ قُرْبِ الْجِوَارِ وَدُنُوِّ الدَّارِ وَكَيْفَ يَكُونُ بَيْنَهُمْ تَزَاوُرٌ وَقَدْ طَحَنَهُمْ بِكَلْكَلِهِ الْبِلَى وَأَكَلَتْهُمُ الْجَنَادِلُ وَالثَّرَى وَكَأَنْ قَدْ صِرْتُمْ إِلَى مَا صَارُوا إِلَيْهِ وَارْتَهَنَكُمْ ذَلِكَ الْمَضْجَعُ وَضَمَّكُمْ ذَلِكَ الْمُسْتَوْدَعُ فَكَيْفَ بِكُمْ لَوْ تَنَاهَتْ بِكُمُ الْأُمُورُ وَبُعْثِرَتِ الْقُبُورُ «هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إلى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ»).
بِدْءً إخواني أسعد الله أيّامكم بولادة الصدّيقة الطاهرة الراضية المرضيّة فاطمة الزهراء(سلام الله عليها) وهي بضعة المصطفى(صلّى الله عليه وآله) وأمّ الأئمّة، سائلين الله تبارك وتعالى أن نكون من زوّارها ومن شفعائها يوم نَفِدُ على الله تبارك وتعالى.
لا شكّ أنّ أمير المؤمنين(عليه السلام) هو سيّدُ البلاغة، وقد بيّن (صلوات الله وسلامه عليه) في مواطن كثيرة وظيفة الإنسان في الدنيا، وأيضاً حذّر من مغبّة أمورٍ لو الإنسان تراخى عنها فإنّه سيقع في شراكها، وأمير المؤمنين عندما ينظّر بين حالةٍ وأخرى يريد أن يبيّن أنّ المقادير تجري علينا جميعاً والإنسان العاقل هو الذي يعتبر بمن قبله، وهذه الكلمات منه (صلوات الله وسلامه عليه) تزيد الإنسان موعظةً أو تزيده عظةً، لأنّ هذا الكلام –واقعاً- يدخل الى شغاف القلب، وأميرُ المؤمنين يضع الأمور في نصابها دائماً، ولعلّ من جملة ما بيّن (سلام الله عليه) ما رواه الإمام أبو جعفر الباقر(عليه السلام)، وهذه الرواية التي أقرأها على مسامعكم الكريمة أيضاً تبيّن نحواً من الملازمات ما بين فعلٍ وآخر، وهذه الملازمات من الأمور التي لابُدّ منها، فنحن نعيش ونحن مكبّلون ومحدودون بحيث لا يُمكن أن نتخلّص من بعض الأمور التي نحن مقهورون عليها شئنا أم أبينا، الموت –مثلاً- من الحالات التي سنواجهها قطعاً ولا يُمكن أن ندفعه عن أنفسنا، بالنتيجة نحن لابُدّ أن ننتقل بعد طول مدّة أو قصرها، يتحدّث الإمام الباقر في هذا الحديث يقول: (قال أمير المؤمنين(عليه السلام): من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ)، هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها أمير المؤمنين(عليه السلام) على نحو أن يعلّمنا طريقة السلوك، فالإنسان في بعض الحالات يحبّ أن يعيش عيشةً جيّدة لكنّه لا يعرف، فتراه يدخل من هنا ويخرج من هناك ويتدخّل في هذا الأمر ويعطف عنانه على أمرٍ آخر، وإذا تجده كهذه الحشرة التي تلفّ نفسها بنفسها ثمّ بعد ذلك لا يستطيع أن يخرج من مشكلة هو من أوقع نفسه فيها، بعض القضايا قضايا سلوكيّة عامّة فقد ترى الإنسان يصلّي ويؤمن بالمعاد لكن طريقة تعاطيه لبعض الأمور قد يكون فيها نوع من التشويش، هناك حالة من التوازن وحالة من التعقّل، والمؤمن كلّما كان أكثر تعقّلاً أو أكثر عقلاً لا شكّ كان أكثر إيماناً، والتعقّل من الأمور الممدوحة، أنّ الإنسان يتعقّل ويستخدم عقله فهذه من الأمور الممدوحة التي ندب الشارع اليها، والتنافس هو تنافس العقلاء، والعقل هو الذي يأتي بالدين، فالإنسان إذا كان عاقلاً وهذه الجوهرة وهذه الموهبة والرحمة التي رحمنا الله تعالى بها -رحمة العقل- إذا كان الإنسان متعقّلاً واعياً ويستخدم عقله دائماً أي يجعل عقله أمامه ولا يجعله خلفه يصل الى مكامن الحقّ لا شكّ ولا ريب.
أمير المؤمنين في مقام أن ينظّم هذا الأمر، والعاقل هو الذي يؤمن أنّ هناك مسيرة لابُدّ أن تنتهي، وهناك جزاء لابُدّ أن نقف عنده في يومٍ ما، وهذه الملازمات يستثمرها الإنسان المؤمن لكن عليه أن يستخدم أيضاً هذا التعقّل، يقول(عليه السلام): (من أصلح ما بينه وبين الله...) لاحظوا عمليّة الإصلاح، الله تعالى يرانا دائماً ونحن مع الله علاقتنا ونسبتنا الى الله نسبة ربٍّ مع مربوب ونسبة عظيمٍ مع حقير ونسبة سيّدٍ مع عبد، علاقتنا مع الله تعالى نسبة محيي مع مميت ونسبة باقٍ مع فانٍ، الإمام(عليه السلام) يقول هناك علاقة لابُدّ أن تكون بمقتضى هذه الحقيقة، وهي أنّ الإنسان بينه وبين الله لابُدّ أن تكون حالته حالة صلاح، المكمن هو هنا.. عندنا جهةٌ لابُدّ أن تكون علاقتنا به أو بها علاقة صلاح، في مقابل علاقة الفساد أنّه الإنسان إذا أصلح ما بينه وبين الله، كيف يُصلح الإنسان ما بينه وبين الله تعالى؟! أوّلاً نحن نؤمن أنّ الله تعالى مطّلعٌ علينا والله تعالى ينفذ الى أعماقنا والله خلقنا وهو أقرب الينا (وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ)، الله تعالى أقرب الينا من أنفسنا، فإذن نحن دائماً في إحاطة الله تعالى في الرّضا وفي الغضب، في الفقر وفي الغنى، في الخلوات وفي الحضور، الله تبارك وتعالى لا تفرق عنده الحالة في النهار أو في الليل، أن أنطق بعبارة أو أضمر هذا المعنى، الله تعالى لا تفرق عنده هذه الأمور فكلّها شيء واحد بالنسبة اليه، الله تعالى مطّلع، إذا كان الأمر كذلك -وهو كذلك- فإذن لابُدّ أن نوقع أنفسنا تحت هذه العناية الإلهيّة، ولنوقع أنفسنا تحت هذه العناية الإلهيّة لابُدّ أن نكون دائماً في حالة تأهّب وترقّب وحالة من اليقظة، لأنّ الله تعالى لا ينام ولا يغفل ولا يسهو ولا يحجبه عنّا حاجب.
الإمام(عليه السلام) يقول: النقطة الأولى لبداية التوفيق تبدأ من إصلاح هذه العلاقة، أن الإنسان إذا أصلح ما بينه وبين الله، يعني هناك لله حقوق عليّ وهناك واجباتٌ منّي تجاه الله تعالى، فهذه الأمور لابُدّ أن أصلحها لابُدّ أن أكون أنا في موضع الرضا الى الله تعالى، وأمري وشؤوني شؤون صلاح، ولذلك عندما نريد أن نمدح إنساناً نقول هذا من أهل الصلاح، أنّ المظهر والكلام والسمت والمحضر الذي يحضره دائماً هو محضر صلاح ودائماً هو محضر خير، هذا المعنى مع الله تبارك وتعالى هو المطلوب في الدرجة الأولى، نقطة التوفيق أنّ الإنسان يُصلح حاله ما بينه وبين الله تعالى، لأنّ الله تعالى مطّلع والله تعالى -كما ذكرنا مراراً- لا يستعجل بعجلة العباد، حتى لو فرضنا أنّ الناس لا تُصلح أمرها مع الله فالله تعالى لا يستعجل وينتقم منها ابتداءً، شيءٌ آخر أنّ الفائدة المجنيّة هي فائدةٌ لنا، الإمام(عليه السلام) كأنّه يقول هذا الشقّ الأوّل أن الإنسان يُصلح أمره مع الله تعالى، ولا شكّ أنّي لا أستطيع أن أُصلح أمري مع الله إذا لم أعرف ماذا يريد الله تعالى منّي، أنا لا يمكن أن أُصلح نفسي مع الله إلّا أن أعلم ماذا يريد الله تعالى منّي فأنا قد أرتكب فعلاً وهذا الفعل لعلّه فيه سخط الله تعالى، فلابُدّ أن أعلم ماذا يريد الله منّي حتى أُصلح هذه الحالة، الله تعالى كما يريد منّي أن أُحسن الظنّ به ويريد من قلبي أن لا يكون فيه غلّ ولا يكون فيه سوء ظنّ بالآخرين فهو أيضاً يريد منّي أفعالاً خارجيّة، يريد منّي بعض الأعمال التي لابُدّ أن أعملها في الخارج، فهناك التزامات قلبيّة وهناك سلوكيّات خارجيّة، فإذا لم أعلم الأولى والثانية كيف أُصلح العلاقة بيني وبين الله تعالى؟!!
الإنسان الآن في حياتنا اليوميّة يقول إنّ علاقتي –مثلاً- مع أبي جيّدة، لماذا؟؟ لأنّه يسمع كلام الأب ويطيع الأب ويعرف ماذا يريد منه والده فينفّذ ما أراده الوالد منه، لتكون العلاقة طيّبة لابُدّ أن أعرف مشتهيات الوالد هذا يريده وهذا لا يريده، الإنسان مع الله تبارك وتعالى لابُدّ أن يعرف ماذا يريد منه ربّه وما لا يريده منه، ولذلك إخواني في بعض الحالات الإنسان يفعل فعلاً خلاف رغبته لكنّ الله يريده، فالله هو الذي يريد هذا الفعل، قد يكون الفعل خلاف رغبتك لكن تقدّم رضا الله على هذا الفعل، ولاحظوا الأنبياء والمصلحين والمعصومين كان همّهم الأوّل هو هذا، أن الإنسان مشتهياته الخاصّة قد يتركها لأنّه يريد أن يُصلح العلاقة بينه وبين الله تعالى، وهذه العلاقة مع الله تعالى لابُدّ أن تكون وفق ما يريد الله جلّ شأنه، وإلّا الإنسان سهلٌ على لسانه أن يقول علاقتي مع الله صحيحة لكن واقعاً عندما نتأمّل نرى أنّ هذه تحتاج الى دراية وتحتاج الى تفكّر وتحتاج الى علم، كيف تكون العلاقة بيني وبين الله تعالى صحيحة؟! لابُدّ أن أعرف ماذا يريد الله تعالى منّي، ولعلّنا ضربنا مثلاً سابقاً في قضيّةٍ وهي أنّه في بعض الحالات الجوّ العام الذي يعيشه الإنسان هو خطأ، هذا لا يكون له مبرّر أن هو يرتكب الخطأ أيضاً حتى وإن كان وحده، لو فرضنا الآن عندنا صفّ من الناس وفرضنا أنّ هؤلاء يقفون وقفةً غير مؤدّبة –مثلاً- لم يلبسوا تمام الملابس، أفرض عندنا الآن مائة صفّ من الرجال وكلّهم يلبسون هذه الملابس غير المحتشمة باستثناء شخصٍ واحد مميّز، لا شكّ ستقع العين على هذا المميّز لأنّ هذا هو الذي يجلب النظر، وعندما تسأل تقول هذا شذّ عنهم أو هذا اختلف عنهم، والواقع الخلل فيهم وليس فيه فالجوّ العام قد يُعطي انطباعاً فيه تشويش.
أمير المؤمنين(عليه السلام) يقول ليس هذا هو المقياس وإنّما المقياس الأوّل والملازمة الأولى ليست مع هؤلاء إنّما مع الله، لأنّ الله هو مسؤولي هو ربّي هو خالقي هو المفيض عليّ فلابُدّ أن أحسن العلاقة بيني وبينه ثمّ بعد ذلك الله يتكفّل، ما الذي يتكفّل به؟ قال: (أصلح الله ما بينه وبين الناس) يعني إذا الإنسان أصلح ما بينه وبين الله أصلح ما بينه وبين الناس، ولكي لا تختلط عندنا المفاهيم فعبارة: (أصلح ما بينه وبين الناس) لا يعني ذلك أنّ الناس لا تكذّبه وأنّ الناس لا تعاديه!! ليس المعنى هذا وإلّا لو كان كذلك يُفترض أنّ الأنبياء لم يُحارَبوا لم يُكذَّبوا، والأنبياء هم أفضل طبقةٍ أصلحت ما بينها وبين الله تعالى، التكذيب ينشأ من عدوٍّ لا يُريد الله تعالى، هذا خارج عن سياقنا وخارج عن مطلبنا، نعم.. الله تعالى يجعل محبّةً لهذا في قلوب المؤمنين، وفي بعض الروايات أنّ المؤمنين إذا أجمعوا أو اتّفقوا أو الأغلب على مدح شخص قد يدلّ هذا على أنّ علاقته مع الله جيّدة، إذا كانت العلاقة جيّدة مع الله أجرى ذكره على لسان المؤمنين أو على خيار خلقه، هؤلاء يثنون عليه لأنّ الله يريد لهذا العبد الذي علاقته مع الله جيّدة أن يكون مثالاً للآخرين، ولا شكّ نحن حريصون على أن تكون العلاقة الأمتن والأفضل هي العلاقة مع الله تبارك وتعالى، ماذا يريد الله تعالى منّي لابُدّ أن أعرف ثم أبدأ وأعمل حتّى أُصلح هذه العلاقة، والله تعالى لرحمته ورأفته بنا يقبل منّا القليل، يا من يقبل القليل أو يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير –كما ورد في الدعاء-، لكن الخطوة الأولى مهمّة إخواني أن الإنسان ينفض عن نفسه بعض القيود ويكسر بعض القيود وهذه النقطة هي المهمّة أن الإنسان يبدأ.
أمير المؤمنين(عليه السلام) يقول هذا هو المقياس أنّه لابُدّ أن تُصلح العلاقة مع الله وبقيّة العلاقات ليست مهمّة فهي علاقات عرضيّة علاقات غير مهمّة فالأولى هي هذه والأساس هو هذا، وطبعاً سيؤثّر هذا إيجاباً على السلوكيّات، فالإنسان إذا أصلح ما بينه وبين الله سيصلح حاله مع أبيه مع أمّه مع أولاده مع زميله مع ربّ العمل وسيكون مورد ثقة عند الناس، الله يأمره أن لا تخون، الله يأمره أن لا تسرق، الله يأمره أن لا تفحش في الكلام، هذه علاقة مع الله تعالى كلّما أراد أن يتقدّم خطوة تذكّر أنّ هذه ليس فيها رضا الله، هذه العلاقة ستفسد علاقته مع الله وهو حريص عليها فسيبتعد عن ذلك، ودون ذلك ما شئت من الأمثلة، هذه العلاقة هي التي تفتح كلّ العلاقات، إذا أصلحنا الأمر مع الله تعالى وكنّا لا نكذب ولا نسرق ولا نفحش في الكلام ولا نخون، الناس قطعاً ستحبّنا والناس تذكرنا بالخير والناس تتشوّق إلينا، فطرة الناس تريد الصادق غير الخائن البشوش الذي يتفقّد الناس ويتفقّد أحوال الناس، الناس تريد هكذا أحد وهذا ينشأ من العلاقة بينه وبين الله تبارك وتعالى، وهذه العلاقة إخواني لها مجالٌ واسع، فمن جملة الرّحمات الإلهيّة فينا أنّ الله في كلّ مكانٍ وزمان، لا يحويه زمان ومكان لكنّ الله حاضر في كلّ زمان ومكان، ففي أيّ وقتٍ وأيّ زمان وأيّ مكان نستطيع أن نناجيه ونستطيع أن نصلح الأحوال، ونستطيع أن نقف بين يديه في كلّ الأحوال وهذه من رحمة الله تعالى بنا، أنّنا لا نتجشّم عناءً أن نذهب الى مكانٍ خاصّ ففي كلّ وقتٍ الله معنا، نعم.. هناك بعض المواطن حثّنا الله تعالى عليها هذا شيءٌ آخر لزيادة الفائدة ولزيادة الكمال، وإلّا فالله تعالى في كلّ مكانٍ وزمانٍ وهو حاضرٌ معنا، فإذن لابُدّ أن نحسن هذه العلاقة مع الله تبارك وتعالى، ما هو الأثر المترتب على ذلك؟! هو أنّ الله تعالى يُحسن ما بينه وبين الناس، فيكون محضره جميلاً وسمته وسمعته وأخلاقه ممدوحة، لا يوجد أحد يحبّ أن تذمّه الناس إلّا الذي أسقط كرامة نفسه، ولا يوجد من يريد أن يستهزئ الناس به إلّا من أسقط كرامة نفسه، والذي له علاقة قويّة مع الله تعالى فهذه منتهى الكرامة مع الله تعالى وقطعاً أنّ الله سيُكرمه، وهذا هو الشقّ الأوّل من الحديث قال: (من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس)، لاحظوا القضيّة الأولى هي قضيّة عباديّة خاصّة بينك وبين الله تعالى والأثر الآخر الذي ترتّب عليها هو الأثر الاجتماعيّ، الإصلاح بينه وبين الناس مطلوب فالإنسان -كما يقول أهلُ الفلسفة والمنطق وعلم الاجتماع- مدنيٌّ بالطبع، الإنسان يحبّ أن يتعايش مع الآخرين والله تعالى جعل هذه شرطاً لإصلاح هذه، وهذا الجانب الذي نُريده ونعيشه بيننا يترتّب على الأوّل، وهذه نكتةٌ مهمّة اجتماعيّاً –إخواني- أنّ الإنسان تراه غير محبوب لأنّ عنده مشكلة مع الله تعالى، قل له: أصلح الحالة مع الله تعالى هو سيعرف كيف يُصلح الحال مع الله تعالى إصلاحاً حقيقيّاً، يعرف ماذا يريد الله تعالى منه، الإنسان الذي لسانه ذرب مع الآخرين لا يرضون به، علاقته مع الله غير جيّدة لأنّ الله لا يحبّ هذا الذي يستعمل لسانه في أذى الآخرين، أو هذا الذي يُحاول أن يهتك أعراض الناس الله لا يريد ذلك، ولذلك الإنسان إذا صرّح وقال: أنا أقبل أن تغتابني الناس –مثلاً- الشارع المقدّس لا يجوّز له ذلك، يقول: هذا الحقّ ليس حقّك فقط، الله لا يرضى أن نعيب الآخرين، لاحظوا المشكلة تكمن في العلاقة مع الله تعالى إذا كانت ضعيفة لابُدّ أن تستصلح.
(ومن أصلح أمرَ آخرته أصلح الله أمرَ دنياه) لاحظوا إخواني -عسى أن يسعفنا بعض الوقت- إصلاح أمر الآخرة ليس بالأمر المستحيل، لكن إصلاح أمر الآخرة يحتاج الى تأمّل، تُنقل روايةٌ -أعرضها بخدمتكم- عن النبيّ(صلّى الله عليه وآله) مع مجموعة من الأصحاب، أنّه كان يشوّقهم الى الجنّة، -التفتوا لهذا الأمر- قال رسول الله(صلّى الله عليه وآله): ((من قال: سبحان الله غرس الله له بها شجرة في الجنّة، ومن قال: الحمد لله غرس الله له بها شجرةً في الجنّة، ومن قال: لا إله إلّا الله غرس الله له بها شجرةً في الجنّة، ومن قال: الله أكبر غرس الله له بها شجرةً في الجنّة) فقال رجلٌ من قريش: يا رسول الله إنّ شجرنا في الجنّة لكثير! قال: (نعم.. ولكن إيّاكم أن تُرسلوا عليها نيراناً فتحرقوها، وذلك أنّ الله عزّ وجلّ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ)) استشهَدَ النبيّ بهذه الآية الشريفة، فإصلاح أمر الآخرة ليس أمراً مستحيلاً لكنّه يحتاج الى تأمّل ويحتاج الى تروٍّ، أنّ الآخرة ماذا تريد؟ أو بمعنى آخر الله تعالى ماذا يريد؟ عندما نقول: هذا من أهل الآخرة فماذا يعني أنّ هذا من أهل الآخرة؟؟ هذا يعني أنّ العمل الذي يعمله يريد به وجه الله تعالى، يُصلح داره الأخرى ويرتّب أثاثه من الآن، يأمل ويرجو من الله ما أَمَرَ الله تبارك وتعالى به، يُصلح ذلك الأمر فإذا حدث هذا يتكفّل الله تعالى بأمر الدنيا، لاحظوا الأولى شيءٌ عليّ والآخر على الله، في الأولى قال: (من أصلَحَ..) أنا الفاعل (مَنْ أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله...) ذهب الفعلُ الى الله، أي أنّ الله يتكفّل بالإصلاح، الثانية كذلك (من أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه) لاحظوا هناك فعلٌ منّا وهناك جزاءٌ من الله تبارك وتعالى، كأنّ الله يقول يا عبدي أنت تفعل هذا الفعل وأنا أُكمل، وعادةً الجزاء شرط، هنا تغيّر الفاعل تارةً تقول: إن نجح زيدٌ أُكرمْهُ، النجاح منه والجزاءُ منك، يعني هناك مؤونة عليك هو ينجح وأنت تكرم، الفاعل مختلف، هنا القضيّة أخرى أنت أصلحْ والباقي على الله تعالى، الذي يصلح أمر الآخرة الله تعالى يتكفّل بإصلاح أمر الدنيا، يُهيّئ له الله تعالى رزقاً من حيث لا يحتسب (وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا)، الإنسان إذا اتّقى الله فالله تعالى يرزقه من حيث لا يحتسب، ويخفّف عنه بعض البلايا ويرزقه القناعة، وكلّنا جرّبنا أنّ لذائذ الأطعمة والأشربة -مثلاً- نستطيع أن نُمسِك عنها لمدّة أربعة عشر ساعة، الإنسان يُعطى قناعةً على طول السنة أنّه أنا أتنافس على شيء أستطيع أن أعيش بلا أن يكون، بالإصلاح يُهيّئ الله تعالى لك نفسيّةً تقتنع، كنت تسعى وتسعى لأمر الدنيا والآن صرت تسعى وتسعى لأمر الآخرة، الله تعالى رزقك الكفاف ورزقك القناعة ورزقك ما لم يكن في حساباتك، رزقك إنساناً صديقاً يذكّرك بالله تعالى وهي أفضل نعمةٍ أن الإنسان يُرزق بمجموعةٍ من الناس معه يذكّرونه بالله تعالى، وهذا الصديق الذي يذكّرك بالله هو نعمة، إذا أراد الإنسان أن يُصلح أمر آخرته بعد أن كان في عبث، فبدأ بالتوبة ثمّ جاء الى الصلاة ليصلّي جلس بجانبه إنسانٌ ذو خبرة وشيبة فتعلّم منه الكثير، هذا هو الإصلاح الذي يتكفّل الله تبارك وتعالى به أمر الدنيا.
(ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ) الواعظ –إخواني- هو من يعظنا ومن ينبّهنا، ولعلّه (كفى بالشيب واعظاً) أنّ الإنسان إذا شاب وأصبحت لحيتُهُ أو كريمتُهُ بيضاء فكفى بهذا واعظاً، أنّه لابُدّ أن تبدأ بدايةً أخرى، (وكفى بالموت واعظاً) أيضاً إنسان إذا كان يتّعظ فالله تعالى يجعل له حافظاً يحفظه من بين يديه ومن خلفه، ما دام أنّه مع الله يكون الله معه وما دام أنّه لم ينسَ الله تعالى تداركه الله في وقت الحاجة، هذه المطالب إخواني قد لا تصبّ في القضيّة الفقهيّة الحرفيّة لكنّها تصبّ في السلوكيّات العامّة التي يدعو لها الفقه، وإلّا فالغنيمة كلّ الغنيمة هي ماذا؟؟! هي الآخرة. الإنسان مهما حصل في الدنيا تبقى الغنيمة الحقيقيّة هي الآخرة، فإذا لم يحصل على الآخرة تعساً لهذه اللذّات بأجمعها، لذلك ورد (وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ) أنّ الإنسان يفعل ما يفعل لكن تكون العاقبةُ للمتّقين، وهذه الأشياء كلّها تصبّ في خدمة الإنسان المؤمن، فيا أيّها الإنسان عليك أن تتّخذ التوازن -كما بيّنه أمير المؤمنين(عليه السلام)-.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يُصلح لنا آخرتنا وأن يجعلنا من الواعظين لأنفسنا قبل أن نعظ الآخرين، اللهمّ أصلح ما بيننا وبينك اللهمّ أصلح آخرتنا اللهمّ اجعل لنا واعظاً من أنفسنا وصلّ اللهمّ على محمد وآله... ونسأله تبارك وتعالى أن يعفو عنّا في زلل اللّسان والأقدام، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على محمد وآله الطيّبين الطاهرين.



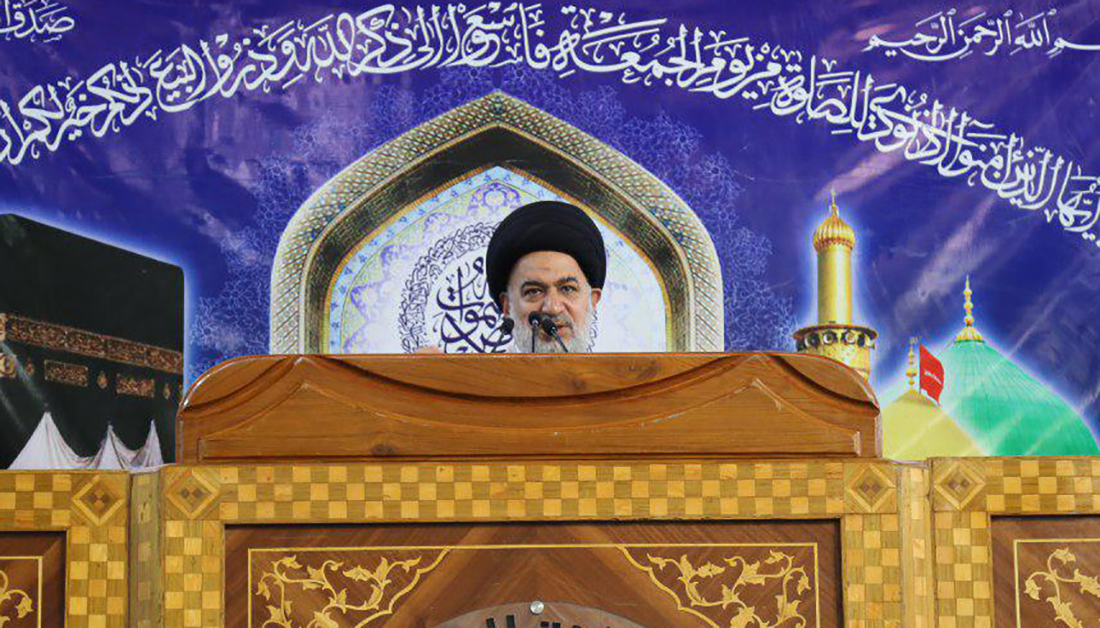













اترك تعليق