لا يخفى أن التاريخ هو عبارة عن الاحداث التي جرت في الزمن الماضي، والزمن الماضي يتحقق وإن كان مضيه بلحاظ جزء الثانية من الناحية العلمية، وهو القاعدة الأساسية المؤثرة في بناء الحال والاستقبال، لذا فهو يحتل مكانة غاية الاهمية في حياة الإنسان.
والتاريخ لا يشهد الوجود بذاته، بل لابد له من صانع، والذي يصنع هذا التاريخ أو ذاك هو الإنسان نفسه، لأن حركته حركة مبنية على الإرادة المتولدة عن التفكر والإدراكات العقلانية، فيقوى ويتأكد ويضعف بناء على موع الإدراك وصحته، وقوة الإرادة وضعفها، ولا يوجد في هذا الكون مخلوق يملك هذه القدرة وبهذه الصفة غير الإنسان.
وبناء على ذلك: نستنتج أن أحداث التاريخ تصنعها سلوكيات الإنسان نفسه(فعله وردود أفعاله)، فتنشئ الأحداث إنشاءً تقليدياً أو ابداعياً فتوجدها، وهذا في أصل إنشائه وتكوينه، أما في استمراره فهو يجرى وفق التأسيس الأول مع بعض التعديلات في التفاصيل والشكل الخارجي له.
وعلى ضوء هذه الحقيقة يقسم صنّاع التاريخ إلى نوعين، والمقسم في هذا التقسيم يكون باعتبار تقسيم جنس الصانع نفسه وهو الإنسان، وهو:
1- الإنسان غير المعصوم، والذي تؤسس أحداثه على ضوء ما يهمه في هذه الحياة الدنيا بالدرجة الأولى، أي المصلحة الشخصية والنوعية المنحصرة في المصلحة الشخصية، كتدبير شؤونه الخاصة وتدبير شؤون عائلته وما يتعلق به.
2- الإنسان المعصوم، والذي يؤسس الأحداث على ضوء ما يهمه، وما يهمه فقط هو المصلحة العامة لا الخاصة، وذلك بسبب علة وجوده ووظيفته، فالإنسان عنده عيال الله تعالى، وهو يهتم بهم على هذا الأساس، إذ يقول الإمام أبو جعفر الباقر(عليه السلام): ((الخلق عيال الله فأحبهم اليه أحسنهم صنيعا إلى عياله))[1].
ولا يخفى أن ما يهم الإنسان عموماً في هذه الدنيا سواء كان معصوماً أو غير معصوم، أمور رئيسية، هي:
1- تحقيق الاستقرار والاطمئنان النفسي بحفظ مكانته وشخصيته الحقيقية والاعتبارية في مكانتها الصحيحة سواء كان في الجانب المعنوي منها أو المادية.
2- تحقيق الإدارة الصحيحة والمتينة للحياة الدنياً علمياً وفكرياً وسلوكياً.
3- تحقق الجانب الاقتصادي للحياة وحركته المستمرة، لأن به قوام الحياة واستمرارها.
والذي يغلب في هذه الأمور عند المقارنة والتفاضل بينها، هو: الجانب الأول، وهو الجانب الذي تحققه العلاقة مع الله(جلّ وعلا)، والتي هي محور الحياة الدنيا، المبنية على العلم الصحيح والسلوك القويم، فمن خلالها تتحقق مرادات الإنسان الجزئية التي تحقق له الاطمئنان والاستقرار سواء كان مادياً أو معنوياً، وهو مطلب له قاعدة حياتية أساسية أشير إليها في قوله تعالى: {قُلْنَا اهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ}[2]، وهو الامتثال المطلق للقرآن الكريم وأوامره.
لذا نجد أن الله تعالى يدل على هذا الأمر بصراحة في كتابه الكريم، ونعني به: (أن من يلتزم بالقرآن وتعاليمه المباركة في سير مجريات هذه الحياة، يمنع وينجو من الخوف الناشئ عن عدم اطمئنان النفس والحزن الناشئ عن عدم تحقق النتائج المطلوبة وهو عدم الاستقرار)، وقد جمع الله تعالى هذه الأمور صرح الله تبارك وتعالى بها في قوله تعالى: {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى ءَامَنُواْ وَاتَّقَوْاْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ والْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ}[3]، باعتبار أن هذه البركات تسبب له القلق وعدم الاستقرار في حال فقدانها، وهي مرتبطة بالإيمان بالله(جل جلاه)، وتحقق الاطمئنان والاستقرار الدنيوي والأخروي.
وعلى ضوء هذه الحقيقة ولأهميتها نرى الله تبارك وتعالى يعاقب البشر في حال سوء العلاقة بينه(جل وعلا) وبينهم بحبس الغيث عنهم، لأنه أساس الزراعة التي من خلالها يطمئن الإنسان على حياته وتدور عجلته الاقتصادية، فيعرقلها ويدخل الإنسان في خطر شديد يشعر به بالشعور بعدم تحقق النتائج ولو على نحو الاحتمال، فيقول سبحانه: {وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ}[4]، هذا المنطوق والمفهوم خلاف ذلك فلا غيث ولا رحمة.
وتوضيح ذلك:
أن الغيث هو: (المطر الغزير الذي يأتي بالخير)، والذي قاعدته أنه ينزل في حال حسن العلاقة مع الله تبارك وتعالى ويزداد ويستمر في حال تحسنها، فيقول الله سبحانه وتعالى: { لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ * فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ * ذَلك جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ}[5].
وقد وردت عن الأئمة الطاهرين(عليه السلام) في غير موضع روايات تصرح بهذه الحقيقة، وهي: (أن منع القطر من أشد المصائب التي تواجه الإنسان، لأنها تقضي على حركته الاقتصادية والتي تعني الاطمئنان على حياته في الدنيا، مما يهدد استمرارها واستقرارها)، ومثاله الرواية التالية، والتي تبين أسباب منع الغيث بسبب المعاصي، أي سوء العلاقة مع الله(جل وعلا).
فقد جاء بسنده عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا خَالِدٍ الْكَابُلِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ زَيْنَ الْعَابِدِينَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(عليه السلام) يَقُولُ: ((الذُّنُوبُ الَّتِي تَحْبِسُ غَيْثَ السَّمَاءِ: جَوْرُ الْحُكَّامِ فِي الْقَضَاءِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ، وَكِتْمَانُ الشَّهَادَةِ، وَمَنْعُ الزَّكَاةِ وَ الْقَرْضِ وَ الْمَاعُونِ، وَقَسَاوَةُ الْقُلُوبِ عَلَى أَهْلِ الْفَقْرِ وَ الْفَاقَةِ، وَظُلْمُ الْيَتِيمِ وَالْأَرْمَلَةِ، وَانْتِهَارُ السَّائِلِ وَرَدُّهُ بِاللَّيْلِ))[6].
ولو لم يكن هذا الأمر مفصليا وجوهريا وذو أهمية حياتية كبيرة تدخل الإنسان في دوامة الخوف والحزن وعدم الاستقرار، لما دعا به الإمام الحسين(عليه السلام) على القوم باستحقاقهم العقوبة في يوم عاشوراء، إذ كانت الدعوة بحق الذين عصوا الله(جل وعلا) بقتله وانتهاك حرمته(عليه السلام) وهي من الكبائر التي لا يختلف عليها اثنان، فقال(عليه السلام): ((اللهم أمسك عنهم قطر السماء وامنعهم بركات الأرض، اللهم فان متعتهم إلى حين ففرقهم فرقا، واجعلهم طرائق قددا، ولا ترض عنهم الولاة أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا فعدوا علينا فقتلونا))[7]، فقطر السماء مفصلي وجوهري في الحياة الاقتصادية للإنسان.
وبناء على ما تقدم أصبح من الواضح بعد التفكر والتمحيص أن الركن الأساس في هذه الأمور هو جانب العقيدة، إذ أن بالعقيدة يكون الاستقرار والاطمئنان، وعلى ضوئها تكون حركة الاقتصاد سليمة مؤدية إلى الاطمئنان في الدنيا والآخرة، لأن الحركة الاقتصادية مرتبطة بالإيمان بالله تعالى ارتباطا جوهريا، فال الله تعالى: {وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ القِيَمَةِ أَعْمَى}[8].
لذا فإن رسالتنا في هذه المقالة والتي نخاطب بها الناس، أن الإنسان إذا أراد الاطمئنان والاستقرار الدائم في الحياة الدنيا المؤثر في الآخرة حري به أن يلتفت إلى هذه الحقيقة، وأن يعلم أن سبب هناء حياته وتعاستها هي سلوكياته خصوصاً المتعلقة بإيمانه بالله تعالى، وأن تعديل حياته واستمرارها مرهون بتعديل السلوكيات السابقة والحالية المؤثرة في بناء أسس حياته الحالية، فاختيار الإنسان هو مفتاح التغيير والحل لكل المشكلات، وهو مفتاح هناء الحياة واستقامتها، ولكننا يجب أن ننتبه إلى أن التغيير يلزم أن يكون مفضي للحياة الهنيئة لا مجرد التغيير، ولا يكون كذلك إلا إذا جرى وفق قانون العلية، أي السبب والمسَبب، والنتيجة تتبع أسوء المقدمات كما يقولون.
الهوامش:--------------------------------------------------
[1] جامع أحاديث الشيعة، السيد البروجردي، ج ١٦، ص: ١٧٧، ح8.
[2] سورة البقرة: 38.
[3] سورة الأعراف: 96.
[4] سورة الشورى: 28.
[5] سورة سبأ: 15-17.
[6] معاني الأخبار، الشيخ الصدوق، ص:271.
[7] مقتل الحسين(عليه السلام)، أبو مخنف الأزدي، ص: 193.
[8] سورة طه: 124.








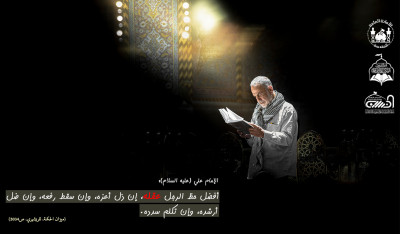



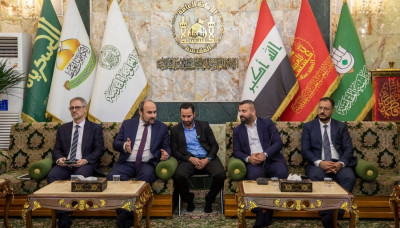







اترك تعليق