مشكلة العالم التي تملأ فكر الإنسانية وتمس واقعها بالصميم هي مشكلة النظام الاجتماعي الذي يصلح للإنسانية، وتسعد به في حياتها الاجتماعية؛ لأن النظام داخل في حساب الحياة الإنسانية، ومؤثر في كيانها الاجتماعي. وأهم الأنظمة الاجتماعية التي تسود العقلية الإنسانية العامة اليوم، ويقوم بينها الصراع الفكري أو السياسي على اختلاف مدى وجودها الاجتماعي في حياة الإنسان هي أربعة.
ويتقاسم العالم اثنين من هذه الأنظمة: النظام الديمقراطي الرأسمالي وهو أساس الحكم في بقعة كبيرة من الأرض، والنظام الاشتراكي هو السائد في بقعة كبيرة أخرى. وكلٌّ من النظامين يملك كيانًا سياسيًا عظيمًا، يحميه في صراعه مع الآخر، ويسلحه في معركته التي يخوضها أبطاله في سبيل الحصول على قيادة العالم، وتوحيد النظام الاجتماعي فيه. والنظامان الآخران هما: الشيوعي والإسلامي، فوجودهما بالفعل فكري خالص. غير أن النظام الإسلامي مرّ بتجربة من أروع تجارب النُّظم الاجتماعية وأنجحها، ثمّ عصفت به العواصف بعد أن خلا الميدان من القادة المبدئيين أو كاد، وبقيت التجربة في رحمة أناس لم ينضج الإسلام في نفوسهم، ولم يملأ أرواحهم بروحه وجوهره، فعجزت عن الصمود والبقاء، فتقوض الكيان الإسلامي. وأما النظام الشيوعي فهو فكرة غير مُجربة حتى الآن تجربة كاملة، وإنما تتجه قيادة النظام الاشتراكي اليوم إلى تهيئة جـوٍّ اجتماعي له، بعد أن عجزت عن تطبيقه حين ملكت زمام الحكم، فأعلنت النظام الاشتراكي، وطبقته كخطوة إلى الشيوعية الحقيقية.
والنظام الديمقراطي الرأسمالي قد أطاح بلون مـن الظلم في الحياة الاقتصادية، وبالحكم الدكتاتوري في الحياة السياسية، وبجمود الكنيسة وما إليها في الحياة الفكرية، وهيأ مقاليد الحكم والنفوذ لفئة حاكمة جديدة حلت محل السابقين، وقامت بنفس دورهم الاجتماعي في أسلوب جدید.
وفي الاشتراكية مذاهب متعددة، وأشهرها المذهب الاشتراكي القائم على النظرية الماركسية والمادية الجدلية التي هي عبارة عن فلسفة خاصة للحياة، وفهم مادي لها على طريقة الديالكتيكية (الشيوعية). وقد طبق الماديون هذه المادية على التأريخ والاجتماع والاقتصاد، فصارت عقيدةً فلسفية في شأن العالم، وطريقة لدرس التأريخ والاجتماع، ومذهبًا في الاقتصاد، وخطة في السياسة. فهي تصوغ الإنسان كله في قالب خاص، من حيث لون تفكيره ووجهته نظره إلى الحياة وطريقته العملية فيها.
وتختلف الشيوعية عن الاشتراكية في الخطوط الاقتصادية الرئيسة؛ وذلك لأن الاقتصاد الشيوعي يرتكز: على إلغاء الملكية الخاصة ومحوها محوًا تامًا من المجتمع، وتمليك الثروة كلها للمجموع، وتسليمها إلى الدولة باعتبارها الوكيل الشرعي عن المجتمع في ذلك واستثمارها لخير المجموع. وعلى توزيع السلع المنتجة على حسب الحاجات الاستهلاكية للأفراد، وعلى منهاج اقتصادي ترسمه الدولة، وتوفّق فيه بين حاجة المجموع والإنتاج في كميته، وتنويعه، وتحديده؛ لئلا يمنى المجتمع بنفس الأزمات التي حصلت في المجتمع الرأسمالي حينما أطلق الحريات بغير تحديد.
والواقع: أن النظام الشيوعي وإن عالج جملة من أدواء الرأسمالية الحرة بمحوه للملكية الفردية، غير أن هذا العلاج ناقص لا يضمن القضاء على الفساد الاجتماعي كله؛ لأنه لم يحالفه الصواب في تشخيص الداء، وتعيين النقطة التي انطلق منها الشرّ حتى اكتسح العالم في ظل الأنظمة الرأسمالية، فبقيت تلك النقطة محافظة على موضعها من الحياة الاجتماعية في المذهب الشيوعي. وبهذا لم تظفر الإنسانية بالحلّ الحاسم لمشكلتها الكبرى، ولم تحصل على الدواء الذي يطبّب أدواءها، ويستأصل أعراضها الخبيثة.
التعليل الصحيح للمشكلة:
تتلخص الفكرة التي أقامها النظام الرأسمالي مقياسًا وغاية، وهي الأساس الحقيقي للبلاء الاجتماعي وفشل الديمقراطية الرأسمالية في تحقيق سعادة الإنسان وتوفير كرامته، في التفسير المادي المحدود للحياة الذي أشاد عليه الغرب صرح الكون؛ فإنّ كل فرد في المجتمع إذا آمن بأن ميدانه الوحيد في هذا الوجود هو: حياته المادية الخاصة، وآمن - أيضًا - بحريته في التصرف بهذه الحياة واستثمارها، وأنه لا يمكن أن يكسب من هذه الحياة غاية إلا اللذة التي يمكن أن توفرها له المادة، وأضاف هذه العقائد المادية إلى حب الذات الذي هو من صميم ذاته، وسوف يسلك السبيل الذي سلكه الرأسماليون، وينفذ أساليبهم كاملة، ما لم تحرمه قوة قاهرة من حريته، وتسدّ عليه السبيل.
وحب الذات هو الغريزة التي لا نعرف غريزة أعم منها وأقدم، فكل الغرائز فروع هذه الغريزة وشعبها، بما فيها غريزة المعيشة. فإنّ حبّ الإنسان لذاته - الذي يعني: حبه للذة والسعادة لنفسه، وبغضه للألم والشقاء لذاته - هو الذي يدفع الإنسان إلى كسب معيشته وتوفير حاجياته الغذائية والمادية. ولذا قد يضع حدًا لحياته بالانتحار إذا وجد أن تحمل ألم الموت أسهل عليه من تحمل الآلام التي تزخر بها حياته.
وعليه، فلا يمكن تكليف الإنسان أن يتحمّل مرارة الألم دون شيء من اللذة، في سبيل أن يلتذ الآخرين ويتنعموا، إلا إذا سُلبت منه إنسانيته، وأعطي طبيعة جديدة لا تتعشق اللذة، ولا تكره الألم.
العلاج الصحيح للمشكلة
والعالم أمامه طريقان إلى دفع الخطر وإقامة دعائم المجتمع المستقر:
الطريق الأول: أن يُبدل الإنسان غير الإنسان، أو تخلق فيه طبيعة جديدة تجعله يضحي بمصالحه الخاصة، ومكاسب حياته المادية المحدودة في سبيل المجتمع ومصالحه، مع إيمانه بأنّه لا قيم إلا قيم تلك المصالح المادية، ولا مكاسب إلا مكاسب هذه الحياة المحدودة. وهذا إنما يتمّ إذا انتزع من صميم طبيعته حب الذات، وأُبدل بحب الجماعة، فيولد الإنسان وهو لا يحبّ ذاته إلا باعتبار كونه جزءًا من المجتمع، ولا يلتذ لسعادته ومصالحه إلا بما أنها تمثل جانبًا من السعادة العامة ومصلحة المجموع؛ فإنّ غريزة حبّ الجماعة تكون ضامنة - حينئذٍ - للسعي وراء مصالحها وتحقيق متطلباتها بطريقة ميكانيكية وأسلوب آلي.
الطريق الآخر: أن يطوّر المفهوم المادي للإنسان عن الحياة، وبتطويره تتطور طبيعيًا أهدافه الإنسانية ومقاييسها.
والطريق الأول هو الذي يحلم أقطاب الشيوعيين بتحقيقه للإنسانية في مستقبلها، ويعِدون العالم بأنهم سوف ينشؤون الإنسانية إنشاء جديدًا، يجعلها تتحرك ميكانيكيًا إلى خدمة الجماعة ومصالحها. وإن استسلام الإنسانية لذلك هو أكبر دليل على مدى الظلم الذي قاسته في النظام الديمقراطي الرأسمالي، الذي خدعها بالحريات المزعومة، وسلب كرامتها، وامتص دماءها؛ ليقدمها شرابًا سائغًا للفئة المدللة التي تمثلها الحاكمون.
وأما الطريق الثاني، فهو الذي سلكه الإسلام؛ إيمانًا منه بأنّ الحل الوحيد للمشكلة تطوير المفهوم المادي للإنسان عن الحياة. فلم يبتدر إلى مبدأ الملكية الخاصة ليبطله، وإنما أقصى المفهوم المادي عن الحياة، ووضع للحياة مفهومًا جديدًا، وأقام على أساس ذلك المفهوم نظامًا لم يجعل فيه الفرد آلة ميكانيكية في الجهاز الاجتماعي، ولا المجتمع هيئة قائمة لحساب الفرد، بل وضع لكل منهما حقوقه، وكفل للفرد كرامته المعنوية والمادية معًا. فالإسلام وضع يده على نقطة الداء الحقيقية في النظام الاجتماعي للديمقراطية وما إليه من أنظمة، فمحاها محوًا ينسجم مع الطبيعة الإنسانية.
وقد أوجد الإسلام بتلك القاعدة الفكرية النظرة الصحيحة للإنسان إلى حياته، فجعله يؤمن بأن حياته منبثقة عن مبدأ مطلق الكمال، وأنها إعداد للإنسان إلى عالم لا عناء فيه ولا شقاء، ونصب له مقياسًا خُلقيًا جديدًا في كل خطواته وأدواره. فليس كل ما تفرضه المصلحة الشخصية فهو جائز، وكل ما يؤدي إلى خسارة شخصية فهو محرّم وغير مستساغ، بل الهدف الذي رسمه الإسلام في حياته هو: الرضا الإلهي. والمقياس الخُلُقي الذي تم توزن به جميع الأعمال إنما هو: مقدار ما يحصل بها من هذا الهدف المقدس. والإنسان المستقيم هو: الإنسان الذي يحقق هذا الهدف. والشخصية الإسلامية الكاملة هي: الشخصية التي سارت في شتى أشواطها على هدي هذا الهدف، وضوء هذا المقياس، وضمن إطاره العام.
رسالة الدين
ويقوم الدين هنا برسالته الكبرى التي لا يمكن أن يضطلع بأعبائها غيره، ولا أن تتحقق أهدافها البناءة وأغراضها الرشيدة إلا على أسسه وقواعده، فيربط بين المقياس الفطري للعمل والحياة وهو: حب الذات، والمقياس الذي ينبغي أن يقام للعمل والحياة؛ ليضمن السعادة والرفاه والعدالة. والتوفيق والتوحيد بين المقياسين يحصل بأسلوبين:
الأسلوب الأول: هو تركيز التفسير الواقعي للحياة وإشاعة فهمها في لونها الصحيح كمقدمة تمهيدية إلى حياة أخروية، يكسب الإنسان فيها من السعادة على مقدار ما يسعى في حياته المحدودة هذه في سبيل تحصيل رضا الله. فالمقياس الخلقي - أو رضا الله تعالى ـ يضمن المصلحة الشخصية في نفس الوقت الذي يحقق فيه أهدافه الاجتماعية الكبرى. فالدين يأخذ بيد الإنسان إلى المشاركة في إقامة المجتمع السعيد، والمحافظة على قضايا العدالة فيه التي تحقق رضا الله تعالى؛ لأن ذلك يدخل في حساب ربحه الشخصي ما دام كل عمل ونشاط في هذا الميدان يُعوض عنه بأعظم العوض وأجلّه.
الأسلوب الثاني: التعهد بتربية أخلاقية خاصة تعنى بتغذية الإنسان روحيًا، وتنمية العواطف الإنسانية والشاعر الخُلقية فيه. فإنّ في طبيعة الإنسان طاقات واستعدادات لميول متنوّعة: بعضها ميول مادية تتفتح شواتها بصورة طبيعية كشهوات الطعام والشراب والجنس، وبعضها ميول معنوية تتفتح وتنمو بالتربية والتعاهد؛ ولأجل ذلك كان من الطبيعي أصبح ـ إذا ترك لنفسه ـ أن تسيطر عليه الميول المادية، وتظل الميول المعنوية واستعداداتها الكامنة في النفس مستترة. والدين باعتباره يؤمن بقيادة معصومة مسددة من الله، فهو يوكل أمر التربية الإنسانية وتنمية الميول المعنوية فيها إلى هذه القيادة وفروعها، فتنشأ بسبب ذلك مجموعة من العواطف والمشاعر النبيلة، ويصبح الإنسان يحبّ القيم الخُلقية والمثل التي يربيه الدين على احترامها، ويزيح عن طريقها ما يقف أمامها من مصالحه ومنافعه.
وليس معنى ذلك أن حب الذات يُمحى من الطبيعة الإنسانية، بل إن العمل في سبيل تلك القيم تنفيذ كامل لإرادة حب الذات؛ فإن القيم بسبب التربية الدينية تصبح محبوبة للإنسان، ويكون تحقيق المحبوب بنفسه معبرًا عن لذة شخصية خاصة، فتفرض طبيعة حب الذات بذاتها السعي لأجل القيم الخُلقية المحبوبة تحقيقًا للذة الخاصة بذلك.
فالدولة الإسلامية لها وظيفتان: إحداهما تربية الإنسان على القاعدة الفكرية، وطبعه في اتجاهه وأحاسيسه بطابعها، والأخرى مراقبته من خارج، وإرجاعه إلى القاعدة إذا انحرف عنها عمليًا.
ولذلك فليس الوعي السياسي للإسلام وعيًا للناحية الشكلية من الحياة الاجتماعية فحسب، بل هو وعي سياسي عميق، مرده إلى نظرة كلية كاملة نحو الحياة والكون والاجتماع والسياسة والاقتصاد والأخلاق، فهذه النظرة الشاملة هي الوعي الإسلامي الكامل.
- وفي نهاية المطاف على المذاهب الاجتماعية الأربعة، نخرج بنتيجة، هي: أن المشكلة الأساسية التي تتولّد عنها كل الشرور الاجتماعية وتنبعث منها مختلف ألوان الآثام، لم تُعالج المعالجة الصحيحة التي تحسم الداء وتستأصله من جسم المجتمع البشري في غير المذهب الاجتماعي للإسلام.
*انظر: كتاب فلسفتنا، للسيد محمد باقر الصدر (قدس سره) - التمهيد: من ص 19 - 62.





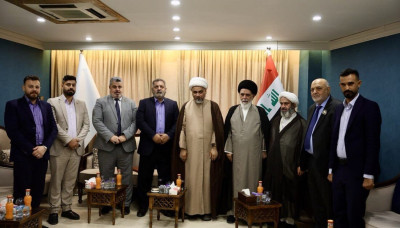


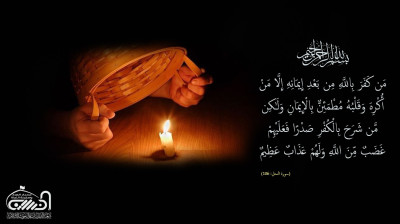

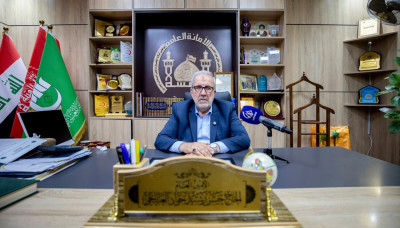










اترك تعليق