التغيير مبدأ مطلوب للإنسان في حال ركود حياتهم وعدم جدواها، والذي يفرض على الإنسان أن يتحرك ليغير حياته من حال إلى حال، من حسن حال إلى أحسن، ومن سيء إلى أفضل، ولكن هذه العملية ليست بالسهلة، بل هي من أصعب العمليات وأعقدها وأشقاها.
ونظراً لصعوبة هذه العملية، يجب علينا أن نستكشف عناصرها وأركانها ومقوماتها لتكون عملية التغيير عملية تسير وفق خطة منهجية علمية تؤدي المطلوب، حالها حال أي عملية علمية أخرى، والتي ترتكز على ثلاث ركائز أساسية، هي:
1- توفر الدافع للتغيير.
2- وجود الخطة التغييرية.
3- توفر الإرادة الفاعلة اللازمة للتغيير.
4- السير في عملية التغيير وفق سلوك نموذجي مسبق يصطلح عليه بالقدوة.
وهنا نسأل عن أهم هذه الأمور اللازمة لإجراء العملية التغييرية، فنقول: ما هو الدافع الأهم لإجراء التغيير؟ هل هو فكر الإنسان أم إرادته أم هي مسألة أعمق من ذلك؟
والجواب المعرفي على هذا السؤال يحدد لنا الدافع وراء ذلك، ويكشف لنا أن المسألة أعمق من الفكر والإرادة، لأنها عملية دائمة بدوام الحياة تحتاج إلى دافع لا ينضب، فالدنيا متنقلة بأهلها من حال إلى حال دائماً وهي محتاجة إلى دافع دائم أيضاً، وعليه فوجوده ضروري لتطور وتحسن الحياة التي تتحسن بتحسين وتغير السلوك والتصرفات الإنسانية، كونه المحرك الأساسي الذي لا يعلوا فوقه شيء لفعل هذا التغيير.
والتغيير بهذا المفهوم ينطوي على فوائد جمة تحقق مصالح الإنسان ورغباته وتؤمن له مشتهياته، وهو أمر مرغوب فيه يسعى إليه الإنسان دائماً، لا يمكن تحققه إلا بعزيمة نفس الإنسان على تحقق ذلك، وهذا ما نعنيه بالدافع الفطري الذي لا يقبل التخلف ولا يحتاج إلى تعليم وتعلم وهو مشترك عند أبناء الجنس الواحد.
وبالرغم من وجود الدافع الفطري في عملية التغيير، إلا أننا نلحظ أن عملية إجراءه لا تكتفي بالدافع الفطري، لأنه نافع على مستوى التحفيز والتنشيط ليس إلا، والتغيير يحتاج إلى خطوات عملية لإجرائه وتحققه، وهي تستند دائماً إلى عنصرين أساسيين، هما:
1- إرادة الإنسان الفاعلة.
2- وفكره وعقيدته.
وهو ما نفهمه من قول الله تبارك وتعالى: {... إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم...}[1]، وكلمة ما بأنفسهم هي التي لفتت نظرنا إلى هذا المستند في التغيير الذي يجب أن ينطلق من ذات الإنسان وداخله، أي الدافع الفطري ثم الفكر والعقيدة، وهذا لا يتم إلا مع توفر إرادة قوية.
وعليه فعملية التغيير تبنى على:
1- الدافع النفسي الفطري.
2- الدافع الفكري والعقائدي.
3- الإرادة الإنسانية الفاعلة.
ويمكن إجمالها بالمراحل التالية:
المرحلة الأولى: مرحلة التشخيص واتخاذ القرار بالتغيير فطرياً.
المرحلة الثانية: مرحلة بناء الخطة التصورية لكيفية إجراء التغيير وحدوثه.
المرحلة الثالثة: مرحلة التطبيق وفق نموذج تطبيقي ناجح على الدوام(قدوة).
ومخط إجرائها كالتالي:
ونستنتج مما سبق أن عملية التغيير لا تحدث اتفاقاً وكيف ما كان، بل هي عملية منهجية علمية وليست اتفاقية، وكذا مرحلية متسلسلة ومتتابعة.
لذا قيل فيها: لا تجعل شخصاً يحدد لك ما تفعله أو يقنعك بما تفعله حتى لو كان غير صحيح، فتكون حياتك كما يريد هو لا كما تريد أنت، بمعنى أن التغيير يجب أن يكون نابع من ذاتك لا من ذات الآخرين.
والجدير بالذكر، أن أهم مرحلة في عملية التغيير، هي: مرحلة رسم الخطة التصورية للتغيير من ناحية عملية، وهي تعتمد على الفكر والإرادة بالدرجة الأساس كما بينا أعلاه، إذ أن الأفكار والمعتقدات هي بمثابة برامج خفية في الكومبيوتر تقود السلوك الإنساني والذي هو أساس تغيير الحال، حيث تشكل لدى صاحبها قواعد أساسية لقيادة التطبيق وما هو صحيح فعله وما هو خطأ، وهو شيء مرتبط بطريقة تغيير الأشخاص للأحداث والظروف.
وهنا يجب أن نلفت النظر إلى نقطتين أساسيتين في هذه العملية من أجل انجاحها، وهما مختصتان بمرحلة العمل والتطبيق لا مرحلة النظر:
النقطة الأولى: أن التغيير حال إجرائه عملياً بحاجة إلى قدوة تتخذ في حال التطبيق، ونموذجاً يحتذى به لتصحح على ضوء سلوكه التطبيقي الأخطاء التطبيقية، وتسمى هذه العملية بعملية النمذجة، ومثالها ما ورد في الحديث الشريف عن النبي الأكرم(صلى الله عليه وآله): ((صلوا كما رأيتموني أصلي))[2].
النقطة الثانية: أن الحال المُغير تكون له الأولوية في الحال في الحياة بالنسبة للفرد والمجتمع فيجرى التغيير على أساسه حتى لا نشتغل بتغيير التوافه من الأمور التي قد تفرض علينا على أنها أولويات يلزم تغييرها وليست كذلك، كالتي يفرضها اليوتيوب والتيك توك ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، والتي تأخذ في ظاهرهاً شكلاً إعلامياً، لكنها في الواقع عبارة عن تغذية فكرية وعقدية وفلسفية تقود الحياة الفردية والاجتماعية.
والملاحظ أن هذا الفرض المفترض في الموضوعات والاهتمامات البشرية الإنسانية لم يُجنى من ورائه غير تعثر الحياة وتعقيدها وعدم انتاجيتها، ومادام الحال هذه، يجب علينا عندها أن نتمسك بما هو واقعي، وهي الموضوعات التي تطرحها وتشخصها الشريعة الإسلامية، والتي لا تهدف سوى مصلحتنا، فتكون تعاليمها وما تعرض علينا من موضوعات وضرورات موضع عنايتنا في أولويات التغيير واهتماماتنا، حتى ينجو الإنسان ويستقيم حاله في هذه الدنيا وتسعد حياته، وهذا لا يمكن الالتزام به إلا إذا تحققت لدينا القناعات التالية:
أولاً: أن الله سبحانه وتعالى هو الجهة الوحيدة التي لا تريد مني منفعة خاصة، بل تريد نفعي مطلقاً، أي: في كل الأحوال، وذلك نلتمسه في قوله تبارك وتعالى: {الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ}[3]، فيلزم أن اختار الأفضل بحسب مصلحتي.
ثانياً: أن اعتقد واقتنع أن كل شيء لا ينفعني في حياتي وليس له ضرورة يلزم أن اجتنبه، لأنه إن لم ينفعني في اغلب الأحيان فأنه يضرني.
ثالثاً: ما يريده الله جلّ وعلا يلزم أن أفعله، حتى لو كان ذلك خلاف مشتهيات نفسي ورغباتها، لأني على يقين أن ذلك في مصلحتي التي لا أعلم بها في كثير أو أغلب الأحيان.
ومنه بحث العلماء مسألة مهمة، هي: أن الأحكام الشرعية هي التي تنظم أفعال الإنسان وتنير دربه وتسعد حياته، وذلك لمراعاتها المصالح والمفاسد في الفعل، فمثلاً: فإن تناول ما يضر الإنسان، فهو فعل محرم كالمخدرات والمسكرات والزنا والعياذ بالله سبحانه، وحكمه الحرمة، أي: حرام تناولها؛ حرام شربها؛ حرام فعلها، والعكس صحيح للمنفعة التي ينطوي عليها.
ويمكن توضيح ذلك من خلال الآتي:
الاحكام الشرعية في الإسلام خمسة: واجب، حرام، مستحب، مكروه، مباح، وأحكامها تتوزع وفق نسب المصلحة والمفسدة بقراءة الجدول التالي:
وما دام الأمر كذلك، فإن التغيير النافع يلزم أن يكون موافق لما يخدم منفعتنا ومصلحتنا، ولا يؤمن لنا ذلك غير الالتزام بأداء أفعالنا وفق الأحكام الشرعية التي اخذت منفعتنا ومصلحتنا بنظر الاعتبار، فنجعل عند ذاك من حياتنا موافقة لما يريده الشارع المقدس، من باب توافق المصلحة والمفسدة أو النفع والضرر النوعي والشخصي مع المصلحة والمفسدة أو النفع والضرر الشخصي والنوعي، فما نهتنا عنه الشريعة الإسلامية ننتهي عن فعله، وما أمرتني به أفعله، وهكذا.
والجدير بالذكر أن الشريعة الإسلامية لا تأمر وتنهى بناء على المصلحة والمفسدة التي تنعكس على الشخص في الفعل فقط، بل التي تنعكس على النفس أيضاً فتلوثها أو تزيدها جمالاً أيضاً، لذا بنت أمرها في الأوامر والنواهي على أساس الحب والبغض لهذا الفعل وهذا الفاعل، فنراها تستخدم الألفاظ والتشبيهات والأمثلة المنفردة المحببة لنفس الإنسان، مع دعم هذه الخصيصة بذكر عاقبة الفعل وارتداداته وامتداداته، والذي يسبب شدة وضعف الرغبة في الفعل وعدمه.
فمثلاً يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}[4]، فنلاحظ التنفير من الفعل في ذكر كلمة الرجس المستقبح ذاتاً قبل أي شيء آخر، ويقول: {مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ}[5]، فنلاحظ التحبيب في الأمر وعدمه بذكر العاقبة.
وناتج الأمر أننا إذا اردنا تغيير الحياة وتحويلها من حياة تعيسة مليئة بالشقاء إلى الحياة الهنيئة السعيدة البعيدة عن المنغصات سواء كان علمت بها أو لم تعلم بها، يلزم أن نتقيد بضوابط العملية التغيرية التي مرت آنفاً، وهي لازم مؤكد لا ينفك إذا ما أردت النجاح في التغيير، لذا نرى أن الشريعة الإسلامية تنسب تغيير الحال إلى داخل الإنسان وليس خارجه، إلى نفس الإنسان ودافعه الفطري وليس عضلاته وأعصابه، إذ يقول(جلّ جلاله): {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}[6]، ويقول(جلّ وعلا): {وَلَأُضِلَّنَّهُم وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا}[7]، ويقول سبحانه: {أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ}[8]، وغيرها من الآيات التي تنسب تغير الحال نسبة واقعية للإنسان نفسه وتحمله جميع المسؤوليات في حال سوء الحال وخيره، لأن التغيير ينبع من النفس الإنسانية ودافعها الفطري، كما قال الله تبارك وتعالى: {وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ}[9]، وقال سبحانه: {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ}[10].
الهوامش:------
[1] سورة الرعد: 11.
[2] مختلف الشيعة، العلامة الحلي، ج ٢، ص: ٢٥٧، نقلاً عن: صحيح البخاري: ج ١، ص: ١٦٢، 163.
[3] سورة البقرة: 268.
[4] سورة المائدة: 90
[5] سورة الأنعام: 160
[6] سورة الأنفال: 53.
[7] سورة النساء: 119.
[8] سورة البقرة: 75.
[9] سورة الشورى: 30.
[10] سورة الروم: 41.



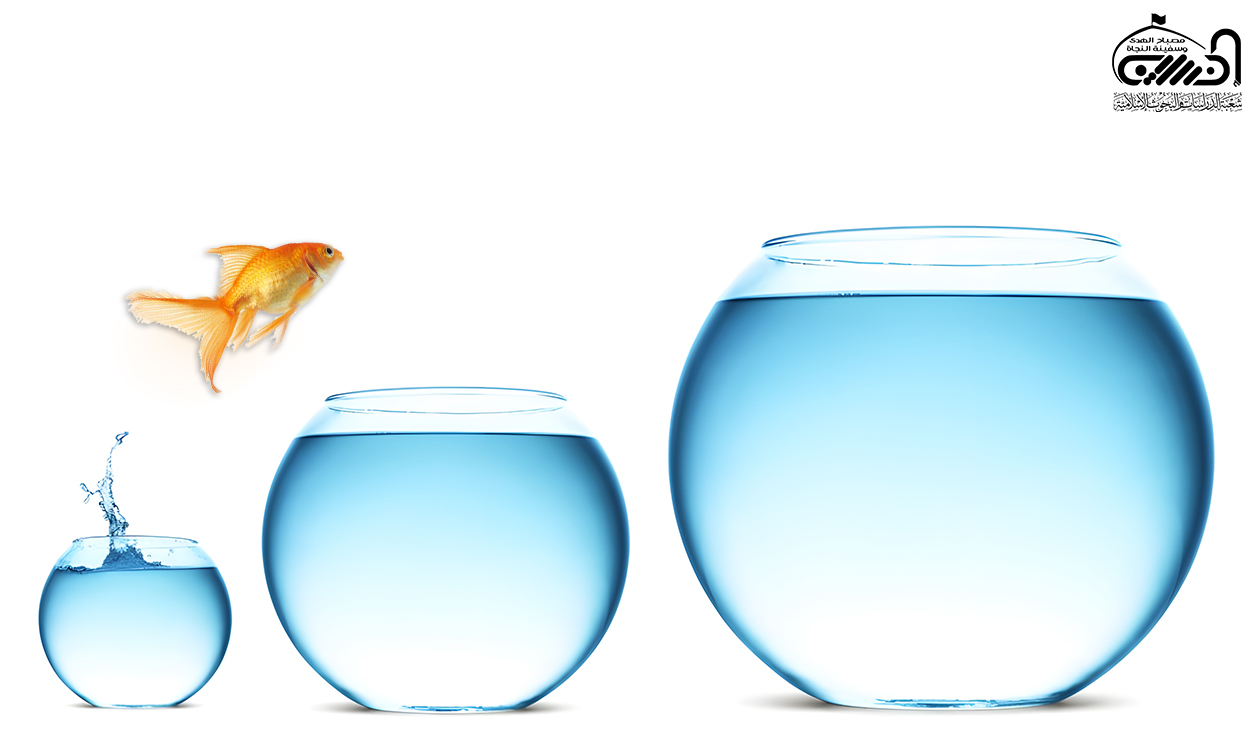








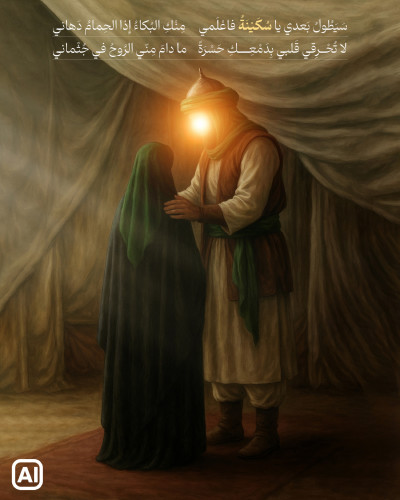



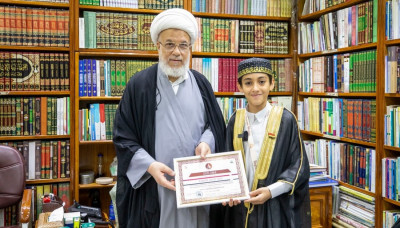





اترك تعليق