الأمر بين الأمرين له معانٍ كلّها صحيحة و هي:
الأول: أن يكون الجبر المنفي هو ما ذهب إليه المجبرة والأشاعرة ، والتفويض المنفي هو كون العبد مستقلاً في الفعل بحيث لا يقدر الرب تعالى على صرفه عنه كما ذهب إليه بعض المعتزلة، والأمر بين الأمرين هو أن الله تعالى جعل عباده مختارين في الفعل والترك مع قدرته على صرفهم عما يختارون وعلى جبرهم على ما لا يفعلون .
الثاني: ما سلكه شيخ الطائفة المحقة الشيخ المفيد في شرحه على الاعتقادات حيث قال بعد قول الصدوق: اعتقادنا في الجبر و التفويض قول الصادق -عليه السّلام- : لا جبر و لا تفويض بل أمر بين الأمرين ما لفظه: الجبر هو الحمل على الفعل و الاضطرار إليه بالقسر و الغلبة، و حقيقة ذلك إيجاد الفعل في الخلق من غير أن يكون لهم قدرة على دفعه و الامتناع من وجوده فيه، و قد يعبر عما يفعله الإنسان بالقدرة التي معه على وجه الإكراه له على التخويف و الإلجاء أنه جبر، والأصل فيه ما فعل من غير قدرة على امتناعه حسب ما قدمناه، و إذا تحقق القول في الجبر على ما وصفناه كان مذهب الجبر هو قول من يزعم أن اللّه تعالى خلق الطاعة في العبد من غير أن يكون للعبد قدرة على ضدها و الامتناع منها، وخلق فيهم المعصية كذلك، فهم المجبرة حقاً و الجبر مذهبهم على التحقيق و التفويض هو القول برفع الحظر عن الخلق في الأفعال، والإباحة لهم مع ما شاءوا من الأعمال، و هذا قول الزنادقة و أصحاب الإباحات، و الواسطة بين هذين القولين أن اللّه أقدر الخلق على أفعالهم و ملكهم من أعمالهم و حد لهم الحدود في ذلك، ورسم لهم الرسوم و نهاهم عن القبائح بالزجر و التخويف و الوعد و الوعيد، فلم يكن بتمكينهم من الأعمال مجبراً لهم عليها، و لم يفوض إليهم الأعمال لمنعهم من أكثرها، و وضع لهم الحدود فيها و أمرهم بحسنها و نهاهم عن قبحها، فهذا هو الفصل بين الجبر و التفويض ...
الثالث: إن الأسباب القريبة للفعل بقدرة العبد، والأسباب البعيدة كالآلات و الأدوات و الجوارح و الأعضاء و القوى بقدرة اللّه سبحانه، فهذا هو الأمر بين الأمرين.
الرابع: إن المراد بالأمر بين الأمرين كون بعض الأشياء باختيار العبد كالأفعال التكليفية و نحوها، و بعضها بغير اختياره كالصحة و المرض و النوم و اليقظة و أشباهها.
الخامس: إن التفويض المنفي هو تفويض الخلق و الرزق و تدبير العالم إلى العباد كما ذهب إليه الغلاة في الأئمة -عليهم السّلام- و المفوضة، و يؤيد ذلك ما رواه الصدوق في العيون بإسناده عن يزيد بن عمير قال: دخلت على علي بن موسى الرضا -عليه السّلام- بمرو فقلت له يا بن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) روي لنا عن الصادق (عليه السّلام) أنه قال لا جبر و لا تفويض بل أمر بين أمرين فما معناه؟ فقال (عليه السّلام): من زعم أن اللّه تعالى يفعل أفعالنا ثم يعذبنا عليها فقد قال بالجبر، ومن زعم أن اللّه عز و جل فوض أمر الخلق و الرزق إلى حججه (عليهم السّلام) فقد قال بالتفويض، فالقائل بالجبر كافر و القائل بالتفويض مشرك. فقلت له يا بن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فما أمر بين أمرين فقال: وجود السبيل إلى إتيان ما أمروا به، و ترك ما نهوا عنه. فقلت له فهل للّه عز و جل مشيئة و إرادة في ذلك. فقال: أما الطاعات فإرادة اللّه و مشيئته فيها الأمر بها و الرضا بها و المعاونة عليها، و إرادته و مشيئته في المعاصي النهي عنها و السخط لها و الخذلان عليها، فقلت فلله عز و جل فيها القضاء، قال نعم ما من فعل يفعله العباد من خير و شر إلا و للّه تعالى فيه قضاء قلت فما معنى هذا القضاء، قال الحكم عليهم بما يستحقونه على أفعالهم من الثواب و العقاب في الدنيا و الآخرة.
السادس: ما اختاره العلامة المجلسي- رحمه اللّه- و تنطبق عليه أكثر أخبار الباب و هو: إن الجبر المنفي قول الأشاعرة و الجبرية كما عرفت، و التفويض المنفي هو قول المعتزلة إنه تعالى أوجد العباد و أقدرهم على أعمالهم و فوض إليهم الاختيار، فهم مستقلون بإيجادها على وفق مشيئتهم و قدرتهم و ليس لله سبحانه في أعمالهم صنع، و أما الأمر بين الأمرين فهو أن لهدايته تعالى و توفيقاته مدخلاً في أفعالهم بحيث لا يصل إلى حد الالتجاء و الاضطرار، كما أن لخذلانه سبحانه مدخلاً في فعل المعاصي و ترك الطاعات لكن لا بحيث ينتهي إلى حد لا يقدر معه على الفعل و الترك، و هذا أمر يجده الإنسان من نفسه في أحواله المختلفة، وهو مثل أن يأمر السيد عبده بشيء يقدر على فعله و فهمه ذلك، و وعده على فعله شيئاً من الثواب و على تركه قدراً من العقاب، فلو اكتفى بتكليف عبده بذلك و لم يزد عليه مع علمه بأنه لا يفعل الفعل بمحض ذلك لم يكن ملوماً عند العقلاء لو عاقبه على تركه و لا ينسب عندهم إلى الظلم، و لا يقول عاقل إنه أجبره على ترك الفعل. و لو لم يكتفِ السيد بذلك و زاد في ألطافه و الوعد بإكرامه و الوعيد على تركه، و أكد ذلك ببعث من يحثه على الفعل و يرغبه فيه و يحذره على الترك، ثم فعل ذلك بقدرته و اختياره فلا يقول عاقل إنه أجبره على الفعل، و أما الفعل ذلك بالنسبة إلى قوم و تركه بالنسبة إلى آخرين فيرجع إلى حسن اختيارهم و صفاء طويتهم و سوء اختيارهم و قبح سريرتهم، أو لسبب لا يصل إليه علمنا، فالقول بهذا لا يوجب نسبة الظلم إليه سبحانه بأن يقال جبرهم على المعاصي ثم يعذبهم عليها كما يلزم الأولين، و لا عزله سبحانه عن ملكه و استقلال العباد بحيث لا مدخل له في أفعالهم فيكونون شركاء للّه في تدبير عالم الوجود كما يلزم الآخرين...
من كتاب : حقّ اليقين في معرفة أصول الدّين / للمؤلّف : العلّامة المحقّق السّيّد عبد الله شبّر .











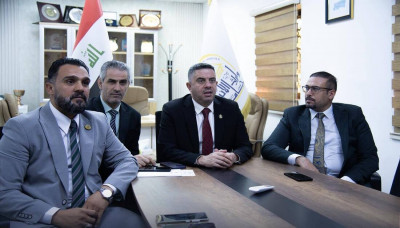






اترك تعليق