إنّ الركن الركين لمسائل التوحيد وبراهين معرفة الله تعالى التنزيهية وغيرها من بحوث العقيدة الحقة، ليست أبحاث "علم المعرفة" أو "نظرية المعرفة"، ولا النظريات الفلسفيّة المعقّدة ونحوها، بل الأساس الوحيد للعقيدة الصحيحة؛ هو: معرفة حُجَج الله تعالى على الناس، وهم: الأنبياء والأوصياء(عليهم السلام)؛ فمن أخذ منهم وتعقّل عنهم فاز بالعلم الصحيح، ومن انقطع عنهم ورجع إلى غيرهم ضلّ ضلالاً بعيدًا.
وفي معرض الاستدلال على هذه القاعدة المنهجية لا بدّ من التركيز على نقاط أساسية:
⏺ أوّلًا: حقيقة اليقين
بعد أن يتَفطَّن الإنسان إلى مقدّماتِ البرهان، ويُحرز تماميّتها على النحو المتعارف والمتداول والمعتبر لدى العقلاء بصورة عامّة، ويحصّل اليقين العقلي القطعي، فهل يصح بعد ذلك التشكيك في اعتبار النتيجة لديه؟
إنّ غالب الباحثين في علمِ المعرفة يجيبون بعدم اعتبار هذه النتيجة في نفسها، ويزعمون أنّ هذا إنّما هو مبتدأُ الطريق لا منتهاه؛ إذ لا بدّ ـ برأيهم ـ من إقامةِ برهانٍ آخر على أنّ يقينَنا مطابقٌ للواقع، وأنّ عقلنا لم يُخطئ في هذا المقام.
يرد عليهم: إذا كانت المقدّمات تامّة برأي الإنسان القاطع؛ فلا مناقشة فيها لديه، فكيف يُعقل التشكيكُ في نفس اليقين المتولّد منها؟
فيُجيبون: أنّ الإنسانَ كثيرًا مّا يظنّ أنّه قد بلغ يقينًا عقليًّا لا يخطأ، ثمّ يتبيّن له لاحقًا بطلان يقينِه، أو يتبيّن للآخرين أنّه أقامَ نظريّةً على أساسٍ ظنّيٍّ لا على قاعدةٍ بديهيّة؛ فالفلاسفة يدّعون القطعَ العقليَّ في قضاياهم غالباً، مع أنّ تناقضَ آرائهم يدلّ على وقوعِ الخطأ في كثيرٍ منها. فكيف يُسلَّم إذن بسلامةِ كلّ يقينٍ يُدّعى عليه البرهان؟
نقول:
١- أيّ طريقٍ سلكه الإنسان، فلن يخرجَ عن هذه الدائرة؛ لأنّ القطعَ تصديقٌ ذهنيٌ، وهو في ذاته محتمل الصدقِ والكذب، فاحتمالُ الخطأ فيه ذاتيٌّ غيرُ منفكّ.
ولا يعني كلامنا هذا عدم اعتبار اليقين في نفسه في الحسّيات ونحوها ما دام كونه مستقرًا، وإن كان إمكان عدم صحّته ذاتيًا ودائمًا؛ فالشخص العاقل الذي يرى مثلًا سيارة قريبة تأتي إليه بسرعة، يتيقّن بمحاسباته الذهنية أنّها سوف تصيبه إذا وقف مكانه؛ فيجب عليه عقلاً وشرعًا العمل طبقًا لهذا اليقين المستقر لديه، لكن يمكن أن يعلم هذا الشخص في مرتبة لاحقة أنّ ذلك كان تخيّلاً أو حلمًا ونحوه، وهذا الاحتمال لا يبرّر له عدم العمل بمقتضى اليقين حال استقراره لديه، كما لا يعني ذاتيّة مطابقة اليقين للواقع.
هذا شأن ما يتعلّق بأمور الدنيا ونحوها، لكن أمر الآخرة والمعرفة العقديّة بحاجة إلى يقين مستقر معتبر، وذلك لا يحرَز إلاّ من خلال الإيمان بعصمة المعصوم والاعتماد عليه والأخذ منه، كما سنبيّن لاحقًا.
٢- إنّ القطعَ ليس هو الواقع نفسَه، بل هو كَشْفٌ عنه وحكايةٌ له؛ فالخلطُ بين الحكايةِ والمُحكى خطأٌ في المفهوم. واليقينُ إنّما هو مرآةٌ للواقع، لا ذاتُ الواقع.
٣- إنّ أيّ برهانٍ يُقام ـ ولو كان في مباحثِ علمِ المعرفةِ نفسه ـ لا يزيدُ في نتيجتِه على «اليقينِ بالحكايةِ عن الواقع»، وهو نفسه محتاجٌ إلى تصديقٍ آخرَ لمعرفةِ مطابقتِه للواقع، فيتسلسلُ الأمرُ إلى ما لا نهاية، ويقعُ الباحثُ عن قيمة المعرفة في الدورِ الباطل.
ولأجلِ هذا، اعتبرَ المحقّقون أنّ مباحثَ علمِ المعرفة الأساسية ليست براهينَ قاطعة، بل تنبيهاتٌ تذكيرية لما يجده الإنسان العاقل من نفسه، إذ ما يُراد إثباته في مباحث #قيمة_المعرفة يحتاجُ بنفسُه إلى إثباتِ قيمتِه.
ومن هنا كان لا بدّ للإنسان من مرجعٍ معصومٍ يخرجه من هذا الدور في البحوث العقَدية، ويضع له ميزانَ الحقّ الذي لا يختلّ، وهو معنى قول بعض أعلامنا: «إنّ معرفةَ الحُجّةِ أصلُ الأصولِ العقَدية».
⏺ ثانيًا: بقاءِ اليقين وإمكان زواله
وقد يقال: إنّ اليقينَ إذا تحقّق، استحالَ زواله، إذ لا يجتمع اليقين والشكّ في آنٍ واحد.
فنقول: هذا خلطٌ بين استحالة اجتماعهما في آنٍ واحد، وبين تبدّلِ الحالاتِ لدى الإنسان في مختلف الأزمنة.
فاجتماعُ يقينِ اليوم مع زوالِه غدًا مثلًا، لا يُعدّ اجتماعَ نقيضين، لأنّ وحدةَ الزمانِ غير محفوظة؛ فالإنسان قد يكون اليوم على يقينٍ تامٍّ بعقيدة، ثمّ يضعفُ يقينُه ويزول غدًا تحتَ تأثيرِ شبهاتٍ أو دعاياتٍ أو مؤثّراتٍ نفسيّةٍ أو غيرها مما مرّ ذكره، فلا استحالةَ في إمكان زواله عقلًا.
ولهذا يأمرنا الشرعُ والعقلُ معًا بالحذرِ من مجالسةِ أهلِ الضلال، وعدم جواز سماعِ شبهاتهم، إلاّ لمن يملكُ القدرةَ العلميّةَ التامّة على ردّها، لأنّ استقرارَ الإيمانِ منوطٌ بالسلامةِ من التأثّر.
⏺ثالثًا: حقيقةِ العلم والجهل المركّب
قد يُقال: لا يجوزُ الاعتمادُ على الجهلِ المركّب، بل يجبُ بناء العلم على أُسسٍ تضمنُ مطابقةَ الواقع بصورة قطعية غير قابلة للتغيير أبدًا.
فنقول: إنّ المطابقة للواقعِ ليست جزءًا من حقيقةِ العلم، بل أمرٌ خارجٌ عنها؛ فالعلمُ في ذاته هو الكشفُ والإدراكُ، سواء طابقَ الواقعَ أم لم يُطابقه. فالتفريقُ بين «العلم» و«المعرفة» من حيث المطابقة تحكّمٌ لفظيٌّ لا أثرَ له في حقيقة العلم.
⏺رابعًا: العلم الصحيح عند المعصوم دون غيره
النتيجة: إنّ العلمَ الصحيح الذي لا يخطئُ ولا يزولُ بإذن الله تعالى هو علمُ المعصومين عليهم السلام وحدهم، دون أيّ أحد غيرهم، وأيُّ طلبٍ لمثلِ هذا العلم في غيرهم هو استغناءٌ عن الوحي والرسالة، وإنكارٌ لحاجةِ الإنسانِ إلى الهدايةِ الإلهيّة.
ولهذا نقول: إنّ «الإنسانَ قبلَ أن يخوضَ في علمِ المعرفةِ المصطلَح، أو أيّ أبحاث فلسفية، يجب أن يعرفَ عجز نفسه»، فإذا عرفَ جهله وفقرَه وحدوده الذهنية، علمَ أنّه لا غنى له عن المعصوم، وأنّ كلَّ يقينٍ بشريٍّ في الأبحاث المعرفية ممكنُ الزوال، أمّا يقينُ الحجّةِ الإلهيّة فثابتٌ لا يتبدّل بإذن الله تعالى؛ فعلى الإنسان أن يأخذ من المعصوم ليكون يقينه معتبًرا.
⏺خامسًا: ضرورةِ الرجوعِ إلى المعصوم
أما قولُ المعرفيّين إنّ الحاجةَ إلى المعصومِ إنّما هي في غيرِ القطعيّاتِ العقليّة، فباطلٌ من وجوهٍ:
لأنّ تقديمَهم مباحثَ المعرفةِ على سائرِ العلوم، لأجلِ رفعِ احتمالِ الخطأ، يُقابله عندنا تقديمُ معرفةِ الإنسانِ بحاجتِه إلى المعصوم، لأنّ رفعَ الخطأ لا يتحقّقُ إلّا بالرجوعِ إليه كما مر الاستدلال عليه.
ولأنّ نفسَ الخلاف في هذا الموضوع يقتضي الرجوع إلى المعصوم، ولم يردْ عنهم(عليهم السلام) تفريقٌ بين القطعيّاتِ وغيرها في ذلك، بل وردَت النصوص الصريحة في ضرورة الرجوعِ إليهم مطلقًا.
ولأنّ ما يحتاجه الإنسان في معرفةِ الله تعالى قد بُيّنَ في الرواياتِ الشريفة، فعلى الباحثِ أن يبتدئَ من الوحي المبين والأحاديث الشريفة؛ فيتعقّلَ عنها، لا أن يعكسَ الأمرَ ويتّخذَ عقلَه حاكمًا على الوحي، فيبتلى بتأويل النصوص الثابتة!
وبعبارة أخرى:
حين يشعر الإنسان العاقل بقدرته على التفكير، تبدأ في ذهنه أسئلة مصيرية. والإجابات التي يقتنع بها تجاه هذه الأسئلة تؤثر في جميع أفكاره ومواقفه وسلوكياته. من هذه الأسئلة:
ما الغاية الأساسية للإنسان في حياته؟
كيف يصل إلى السعادة الحقيقية؟
والجواب: إنّ الإنسان يسعى بطبيعته إلى إشباع حاجاته الحسية، والنفسية، والفكرية، وغيرها. وعندما يُحقق بعض ما يرجوه، يشعر بالرضا والسعادة. وبما أنّ حاجاته متعددة ومستمرة، فإنه لا ينفكّ عن السعي لإكمال ما ينقصه. لذلك، فإن الوصول إلى الكمال والسعادة، في حدود ما يقدر عليه، هو غايته الأساسية في الحياة. وهذا أمر بدهي يدركه كلّ عاقل، ولا يحتاج إلى استدلال.
الخلاف في مصاديق الكمال:
غير أنّ البشر يختلفون في تحديد ما يمثّل الكمال وما يُفضي إلى السعادة... فمنهم من يحصر السعادة في المنافع واللذّات الدنيوية؛ فينشغل بجمع المال، واتباع الشهوات، وتحقيق الرغبات.
ومنهم من يرى أنّ السعادة الحقيقية إنما تتحقّق بالإيمان والالتزام الديني؛ فيجتهد في تحصيل المعرفة من مصادرها الموثوقة، ويلتزم بأحكام الشريعة في حياته كلّها.
وهنا يبرز سؤال:
لماذا تختلف حياة المؤمن عن غيره؟ وما الأسس التي يقوم عليها هذا الاختلاف؟
الجواب: إنّ الاختلاف في السلوك يعود أساسًا إلى الاختلاف في نوعية المعلومات والأفكار. فكلما كانت المعلومات أصدق وأكثر صوابًا، انعكس ذلك على التوجه النفسي والإرادة السلوكية. ومن هنا، فإنّ تحصيل السعادة الحقيقية مشروط بالحصول على العلم الصحيح.
ولا يصح إنكار هذه الحقيقة؛ لأنّ من يُنكر وجود الثوابت والحقائق، يكون قد أقرّ بها ضمنًا، ولو دون التفات، إذ لا يمكنه الادّعاء بصحة رأيه دون التسليم بإمكانية الوصول إلى الحقيقة.
العقل ومصادر المعرفة:
كيف نصل إلى المعرفة الصحيحة؟ وما دور العقل في ذلك؟
يتفق العقلاء على أنّ العقل هو آلة المعرفة. وهو يدرك المعلومات من مصدرين:
معلومات يقينية يتفق عليها البشر عادة، كالمدركات الحسية. ومعلومات نظرية يختلف الناس حولها، كالبحوث الفلسفية والميتافيزيقية.ولا إشكال في وجوب العمل بالمعلومات اليقينية. أما في القضايا النظرية، فالخلاف واسع، والنقاش دائم، والآراء متغيّرة. فكم من فيلسوف ينقض في كِبره ما كان يؤمن به في شبابه.
فما السبيل إلى الحقيقة في هذا الميدان؟
إنّ العقل لا يصنع الحقائق، بل يميّز بينها. فهو كالمصباح الذي يُضيء الطريق، لكنه لا يخلقه. وهنا تبرز أهمية مصادر المعلومات التي يتلقاها الإنسان.
وبما أن عمر الإنسان محدود، والعلوم كثيرة، والنظريات متعارضة؛ فلا بد له من الرجوع إلى مصدر يُحتمل أن يكون أقرب إلى الواقع من سواه، وإلا بقي في الحيرة حتى الممات.
الدين كمصدر فريد للمعرفة:
وهنا يظهر الدين باعتباره المدّعي الوحيد لامتلاك معرفة تتجاوز حدود العقل البشري.
فالإنسان يواجه فئتين:
فئة تدّعي امتلاك علمٍ موحى به من الله بشأن حقائق الكون والحياة، وهم الأنبياء والأوصياء. وفئة تعتمد على الفكر البشري المجرد، وتعترف بإمكان الخطأ والنقص، وهم الفلاسفة والمفكرون البشريون.فأيّ الفريقين أولى بالالتفات؟
العقل يحكم بضرورة تقديم النظر في دعوى الفئة الأولى؛ لأنّ مجرد وجود دعوى الوحي، وادعاء امتلاك معرفة مصيرية لا يُدركها العقل وحده، يوجب الالتفات الجاد إليها، خاصة إذا كانت تتضمن احتمالات دفع ضرر عظيم أو جلب نفع كبير.
والنتائج التي تنتج عن التأمل في أدلة الأنبياء، سواء عن طريق العقل أو عن طريق التعبّد، تؤسس للأصول العقائدية، التي تحدد فهم الإنسان لمفاهيم مثل الكمال، والسعادة، والغرض من الوجود.
وهل يمكن الإيمان قبل إثبات التوحيد؟
قد يُقال: كيف نأخذ من النبي ووصيه قبل أن نثبت التوحيد نفسه بالأدلة العقلية؟
والجواب: إنّ الأنبياء يثبتون صدق دعوتهم بالمعجزة، وهي خارقة للعادة يشهد العقل بصدورها من الله، وبذلك يثبت صدق النبوة، ويُثبت معها ما جاء به النبي، ومن ذلك التوحيد.
فلا يلزم أن نبرهن على التوحيد أولًا ثم على النبوة، بل يمكن أن يُثبتا معًا في لحظة واحدة، عبر دليل النبوة.
وبعد الإيمان بالنبي، يجوز للإنسان أن يكتفي بالإيمان بما جاء عنه تعبّدًا، وله أيضًا أن يتوسّع في المعارف الإلهية، ويبحث في الأدلة التي لا تُدرك إلا من خلال إخبار النبي وأوصيائه.
⏺ سادسًا: دفعِ شبهةِ الوسائط
قد يُقال: إنّا لا نصلُ إلى رأيِ المعصومِ عليه السلام مباشرةً، بل عبر وسائطَ من الرواةِ والمحدّثين، ومع تعدّدِ الوسائطِ يزدادُ احتمالُ الخطأ.
فنقول: أوّلًا، إنّ احتمالَ الخطأ في هذا الطريقِ أقلّ بكثيرٍ من احتمالِ الخطأ في طريقِ الاستقلالِ عن الوحي. وثانيًا، إنّنا مكلّفونَ بما في وسعِنا، وقد اتّخذنا أوثقَ الطرقِ وأصحَّها، فنكونُ معذورينَ أمامَ الله تعالى، بخلافِ من أعرضَ عن المعصومين وتركَ هدايتَهم، فإنّه مسؤولٌ أمامَ ربّه وعقلِه.
النتيجة:
إنّ جعلَ مباحثِ "علم المعرفة" مقدَّمةً لازمة للبدء في البحوث العقَدية العالية يورثُ اضطرابًا في ذهنِ الباحثِ الذكيّ، ويمنعه من الاطمئنان بالنتائج. أمّا البدء من معرفةِ الإنسانِ بجهلِه وحاجتِه إلى المعصوم، ثمّ التعرّف على طرق إثبات التوحيد والنبوّة والعصمة معًا بالمعجزات، ومن بعده التعرّف على البراهين الوحيانية وتصديقها عقلاً، هو الذي يرسّخُ الإيمانَ، ويمنح النفسَ يقينًا لا يتزلزل، كما يمنع من تأطير ذهن الباحث وبرمجته بنظريات فلسفية يصعب معها الإذعان بصريح كثير من دلالات النصوص المحكمة.
فأوّلُ الواجباتِ على الإنسان هو "معرفةُ الحُجّة"، ثمّ التسليمُ له، والرجوع إليه في مواردِ الاختلاف، كما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام:
إِنَّمَا كُلِّفَ النَّاسُ ثَلاَثَةً: مَعْرِفَةَ الْأَئِمَّةِ، وَالتَّسْلِيمَ لَهُمْ فِيمَا يَرِدُ عَلَيْهِمْ، وَالرَّدَّ إِلَيْهِمْ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. {بحار الأنوار٢: ٢٠٢}.







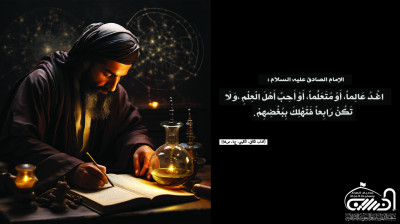
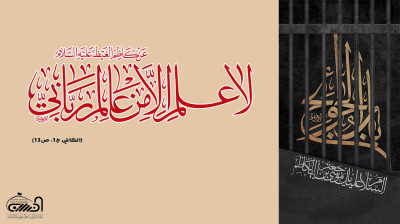



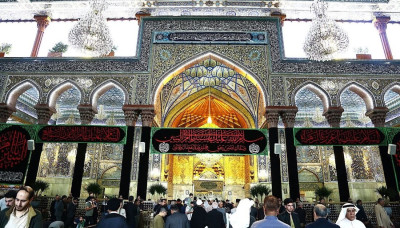
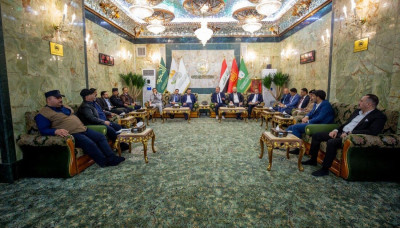




اترك تعليق