في واحدة من أحلك مراحل التاريخ الإسلامي، بزغ نورٌ حاول الظالمون إخفائه؛ لكنه عميق التأثير، إنه الإمام علي بن الحسين زين العابدين (عليه السلام)، الذي ورث النبوة لا بدمها فقط، بل بحكمتها وصبرها ووعيها.
بعد فاجعة كربلاء، تلك الملحمة التي أراد بنو أمية من طريقها طمس معالم الدين الحقيقي وتثبيت شرعيَّةٍ زائفةٍ بقوَّة السيف، ظهر الإمام زين العابدين (عليه السلام) بوصفه وريثاً للرسالة وحاملاً لأمانتها، على رغم من كونه الناجي الوحيد من مجزرة الطف من جيل الإمامة المباشرة، لكن الإمام (عليه السلام) لم يحمل سيفًا، ولم يعلن ثورة؛ بل أمسك بزمام الأمَّة بالكلمة والدعاء والعلم، مؤمنًا أنَّ إصلاح المجتمع لا يكون دائمًا عبر السلاح؛ بل عبر بناء الوعي من الجذور، بما يتناغم مع المنهج القرآني الذي يتمثل بـ:
أولاً: القيادة بالعلم والكلمة لا بالسلاح
بعد واقعة كربلاء، كان الوضع متأزماً، فالحكم الأموي استفرد بالسُّلطة، وغلَّف جرائمه بلباس الدين، والمعارضة له شبه منعدمة، وكان الناس إمّا مرعوبون، أو مخدوعون، أو خاضعون، هنا أدرك الإمام زين العابدين (عليه السلام) أن أي مواجهة عسكريَّةٍ لن تُثمر إلا مزيدًا من الدماء والإنكسار، فاختار(عليه السلام) مسارًا آخر، هو أن يقود الأمة من داخلها، بروحٍ قرآنيَّة، وكلمةٍ هادئة، منتهجاً لقوله تعالى: ﴿ادْعُ إِلِىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ النحل: 125 .
وهذا ما فعله الإمام (عليه السلام) تمامًا، فقد تحوّل إلى مربٍّ ومرشد، يعلّم الناس معاني الدين الحقيقية، بعيدًا عن التزييف السياسي، ويُعيد ربطهم بالله والقرآن وأخلاق النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله)؛وأوضح الشيخ ناصر مكارم الشيرازي بوصفه للقائد: (إن قائد العالم يعرف طريق سعادة المجتمع ويرسم الخطط للوصول إليه بعلمه وحنكته، وكذلك يرسم الأسلوب الصحيح في مواجهة الأعداء...)([1])
1. القيادة الروحية والتعليمية:
لم يكن مجلس الإمام مجلسًا تخيم عليه السياسة، بل كانت السيادة للجانب الروحي والعبادي والتعليمي ايضاً، لكنه كان يحمل رسالة سياسية خفية من طريق أدعيته ومواعظه، فقد اجتمع حوله المستضعفون، والمحبون، وأهل الفطرة الذين شعروا أن في كلماته صدقًا لا يشبه ما يُقال على منابر السلطة، وقد ركّز الإمام (عليه السلام) على تربية النفوس، وتنقية القلوب، وإعداد جيلٍ جديد يعرف الحق من الباطل، لا بالتلقين، بل بالإقناع والتوجيه، انسجامًا مع قوله تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ البقرة: 143، أراد أمةً وسطًا بين التهور والجمود، تعرف متى تصبر ومتى تثور، ومتى تصمت ومتى تتكلم.
2. ترسيخ الهوية الإسلامية الأصيلة:
في زمنٍ كان يُقدَّم فيه الحاكم بوصفه (ظل الله في الأرض)، جاء الإمام ليعيد تعريف الخلافة كما أرادها الله: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ البقرة: 30
فالخلافة أمانة، لا سلطة، والإمام مارسها بهذه الروح: أمانة التعليم، أمانة الدفاع عن الدين، أمانة الوقوف مع المظلومين.
3. حماية الخط الرسالي:
لو اختار الإمام المواجهة المباشرة، لانتهى وجود أهل البيت عليهم السلام بوصفهم مدرسة ومرجعية، لكن بصبره وهدوئه الظاهري، وحركته العميقة، ضَمِنَ:
أ- استمرار الإمامة.
ب- تخريج تلاميذ حفظوا العلم والهوية.
ت- تمرير المفاهيم الحسينية عبر الدعاء والخطاب.
لقد حمى الرسالة بالصمت الحكيم والكلمة المدروسة، لا بالانفعال أو المواجهة اليائسة.
4. الكلمة سلاح:
قال تعالى: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ﴾ الزمر: 23
فكان الإمام(عليه السلام) من أهل هذا (الحديث الأحسن)، لا بالبلاغة فقط، بل بالصدق والهدف، إذ حوّل الكلمة إلى سلاح يوقظ، لا يقتل، ويُربّي، لا يُرهِب.
ثانياً: خطبته في مجلس يزيد… الكلمة في وجه الطاغوت
حين اقتيد الإمام (عليه السلام) أسيرًا إلى الشام، ظنَّ الطغاة أنَّ الإمام سيلتزم الصمت، لكنّه وقف، وهو مُنهكٌ من الأسر، ليرفع راية الحقِّ من قلب الظلم بالكلمة الصادقة والحقيقة الصادمة، قال مخاطبًا أهل الشام: (أيها الناس، أعطينا ستًا وفُضّلنا بسبع...)([2]) وفي كل كلمةٍ من كلماته، كانت هناك شحنة قرآنية، وحقيقة دامغة، وموقف يُذكّرهم بمن هم(عليهم السلام)، ومن هو يزيد.
قال الله تعالى: ﴿وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا﴾ الفرقان: 52 ، فكانت خطبته جهادًا بالكلمة، كشف زيف السلطة، وأعاد الميزان للناس.
ثالثاً: الصحيفة السجادية… (دعاء فيه ثورة)
ترك الإمام للأمة إرثًا روحيًا عظيمًا، هو الصحيفة السجادية، التي ليست أدعية فقط ؛ بل برنامج إصلاحي شامل، فيه قيم، وسياسة، ونقد اجتماعي، وتربية قلبية.
ومن دعائه (عليه السلام): (اللهم إني أبرأ إليك من كل سلطان جائرٍ، وكل شيطان مريد...)([3]) دعاء، لكنه يحمل موقفًا سياسيًا واضحًا : يتجلى فيه الرفض للظلم والطغيان.
رابعاً: الصبر الهادف لا الخضوع
قال تعالى: ﴿وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ النحل: 127
جسّد الإمام (عليه السلام) هذا المعنى، فكان صبره وعيًا، لا استسلامًا، وكان يرى أن رسالة الامام الحسين (عليه السلام) يجب أن تستمر، لكن بطريقة تحفظ فيها النفس بالتقدير للحالة التي يعاصرها الامام والحسابات الدقيقة من طريق ممارسات السلطان الحاكم الذي يبطش بمن يعارضه.
خامساً: بناء وعي مقاوم عبر الأجيال
لم يكن هدف الإمام زين العابدين (عليه السلام) مقتصرًا على إصلاح لجيلٍ واحد، بل كان يسعى إلى ترسيخ نهجٍ رسالي عميق، يضمن استمرارية الدين في صورته المحمدية الأصيلة، فعمل على إعداد نخبةٍ من الفقهاء والمحدّثين وأهل البصيرة، ممن حملوا أمانة العلم، وصانوا تراث النبوة، ونقلوه للأجيال بصفائه وعمقه، وهذا ما يدعو إليه القرآن الكريم: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ﴾ التوبة: 122، فالتفقه لا يعني فقط معرفة الأحكام، بل الوعي بالدين بوصفه منهجاً حياتياً.
كان الإمام زين العابدين (عليه السلام) قائدًا بصمته، وثائرًا بكلمته، ومصلحًا بأدعيته، ورمزًا لصبرٍ فيه نَفَس الحسين(عليه السلام) وروح النبوة، وبفضله لم تمت كربلاء، بل تحوّلت إلى شعلة أبدية، تعلّم الأجيال أن الكلمة إذا خرجت من قلبٍ مؤمن، قد تكون أقوى من كل سيوف الطغاة.
([1]) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل - الشيخ ناصر مكارم الشيرازي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٢.
([2]) بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٤٥ - الصفحة ١٣٨.
([3]) بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٢ - الصفحة ٣٩٢.



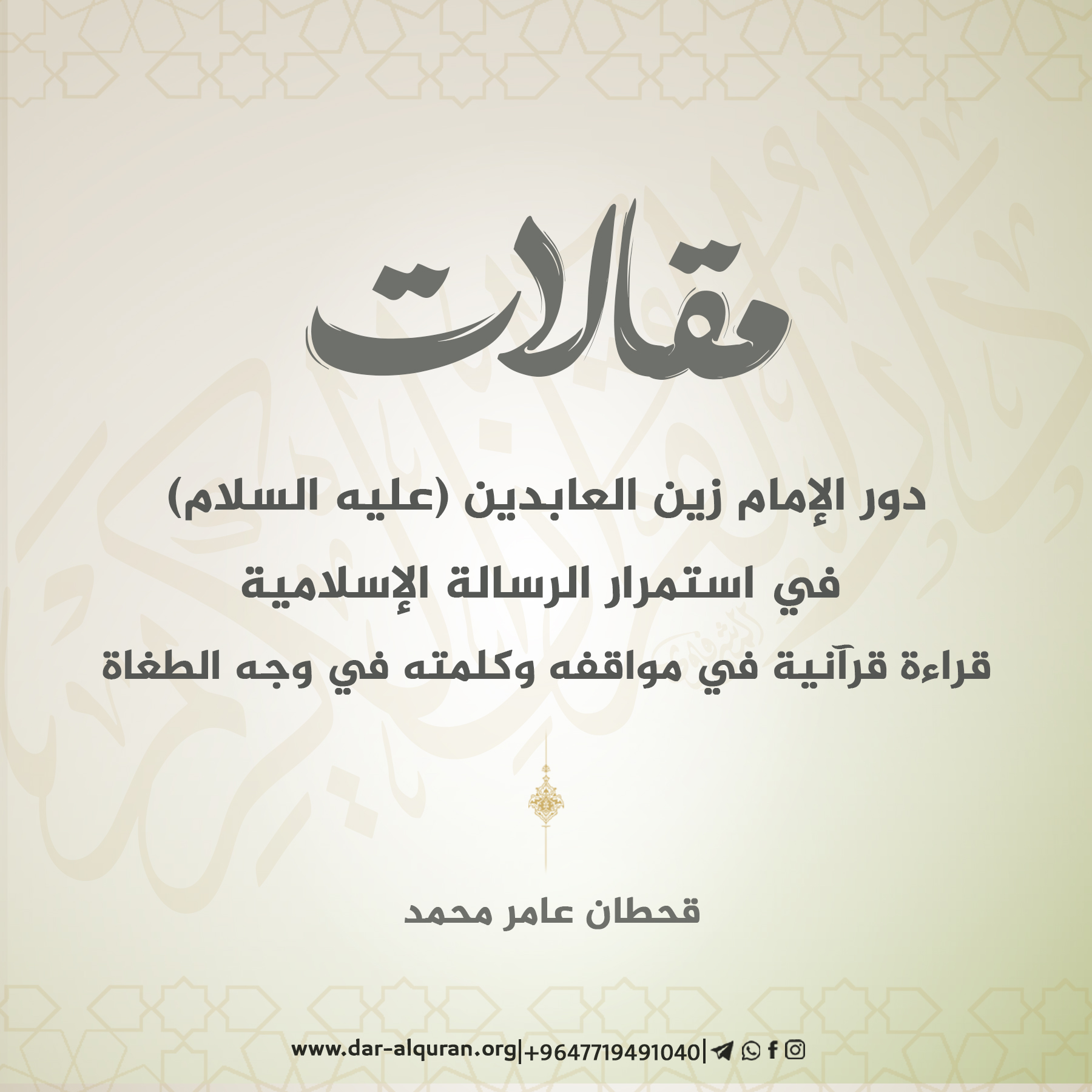













اترك تعليق