إن القرآن الكريم كتاب أنزله الله تبارك وتعالى ليقود الحياة وهو أهل لذلك، لأنه وبشكل طبيعي فيه كل الموضوعات الاساسية التي تهم الإنسان ويحتاجها للبناء والتقدم على المستوى النفسي والاجتماعي في الحياة، لذا يجب تسميته بأنه: (كتاب حياة)، وهو على هذه السمة يلزم النظر فيه ومطالعته في كل يوم، كما حثنا على ذلك الأئمة الطاهرون(عليهم السلام)، فقد ورد عن الإمام علي ابن أبي طالب أمير المؤمنين(عليه السلام) لما خاطب أهل البصرة: ((... وعليكم بكتاب الله فإنه الحبل المتين والنور المبين والشفاء النافع والري الناقع والعصمة للمتمسك والنجاة للمتعلق، لا يعوج فيقام ولا يزيغ فيستعتب ولا تخلقه كثرة الرد وولوج السمع، من قال به صدق ومن عمل به سبق))(1)، ولكن الناس رغم ذلك ورغم تمتعهم بالعقل وتبجحهم به، إلا أنهم زاغوا عن الصواب وضاعوا في هذه الدنيا وكثرت مشكلاتهم واستحكمت إشكالاتهم وزادت شبهاتهم وقل وضوح الموضوعات والأحكام لديهم وعسرت حياتهم، وهو ما لا يحتاج إلى دليل، بل هو مؤيد بالواقع المعاش.
قام إلى علي أمير المؤمنين(عليه السلام) رجل ذات يوم وقال: ((أخبرنا عن الفتنة وهل سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عنها؟ فقال عليه السلام: لما أنزل الله سبحانه قوله: {الم * أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ}(2) علمت أن الفتنة لا تنزل بنا ورسول الله صلى الله عليه وآله بين أظهرنا، فقلت يا رسول الله ما هذه الفتنة التي أخبرك الله تعالى بها، فقال: يا علي إن أمتي سيفتنون من بعدي، فقلت يا رسول الله: أوليس قد قلت لي يوم أحد حيث استشهد من استشهد من المسلمين وحِيزت عني الشهادة فشق ذلك علي فقلت لي: أبشر فإن الشهادة من ورائك، فقال لي: إن ذلك لكذلك فكيف صبرك إذا؟ فقلت: يا رسول الله ليس هذا من مواطن الصبر، ولكن من مواطن البشرى والشكر، فقال: يا علي إن القوم سيفتنون بأموالهم، ويمنون بدينهم على ربهم، ويتمنون رحمته، ويأمنون سطوته، ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة والأهواء الساهية، فيستحلون الخمر بالنبيذ، والسحت بالهدية، والربا بالبيع، قلت يا رسول الله: بأي المنازل أنزلهم عند ذلك؟ بمنزلة ردة أم بمنزلة فتنة؟ فقال: بمنزلة فتنة))(3).
واليوم وللأسف الشديد نشهد هذه الأمور جميعها مضافاً إليها التهكم والازدراء وطرقاً أخرى تشويهية اتخذت شكل حرب اعلامية، لخلق رأي عام بضرورة التخلي عن الشريعة الإسلامية لعدم عقلائيتها وعدم منطقيتها، وأن أحكامها مخالفة للفطرة السليمة، وإيصال الأمر إلى هذا النكتة يتطلب إبعاد النفس الإنسانية عن التعلق بالإسلام ودفع الفكر البشري عن الاعتقاد به.
وهذا الغرض لدى المخالفين للإسلام قام على خطة علمية تؤهل لخلق رأي عام مضاد، وهو ما يتم تنفيذه اليوم من استراتيجية للتغيير، فهي قائمة على قدم وساق بواسطة الإعلام، واستراتيجيتهم هي:
أولاً: استشعار مضرة الاعتقاد القديم ومنفعة الاعتقاد الجديد.
ثانياً: خلق الشكوك والشبهات حول العقيدة الحقة والمناقشة فيها لزعزعة الاعتقاد الجازم وغيره.
ثالثاً: اختار الاعتقاد البديل.
رابعاً: ابدأ العمل بالاعتقاد الجديد وكرره ليخلق القناعة الجديدة(4).
وهنا نسأل هل هناك علاقة بين الفتنة والتغيير؟ وجوابه يتضح مما تقدم، حيث يظهر جلياً: أن التغيير الذي يحصل للإنسان المسلم في حياته وسلوكياته والذي عبرت عنه النصوص الشرعية بـ(الفتنة) له علاقة بالتغيير، إذ أن السلوكيات البشرية نابعة من صميم الاعتقادات التي يتحلى بها الإنسان والمسلم يعتقد بكلام وأفكار واعتقادات القرآن الكريم وكلام أهل البيت(عليهم السلام)، والتغيير الممارس على قدم وساق نظرياً وتطبيقياً عبر الوسائل والممارسات المتعددة المختلفة والفعالة، يبعد الإنسان عن تطبيق كلام الله تبارك وتعالى وأهل بيته، وبالتالي ينتج تغيير أفعاله وسلوكياته ومجريات الحياة وتحويلها من حياة طيبة مستقرة منسجمة ومنافع ومصالح الإنسان إلى حياة متزلزة غير مستقرة تارة تلبي احتياجاته وأغراضه وأخرى لا تلبي، وهذه العلاقة تعتمد كمياً على نظرية الإزاحة دفعاً لحدوث الفراغ غير المتصور الحدوث في أفعال الإنسان.
وعلى هذا فإن العلاقة تكون علاقة طردية مطردة.
الهوامش:-----
(1) نهج البلاغة، خطب الإمام علي عليه السلام، ج ٢، ٤٩
(2) سورة العنكبوت: 1-2
(3) نهج البلاغة، خطب الإمام علي عليه السلام، ج ٢، ٤٩- 50
(4) انظر: دار البلاغ للإنتاج والتوزيع، استراتيجية التغيير الفعال، الدكتور صلاح الراشد، صوتي










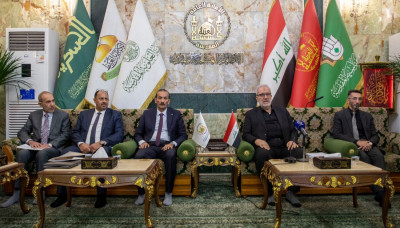









اترك تعليق