تمهيد
ابتُلِيَت الأُمّة الإسلامية بآفة الإرهاب، الذي عُدَّ في فكر البعض من ذاتيات الدين الإسلامي. بيد أنّ الأُمّة الإسلامية هي المتضرّر من هذا النهج الغريب الذي وُلِدَ بين ظهرانيه نتيجةً لعوامل عديدة، منها: غياب الوعي الحقيقي بالرسالة المحمّدية، وعدم الانقطاع التام عن الجاهلية وعادات ما قبل الإسلام، وخاصّة بعد أن جاء الإسلام بديلاً متكاملاً لإدارة الحياة في مختلف الجوانب. ومنها: العلاقات الخارجية ببعض الجهات التي أرادت للإسلام أن ينتهي في جزيرة العرب كما بدأ منها. ومنها ـ وهي أهمّها ـ : عزل أهل البيت عليهم السلام باعتبارهم يُمثِّلون الامتداد الطبيعي للرسول صلى الله عليه وآله الذين يحملون روح الإسلام وجوهره. وما نراه من المحاولات الفاشلة لإلصاق تهمة الإرهاب بالدين الإسلامي وبمنظومته الفكرية، من خلال تفسير بعض النصوص التي تأوَّلت على غير مراد السماء، هو بعيد جداً عن واقع الإسلام؛ لأنّ من النصوص الإسلامية الصريحة ما يرفع هذه الشبهة عن الدين الإسلامي.
لا شكَّ أنَّ الإرهاب الفكري من أخطر أنواع الإرهاب؛ لأنّه يستهدف العقل الذي يُعدّ قيمة الإنسان العليا التي تميّزه عن سائر المخلوقات، ويستهدف على إثر ذلك الإبداع الفكري في مختلف جوانب الحياة، فيعمد إلى الحرّيات الفكرية فيقمعها، ويقيّد أُفق الإبداع، كما أنّ الإرهاب هو أُسلوب وسلوك خاص طبيعته إثارة الرّعب والخوف للوصول إلى هدف معيَّن، فالإرهاب الفكري هو ما كان يستهدف بهذا الأُسلوب الفكر والعقيدة. إنَّ الإرهاب الفكري تارة يتبنّى فكرة معيّنة يدافع عنها بهذا الأُسلوب، وتارة يكون هو عدو الفكرة والرأي والعقيدة، ولعلّ هذا الشكل أو النوع أشدّ خطراً من الأوّل؛ لأنّ إمكانية الحوار هنا منتفية من الأساس، إذ لا موضوع له.
ولا تختلف أساليب الإرهاب الفكري عن غيره في سبيل تحقيق أهدافه، وهذه الأساليب قد تتطوّر لتصل إلى حدّ التصفية الجسدية، أو الحبس، أو غير ذلك، التي من شأنها تغييب الخصوم عن ساحة النزاع إن لم يكن باستطاعته أن يُكمِّم الأفواه.
وأوضح المصاديق وأتمّها للإرهاب الفكري ـ بكل خصائصه وصوره ـ هو سياسة وأُسلوب المعسكر الاُموي في واقعة الطف، الذي استنفذ كل طاقاته العدوانية وأساليبه الإجرامية في سبيل تحقيق غرضه؛ المتمثّل بالقضاء على صوت الحق الرافض للاضطهاد والظلم، وتحريف الدين وتغييب مبادئه وقيمه الإنسانية، التي صدع بها الإمام الحسين عليه السلام مُعلناً رفضه لهذا الغرض البعيد عن الإسلام وتعاليمه، فواجه المعسكر الأُموي هذا الإصحار بأبشع صور العنف والقتل والسلوك الهمجي، وهي أجلى صورة للإرهاب الفكري جرت في تاريخ الإنسانية.
وفيما يلي من المباحث بيان للأساليب والآليات التي اعتمد عليها المعسكر الأُموي في ترسيخ منهجيّته، مع شيء من التحليل الذي يُعدّ بياناً لخصائص الإرهاب الفكري للمعسكر الأُموي.
الآلية الأُولى: سياسة الركون إلى الظالمين ــ دعم وتأسيس المعسكر الأُموي
إنّ من العوامل الأساسية التي اعتمدها الإرهاب الفكري الأُموي اعتماداً مطلقاً هي سياسة الركون إلى الذين ظلموا ـ هذا التعبير اقتبسناه من القرآن الكريم في قوله تعالى ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّـهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴾[1] ـ التي نهى الله تعالى المؤمنين عنها؛ كونها لا تليق إطلاقاً بمبادئ المؤمنين مهما كانت الأهداف التي يسعون إلى تحقيقها؛ لأنّ الأُسلوب والطريقة فرع الهدف والغاية، وقد قيل: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إلّا أنّ هذا الأُسلوب يُعتَبر من الأساليب التي اعتمد عليها المعسكر الأُموي استعداداً لمواجهة الإمام الحسين عليه السلام . وهنا نماذج نذكرها لهذا الأُسلوب، هي:
أولاً: يزيد بن معاوية بين ظلم السلف وتضليل الخَلَف
إنّ من أوضح مظاهر الظلم هو ظلم الإنسان لنفسه، ثمّ ظلمه للآخرين، وأشدّ ما يكون الظلم كذلك هو تضليل الناس وإبعادهم عن الحق والصراط السوي، وهذا ما كان عليه بنو أُميّة قاطبة، ابتداءً من أسلافهم في عصر الجاهلية وعداواتهم لهاشم وعبد المطّلب، وما تمخَّض عنه من عداوة معلنة من قِبَل أبي سفيان وعتبة بن ربيعة للنبي صلى الله عليه وآله . أمّا عتبة فقد قضى في معركة بدر، والدور الأهم كان لأبي سفيان الذي ما برح يُضعِف كاهل الإسلام بمؤامراته وضغائنه حتى أعلن ذلك صراحة عندما بويع عثمان بن عفان خليفة ثالثاً للمسلمين بعد عمر بن الخطّاب، إذ ورد: «عقيب الوقت الذي بويع فيه عثمان ودخل داره ومعه بنو أُميّة، فقال أبو سفيان: أفيكم أحدٌ من غيركم؟ وقد كان عدي. قالوا: لا. قال: يا بني أُميّة، تَلَقّفُوهَا تلقُفَ الكرة، فوالذي يحلف به أبو سفيان، ما زلتُ أرجوها لكم، ولتصيرَنَّ إلى صبيانكم وراثة»[2].
هذا الظلم من أبي سفيان لنفسه وللإسلام وأهله، اتخذه يزيد بن معاوية سيرة له، فترك الإسلام عقيدة ومنهجاً، وركن إلى أسلافه الظالمين بحقّ أنفسهم وبحقّ الإسلام وأهله. فأسّس يزيد وقبله معاوية ـ بناءً على هذا النهج ـ فكرة الحكم الملكي، وبدأ بنو أُميّة بالفتك بكل ما من شأنه أن يُهدّد عروش سلطانهم، حتى أعلنها صراحة ودون لبس عندما أُدخِل عليه رأس الحسين عليه السلام :[3]
خبـر جاء ولا وحي نـزل «لعبت هاشـم بالمُلك فلا
من بني أحمد ما كان فعل». لستُ من خندف إن لم أنتقم
فيزيد بن معاوية قد باع نفسه لهواه، كما فعل أسلافه، وركن إليهم كما ركنوا إلى سيرة أسلافهم من التعصّب والاستعلاء والبغض لأهل الخير. كما وركن أتباع بني أُميّة إلى يزيد الذي هو الآخر حمل أتباعه على اتّباع الهوى وترك الحق وأهله، فلا نكاد نجد فارقاً في الاعتقاد بين يزيد وأتباعه، وخاصّة المقرَّبين منه أصحاب القرار كعبيد الله بن زياد وأضرابه.
فالحرب التي أعلنها المعسكر الأُموي هي حرب ضدّ العقيدة والدين وليست حرباً عقائدية كما أشار إلى ذلك الشهيد مطهري: «ومن هنا؛ يتّضح أنّ حرب أصحاب ابن زياد مع الحسين بن علي عليه السلام لم تكن حرباً عقائدية، بل حرباً ضدّ العقيدة»[4].
فالإرهاب الفكري ـ وإن تصنّع في أُسلوبه وإعلامه ليوحي بأنّ معركته فكرية أو عقدية ـ إنّما يخوض حرباً ضدّ الفكر والعقيدة والدين.
ثانياً: سرجون الرومي ومخطّطات أعداء الإسلام
وقد ذكره المؤرّخون بهذا الوصف (الرومي)، ومنهم الطبري وابن الأثير. قال الطبري: «لمّا بويع لمعاوية بالخلافة صيَّر على شرطته قيس بن حمزة الهمداني، ثمّ عزله واستعمل زميل بن عمرو العذري، ويُقال: السكسكي، وكان كاتبه وصاحب أمره سرجون بن منصور الرومي»[5]. وذكر سرجون بهذا الوصف أو اللقب في كتب المؤرِّخين يمكن أن يحتمل أمرين:
1 ـ إنّ معاوية كان قد استعمله بناءً على اتّفاق بينه وبين الدولة البيزنطية أو الرومية آنذاك؛ لأخذ المشورة في إدارته للحكم، فهو باقٍ على روميّته وانتمائه المناطقي؛ إذ لا معنى أن يبقى على هذا الوصف بعد أن أصبحت الشام تحت الحكم الإسلامي في زمن الخليفة الثاني.
2 ـ إنّ المؤرِّخين أبقوه على هذا الوصف دلالة على بقائه على مسيحيّته؛ لأنّ الروم عامّتهم على دين المسيحية؛ فيُطلَق على المسيحي أنّه رومي. وهذا الاحتمال قريب، يقول السيّد محمد الصدر: «على أُطروحة أُخرى ـ أن يكون سرجون كاذباً، وإنّما يريد أن يخدع يزيد لأجل تنفيذ أغراضه التي يدركها إجمالاً، بما فيها ما حصل في واقعة الطف. فكان سرجون ـ الذي هو مسيحي وليس مسلماً ـ مسؤولاً عنها»[6].
أمّا المشورة التي تقدَّم بها سرجون إلى يزيد، فهي بدورها تُبيِّن لنا ما هي الأهداف الحقيقية لسرجون؛ فهو قد أشار على يزيد أن يضمّ العراقَين (البصرة والكوفة) إلى عبيد الله بن زياد. «فلمّا اجتمعت الكتب عند يزيد دعا سرجون مولى معاوية، فأقرأه الكتب واستشاره فيمن يولّيه الكوفة، وكان يزيد عاتباً على عبيد الله بن زياد، فقال له سرجون: أرأيت لو نُشِرَ لك معاوية كنت تأخذ برأيه؟ قال: نعم. قال: فأخرج عهد عبيد الله على الكوفة. فقال: هذا رأي معاوية، ومات وقد أمر بهذا الكتاب. فأخذ برأيه وجمع الكوفة والبصرة لعبيد الله، وكتب إليه بعهده وسيّره إليه مع مسلم بن عمرو الباهلي والد قتيبة، فأمره بطلب مسلم بن عقيل وبقتله أو نفيه»[7]. وهذا يعني أنّ المهمّة والغرض الذي يريد تحقيقه سرجون أو يزيد لا يمكن أن يقوم به إلّا مثل عبيد الله بن زياد، وهذا ما تحقّق فعلاً من قتل الحسين عليه السلام ، وأحداث تلك الفاجعة بما تضمّنت من وقائع مؤلمة، ولا يمكن لأحد أن يُباشر هذا الفعل بنفسه سوى ابن زياد أو أشباهه، فضلاً عن سياسته بعد قتل الحسين عليه السلام ؛ إذ أمر بأن يوطأ صدر الحسين عليه السلام بحوافر الخيل، وسوقه النّساء والأطفال من أهل البيت عليهم السلام أُسارى إلى الكوفة، وعزمه على قتل الإمام زين العابدين عليه السلام في قصره لولا أنّ العقيلة زينب ألقت بنفسها على ابن أخيها وطلبت أن تُقتل معه[8].
فركون يزيد إلى سرجون في المشورة ـ مع أنّه بعيد عن الإسلام ولا يرى مصلحته ومصلحة دولته في بقاء الإسلام ـ دليل على أنّ الإرهاب الفكري لا يرى أيّ تقييد في الأساليب والسلوكيات من أجل تحقيق غاياته. وبعبارة أُخرى: فهو لا عقيدة له ولا مبادئ ولا أخلاقيات يمكن أن تزاحمه في سلوك أيّ طريق وانتهاج أيّ أُسلوب لتحقيق أغراضه، وإلى هذا المعنى يُشير السيّد الصدر: «وهنا نرى أنّ الخلافة الظالمة كانت تعتمد على بعض اليهود أو النصارى. وليس في التاريخ أنّهم دخلوا الإسلام، بل كانوا يعتمدون عليهم حال كونهم يهوداً أو نصارى، وهم يعلمون أنّهم يريدون السوء بالإسلام. بل كانت الخلافة عميلة إلى ملك الدولة البيزنطية بمقدار فهم الدول يومئذ»[9].
فهذه الصفة والخاصّية ممّا يتَّصف به الإرهاب الفكري بشكل عام، والمعسكر الأُموي كأحد أشكاله بشكل خاص، وهي أنّه يركن إلى أعداء الإسلام في سبيل أن يحقّق غرضه، فهو حقيقة لا يمت إلى الإسلام بصلة؛ لأنّه يخالف أوضح الواضحات في تعاليم الدين الإسلامي فضلاً عن القول: بأنّه أداة بيد أعداء الإسلام في سبيل تمرير مخططاتهم الخبيثة ضد الإسلام من خلال مَن ينسبون أنفسهم للإسلام.
الآلية الثانية: سياسة التجهيل وتغييب الوعي - أهل الشام أُنموذجاً
لعلّنا نواجه اعتراضاً هنا وهو: أنّ توصيف أهل الشام بأنّهم من الظالمين الذين ركن إليهم الحاكم الأُموي، فيه نوع من القساوة التي في غير محلّها.
فنقول: إنّ المقصود من أهل الشام الذين عاصروا وناصروا الحكم الأُموي، وليس كل أهل الشام على مرّ العصور، فهذا ممّا لا يمكن تصوّره، هذا من جهة.
ومن جهة أُخرى، فإنّ أهل الشام لا تعني الاستيعاب، بل هيَ على نحو التغليب، فتشمل الذين تولّوا بني أُميّة خاصّة، واستعملوهم في تمرير مخطّطاتهم وترسيخ منهجهم الدّموي، وهم كثُر على كل حال.
أمّا صفات أهل الشام التي كانوا يتّصفون بها من ناحية الوعي والثقافة الدينية، فهي من العوامل التي ساعدت بني أُميّة على دعم منهجهم الإرهابي، وهم أيضاً رسموا لأسلافهم صورة واضحة في الاعتماد على الجهل وغياب الوعي عند أتباعهم، فجهل أهل الشام بالشريعة الإسلامية أُصولاً وفروعاً وكلّ ما هو متعلّق بها ـ ابتداءً من رأس الهرم وهو الخليفة بما يلزم له من مزايا تؤهّله للقيام بهذه المهمّة العظيمة، إلى أبسط المفاهيم الدينية ـ كانت من العوامل الأساسية التي اعتمد عليها يزيد في بناء معسكره وإعداده.
وهذه الخصلة لأهل الشام آنذاك لها جذور وأسباب نذكر منها:
1ـ إنّ الشام كانت من المستعمرات الروميّة، ثمّ فُتِحَت في عهد عمر بن الخطاب، لكنّ هذا الفتح لم يمنع المسيحيين من ممارسة طقوسهم الدينيّة والبقاء على ديانتهم بحسب الصلح الذي تصالحوا عليه مع الخليفة الثاني الذي استعمل عليها يزيد بن أبي سفيان، ثمّ بعد موته استعمل معاوية بن أبي سفيان، الذي كان حريصاً على عزل الشام عن الإسلام الحقيقي ومفاهيمه السامية، يقول السيّد الحكيم: «وحتّى الشام، فإنّها وإن حُجِر عليها ثقافياً ولم تعرف عموماً غير ثقافة الأُمويين»[10].
وقد وصف المسعودي لنا حجم هذه الجاهلية بالإسلام وقادته بقوله: «فقال لي ذات يوم بعضُهم ـ وكان من أعقلهم وأكبرهم لحية ـ : كم تُطْنبون في عليٍّ ومعاوية وفلان وفلان؟! فقلت له: فما تقول أنت في ذلك؟ قال: مَن تريد؟ قلت: عليّ، ما تقول فيه؟ قال: أليس هو أبو فاطمة؟ قلت: ومَنْ كانت فاطمة؟ قال: امرأة النبي عليه السلام بنت عائشة أُخت معاوية. قلت: فما كانت قصة علي؟ قال: قُتل في غَزَاة حنين مع النبي صلّى الله عليه وسلّم»[11].
2 ـ سياسة الخليفة الثاني في الحجر على الصحابة، فكانت سبباً مهمّاً في جهل الأُمّة بتعاليم الدين الحنيف، «عن الشعبي، قال: لم يمُتْ عمر ـ رضي الله عنه ـ حتّى ملّته قريش، وقد كان حصرهم بالمدينة، فامتنع عليهم وقال: إنّ أخوف ما أخاف على هذه الأُمّة انتشاركم في البلاد»[12]. قال السيّد الحكيم ذلك: «ومن أجل إبقائهم على غفلتهم رأى أنّ الّلازم الحجر على كبار الصحابة وذوي الشأن منهم، وحبسهم في المدينة المنوّرة، وجعلهم تحت سيطرته ... من أجل الالتزام بتعاليمه والسير على خطّه، ولا أقلّ من عدم الخروج عنه وزرع بذور الخلاف والانشقاق»[13]. وقد استثمر معاوية هذه السياسة لصالحه في إبقاء النّاس على غفلتهم وجاهليّتهم، وأصبحت من عناصر تقوية سلطانه، فعزَلَ أهل الشام عزلاً ثقافياً محكماً، وقد بلغ هذا العزل بأهل الشام حداً انطلت عليهم أكذوبة أن لا قرابة للنبي صلى الله عليه وآله غير بني أُميّة، كما قال المسعودي: «ونزل عبد الله بن علي الشام، ووجّه إلى أبي العباس السفّاح أشياخاً من أهل الشام من أرباب النعم والرياسة من سائر أجناد الشام، فحلفوا لأبي العباس السفّاح أنّهم ما علموا لرسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم قرابة ولا أهل بيت يرثونه غير بني أُميّة حتّى ولّيتم الخلافة»[14].
وكان معاوية قد مهَّد ليزيد في بناء معسكره الداخلي بالاعتماد على مشورة مَن يعتقد بولائهم المطلق لبني أُمية، ومعرفتهم بمؤهّلات أهل الشام، وقبولهم لسياسة بني أُميّة مهما كانت طبيعتها.
اعتراض وجواب
قد يواجه الطرح المذكور في النقطة المتقدّمة نقضاً واضحاً؛ يراد منه تبرئة أهل الشام من جميع ما حصل في واقعة الطّف، ويعتقد أصحاب هذا الاعتراض أنّ جيش بني أُميّة في واقعة الطّف كان من أهل الكوفة، وروايات خذلان أهل الكوفة للحسين عليه السلام أكثر من أن تحصى، فكيف لنا أن نُهمل هذا الدور لأهل الكوفة؟ فضلاً عن القول: بأنّ جيش المعسكر الأُموي كان من أهل الكوفة.
فنقول: إنّنا يمكن أن نذكر عدّة أدلّة يمكن أن نستدلّ بها على وجود جيش الشام في كربلاء وبعدّة وجوه، فإمّا أن تكون هذه الأدلّة بمجموعها معارضة لما هو شائع تاريخياً، فيبقى احتمال الأمرين في الانتماء المناطقي لجيش المعسكر الأُموي هو القائم ولا مرجِّح لأحدهما على الآخر. وإما أن نجمعَ بينهما بأن نقول: إنّ المؤرِّخين ركَّزوا في رواياتهم على الجيش الذي حضر من الكوفة مع عمر بن سعد، وتركوا الحديث عن جيش أهل الشام، سوى كتيبة الحصين بن نمير التي ذكروها ضمن جيش أهل الكوفة، والحال أنّ الحصين بن نمير من كندة أهل الشام أو سيّدهم على ما يظهر من دوره في تنصيب مروان بن الحكم خَلَفاً ليزيد، «ولمّا بايع حصين بن نمير مروان بن الحكم، وعصا مالك بن هبيرة فيما أشار به عليه من بيعة خالد بن يزيد بن معاوية، واستقرّ لمروان بن الحكم المُلك، وقد كان الحصين بن نمير اشترط على مروان أن ينزل البلقاء مَن كان بالشام من كندة، وأن يجعلها لهم مأكلةً، فأعطاه ذلك»[15].
ومن هذه الأدلة:
1 ـ ما ورد عن الإمام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء من وصفه لمعسكر بني أُميّة بأنّهم شيعة آل أبي سفيان إذ قال عليه السلام مخاطباً إياهم: «ويحكم يا شيعة آل أبي سفيان...»[16]. فهذه الرواية وإن كانت تحتمل وجوهاً عدّة بأن يكون هذا الوصف لأهل الكوفة أيضاً؛ لأنّهم شايعوا بني أُميّة، أو أنّه خاص بأتباع بني أُميّة الذين يسكنون الكوفة، إلّا أنّ ما ذكرناه أحد هذه الاحتمالات أيضاً، مضافاً إلى ما سيأتي من الأدلّة.
2 ـ ما ذكره المجلسي رحمه الله في البحار: «عن عبد الملك، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صوم تاسوعا وعاشورا من شهر المحرَّم، فقال: تاسوعا يوم حوصر فيه الحسين عليه السلام وأصحابه بكربلاء، واجتمع عليه خيل أهل الشام وأناخوا عليه، وفرح ابن مرجانة وعمر بن سعد بتوافر الخيل وكثرتها، واستضعفوا فيه الحسين عليه السلام وأصحابه وأيقنوا أنّه لا يأتي الحسين ناصر»[17]. ففيها دلالة واضحة على ما طرحناه من دور أهل الشام في واقعة الطف.
3 ـ إصرار سليمان بن صرد الخزاعي على الأخذ بالثأر من عبيد الله بن زياد ومَن كان معه وهم في الشام يومئذ، ورفضه فكرة الأخذ بالثأر ممّن كان في الكوفة، «ودعا سلمان بن صرد بالمسيب بن نجبة الفزاري، فقال له: صِرْ إلى ابن عمّك هذا فخبّره أنّا لسنا إيّاه أردنا، وإنّما نريد عبيد الله بن زياد وأصحابه الذين قتلوا الحسين بن علي»[18]. فسليمان بن صرد كان على قناعة تامّة بأنّ مَن قتل الحسين عليه السلام هو عبيد الله بن زياد ومَن كان معه؛ وهم أهل الشام خاصّة. فبعد مقتل سليمان بن صرد ـ رضوان الله عليه ـ في عين الوردة، وزحف جيش عبيد الله بن زياد وفيهم الحصين بن نمير إلى الموصل، قاتلهم إبراهيم بن مالك الأشتر وقتلهم في وقعة خازر. وعن هذه الواقعة وغيرها يقول ابن أعثم: « الهيثم بن عدي: قال: أنبأني عبد الله بن عياش، قال: كان لأهل العراق على أهل الشام النّصر والظفر في ثلاثة مواطن، قتلوا منهم ستة وثمانون ألفاً، منها: وقعة بابلا... ومنها: وقعة خازر... ومنها: يوم دجيل»[19]. فهي دالة وبوضوح على أنّ مَن كان مع عبيد الله بن زياد قد شارك في قتل الحسين عليه السلام بناءً على قول سليمان بن صرد، وهم من أهل الشام الذين قتلهم إبراهيم بن الأشتر بناءً على قول ابن أعثم.
وهذا القتال وهذه الدماء كان سببها تضليل بني أُميّة أهل الشام، وانتهاج سياسة التجهيل والعزل الثقافي والديني عن أُصول الإسلام وتعاليمه، مضافاً إلى أنّهم كانوا حجر الأساس في إعداد الجيش لقتل ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسبطه وأهل بيته، في حادثة تُعدّ من أفظع ما فعله الإنسان على البسيطة، ومشاركتهم قبل ذلك مع معاوية في قتال الإمام علي عليه السلام وسراياهم التي كان يبعثها معاوية للإغارة على قرى أهل العراق، كما أجمل ذلك المسعودي بقوله: «ولم يكن بين علي ومعاوية من الحرب إلّا ما وصفنا بصفين، وكان معاوية في بقية أيام علي يبعث سرايا تُغِير، وكذلك علي كان يبعث مَن يمنع سرايا معاوية من أذيّة الناس»[20].
ثمّ دورهم في وقعة الحرّة التي أعقبت واقعة كربلاء وغيرها؛ كل ذلك يدلّ على غيبوبة الوعي والإصرار على إعانة الظالمين والتسليم المطلق لهم، مع العلم والعمد، فهم من هذه الناحية قد وطّؤوا وهيّئوا ورسّخوا نهج الإرهاب الذي ما فتأ يفتك بهذه الأُمّة إلى يومنا الحاضر، برعاية بني أُميّة ومَن نهج نهجهم وسار على سنّتهم.
فهذه هي الآلية الثانية من آليات الإرهاب الفكري وما اتصفت به من صفات، وتتلخّص بانتهاج سياسة التجهيل وغياب الوعي وتضليل الأفراد المنتمين إلى جهةٍ ما؛ ليكونوا أدوات في تمرير مخطّطاتٍ معيّنة، وتحقيق أهداف محدّدة، وهو أُسلوب ليس بغريب؛ لأنّ الإرهاب الفكري في الحقيقة هو عدو العلم والفكر والرأي والعقيدة، فلا نتصوَّر أن ينتمي إليه غير مَن هم على شاكلته.
الكاتب : السيد شهيد طالب الموسوي
مجلة الإصلاح الحسيني – العدد العاشر
مؤسسة وارث الأنبياء للدراسات التخصصية في النهضة الحسينية
_____________________________________
[1] هود: آية 113.
[2] المسعودي، علي بن الحسين، مروج الذهب: ج2، ص268 ـ269.
[3] ابن طاووس، علي بن موسى، الملهوف: ص105.
[4] مطهري، مرتضى، الملحمة الحسينيّة: ص568.
[5] الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج5، ص330.
[6] الصدر، محمد، شذرات من فلسفة تاريخ الحسين عليه السلام : ص269.
[7] ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج3، ص135.
[8] اُنظر: ابن طاووس، علي بن موسى، الملهوف: ص202.
[9] الصدر، محمد، شذرات من فلسفة تاريخ الحسين عليه السلام : ص269.
[10] الحكيم، محمد سعيد، فاجعة الطف: ص106.
[11] المسعودي، علي بن الحسين، مروج الذهب: ج1، ص362.
[12] المصدر السابق: ص397.
[13] الحكيم، محمد سعيد، فاجعة الطف: ص255.
[14] الحكيم، محمد سعيد، فاجعة الطف: ص255.
[15] الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج5، ص544.
[16] ابن طاووس، علي بن موسى، الملهوف: ص171.
[17] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص95.
[18] الكوفي، أحمد بن أعثم، الفتوح: ج6، ص220.
[19] المصدر السابق: ج7ص88
[20] المسعودي، مروج الذهب: ج1، ص339.









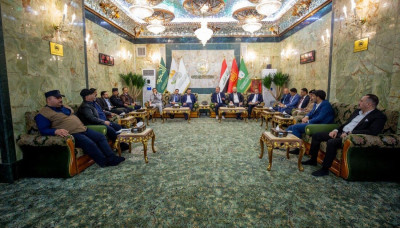






اترك تعليق