منَ المُتسالمِ عليهِ بينَ جميعِ المُسلمينَ أنَّ القرآنَ الذي بينَ أيدينا هوَ ما أنزلَهُ اللهُ على النّبيّ مُحمّدٍ (ص) مِن غيرِ زيادةٍ أو نقيصةٍ، ولَم يقَع جدالٌ حولَ هذهِ القضيّةِ برغمِ تعدّدِ مذاهبِهم وإتّجاهاتِهم، وإن كانَ هُناكَ بعضُ الآراءِ الشّاذّةِ وأخبارُ الآحادِ التي تشيرُ إلى وقوعِ النّقصِ في بعضِ آياتِه، إلّا أنَّ ذلكَ موقفٌ لا يُعتدُّ بهِ ومُخالفٌ لِما أجمعَت عليهِ الأمّةُ، وقَد مثّلَت رواياتُ جمعِ القرآنِ حافزاً للبعضِ للتّأكيدِ على شُبهةِ تحريفِ القُرآنِ، وذلكَ لوجودِ إختلافاتٍ حولَ وقتِ وكيفيّةِ جمعِ القُرآنِ والظّروفِّ والحيثياتِ التي رافقَت عمليّةَ الجمعِ.
فقَد زعمَت مرويّاتُ أهلِ السّنّةِ والجماعةِ أنَّ القرآنَ تمَّ جمعُه في عهدِ الخُلفاءِ بعدَ رسولِ اللهِ، في حينِ يعتقدُ الشّيعةُ أنَّ القُرآنَ تمَّ جمعُه في عهدِ رسولِ اللهِ (صلّى اللهُ عليهِ وآله)، ومنَ المُفيدِ الإشارةُ إلى أنَّ الإختلافَ في وقتِ جمعِ القرآنِ لا يُؤثّرُ على الإتّفاقِ بكونِ القُرآنِ الذي يتعبّدُ بهِ المسلمونَ اليومَ هوَ قرآنٌ واحدٌ لا إختلافَ فيهِ، وعليهِ يصبحُ النّقاشُ في هذهِ المسألةِ مِن بابِ سدِّ الثّغراتِ التي يتحجّجُ بها بعضُ المُشكّكينَ في سلامةِ القُرآنِ.
يعتقدُ عمومُ أهلِ السّنّةِ بأنَّ القُرآنَ جُمعَ في عهدِ الخُلفاءِ، ويرتكزُ هذا الموقفُ على مجموعةٍ منَ المرويّاتِ في مصادرِ أهلِ السّنّةِ، ومِن هُنا فإنَّ مُناقشةَ هذهِ المرويّاتِ وبيانِ مصداقيّتِها مِن عدمِها يحسمُ النّقاشَ في هذهِ المسألةِ، وهذا ما قامَ بهِ السّيّدُ الخوئي في تفسيرِه البيانِ حيثُ تتبّعَ كلَّ هذهِ المرويّاتِ وأثبتَ ما فيهَا مِن تناقضٍ بحيثُ لا يمكنُ الرّكونُ إليها. فبعدَ أن يُقرّرَ السّيّدُ الخوئيُّ أصلَ الشّبهةِ والإشكاليّةَ بقولِه: (إنَّ مصدرَ هذهِ الشّبهةِ هوَ زعمُهم بأنَّ جمعَ القرآنِ كانَ بأمرٍ مِن أبي بكرٍ بعدَ أن قُتِلَ سبعون رجلاً منَ القُرّاءِ في بئرِ معونة، وأربعمائة نفرٍ في حربِ اليمامةِ فخيفَ ضياعُ القرآنِ وذهابُه منَ النّاسِ، فتصدّى عُمر وزيدٌ بنُ ثابت لجمعِ القرآنِ من العسبِ، والرّقاعِ، واللّخافِ، ومِن صدورِ النّاسِ بشرطِ أن يشهدَ شاهدانِ على أنّهُ منَ القُرآنِ، وقَد صرّحَ بجميعِ ذلكَ في عدّةٍ منَ الرّواياتِ، والعادةُ تقضي بفواتِ شيءٍ منهُ على المُتصدّي لذلكَ، إذا كانَ غيرَ معصومٍ، كما هوَ مُشاهدٌ فيمَن يتصدّى لجمعِ شعرِ شاعرٍ واحدٍ أو أكثر، إذا كانَ هذا الشّعرُ مُتفرّقاً، وهذا الحكمُ قطعيٌّ بمُقتضى العادةِ، ولا أقلَّ مِن إحتمالِ وقوعِ التّحريفِ، فإنَّ منَ المُحتملِ عدمُ إمكانِ إقامةِ شاهدينِ على بعضِ ما سمعَ منَ النّبيّ (صلّى اللهُ عليهِ وآله) فلا يبقى وثوقٌ بعدمِ النّقيصةِ.
والحقيقة إنَّ هذهِ الشّبهةَ مُبتنيةٌ على صحّةِ الرّواياتِ الواردةِ في كيفيّةِ جمعِ القُرآنِ والأولى أن نذكرَ هذهِ الرّواياتِ ثمَّ نعقبُها بما يردُ عليها)
ثمَّ يذكرُ جميعَ الرّواياتِ في البابِ ويقومُ بمُناقشتِها روايةً روايةً ويُبيّنُ ما فيها مِن تناقضٍ حيثُ يقولُ: (إنّها مُتناقضةٌ في أنفسِها فلا يمكنُ الإعتمادُ على شيءٍ مِنها، ومنَ الجديرِ بنا أن نُشيرَ إلى جُملةٍ مِن مُناقضاتِها..) ثمَّ يذكرُ هذهِ المُتناقضاتِ بالتّفصيلِ، وحيثُ لا يحملُ المقامُ ذكرَها هُنا فيجبُ على المُهتمِّ الرّجوعُ إلى تفسيرِ البيانِ للوقوفِ عليها.
أمّا ما يخصُّ تسميةَ السّورِ فإنّهُ لم يثبُت أنَّ رسولَ اللهِ (صلّى اللهُ عليهِ وآله) هوَ مَن سمّى جميعَ سورِ القرآنِ، ومعَ ذلكَ فقَد وردَت بعضُ الرّواياتِ عَن رسولِ اللهِ وأهلِ بيتِه بتسميةِ بعضِ السّورِ مثلَ سورةِ البقرةِ وسورةِ آلِ عمران وسورةِ هود وسورةِ الواقعةِ وسورةِ المائدةِ. والظّاهرُ أنَّ تسميةَ السّورِ قَد وردَ ضمنَ آياتِ السّورةِ نفسِها أو مِن خلالِ إقتطاعِ أوّلِ فقرةٍ إفتُتحَت بها السّورةُ مثلَ سورةِ (إقرَأ بِاسمِ رَبِّكَ) وسورةِ (إِنَّا أَنزَلنَاهُ). وقَد يكونُ على أساسِ ما وُصفَت بهِ السّورةُ مِن نعوتٍ في الرّواياتِ مثلَ سورةِ (فاتحةِ الكتابِ) و(أمِّ الكتابِ) و(السّبعِ المثاني) وسورةِ (الإخلاصِ)، ومِن هُنا قد يكونُ للسّورةِ الواحدةِ أكثرُ مِن تسميةٍ، إلّا أنَّ كلَّ ذلكَ كانَ مُتعارَفاً عليهِ منذُ الصّدرِ الأوّلِ للإسلام.



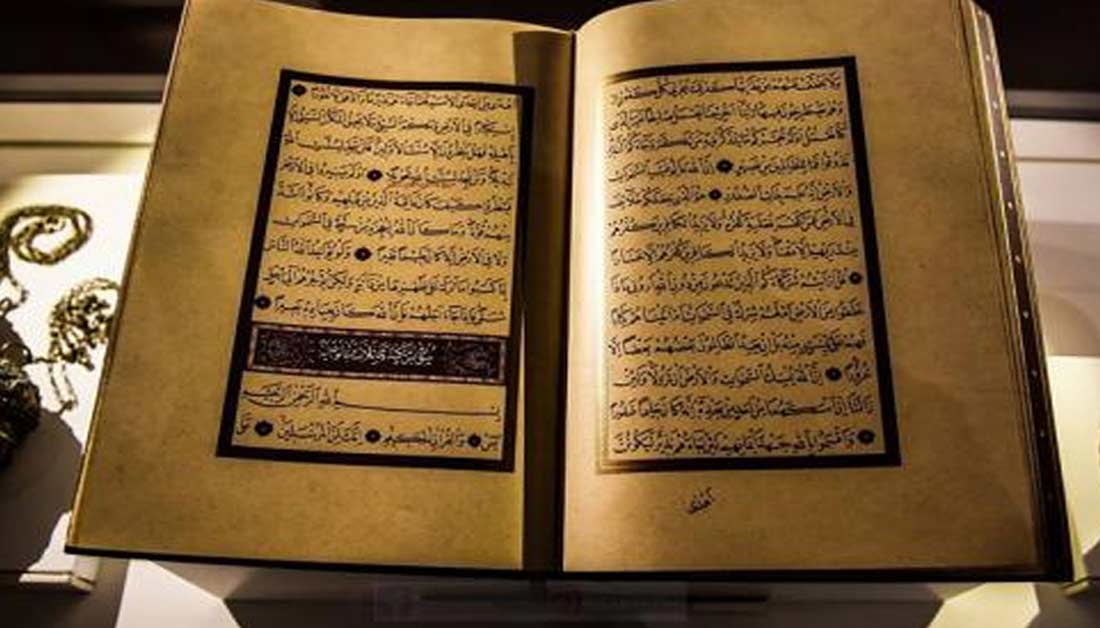

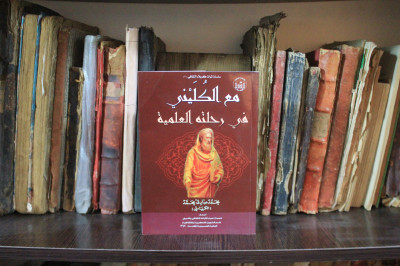










اترك تعليق