حقيقة، يعجز القلم عن الإلمام بحياة الكثير من علمائنا الأعلام ومراجعنا الكبار وتفصيل جوانب حياتهم العلمية المشرقة ولما بذلوه من طاقات جبارة في خدمة الإسلام والمسلمين.
من هؤلاء العلماء الأعلام الشيخ محمد جواد مغنية الذي صارع الحياة وحارب العقبات واستطاع أن يصنع ذاته بذاته ويكوّن مجده بيده لينتمي إلى مصاف العظماء الخالدين.
عاش حياة قاسية أمتزج فيها الكدح والكفاح والمعاناة والبؤس إلا أنها خلت من اليأس فامتلأت فصول حياته بالحركة والمتابعة والدراسة والعمل والعلم حتى أصبح من علماء الإسلام الكبار.
ونجد في انطباع الشيخ حسن خالد مفتي الجمهورية اللبنانية حول شخصية الشيخ محمد جواد مغنية نافذة لتسليط الضوء أكثر على شخصية مغنية العلمية والفكرية والاجتماعية، يقول الشيخ حسن خالد في تأبين الشيخ مغنية:
(ولقد كان الشيخ محمد جواد مغنية ــ رحمه الله ــ فضلاً عن مكانته الاجتماعية، عالماً فاضلاً واسع العلم غزير المعرفة فيما انتجه وينتجه كبار العلماء وجهابذة الفكر والأدب والفن، متابعاً لهم سواء أكانوا من المسلمين أم غير المسلمين، يراقب عطاءهم ويكسب منه الكثير مع شدة محاكمته لهم، ولقد كان كاتباً طيّع القلم، سهل العبارة، غزير المادة، عميق الغور، دقيق النظرة، وكان من العلماء القلائل الذين برزوا في هذه الحقبة من الدهر، وأعطوا الفكر الإسلامي فيضهم الفكري والروحي، وأثروا مكتبته، بل ودرسوا واقع أمتهم، وما أصابها من تخلف وظلم وعدوان، وناقشوا أسباب ذلك ورسموا له بالتالي بفكرهم الشيّد ونظرهم البعيد معالم الطريق).
قد نجد في هذا القول المقتضب صورة قريبة لهذا العالم الجليل ولكنها بدون مؤثرات ونرجو أن نوفق في إعطاء صورة أقرب الى الأذهان عن رحلته الشاقة مع الحياة وسلوكه الجانب العلمي من خلال هذا الموضوع.
الشقاء يواكب مسيرة العلم
ولد الشيخ محمد جواد ــ وهو اسم مركب ــ بن الشيخ محمود محمد مغنية عام 1904م في جبل عامل في لنبان في قرية تسمى (طيردبا) ونشأ في أسرة علمية عريقة في القدم يعود تاريخها الى أكثر من ثمانمائة عام تقريباً وقد اشتهرت هذه الأسرة الكريمة بالوجاهة العلمية والاجتماعية, فالشيخ محمد مغنية ــ جد محمد جواد ــ عالم كبير ومعروف وله مكانته العلمية وحضوره الديني ويعد من الوجوه المعروفة في الأوساط الدينية والسياسية.
وقد توفي كما يذكر السيد محسن الأمين العاملي في سنة 1253 للهجرة في قرية (طيردبا) بعد أن كان قد أرسل ولده محمود ــ والد الشيخ محمد جواد ــ إلى النجف الأشرف لطلب العلم جرياً على عادة قديمة تعود إلى ثمانمائة عام أو يزيد. (1)
وكان الشيخ محمود إلى جانب كونه يعد من العلماء الأعلام فقد عُرف أيضاً بين أوساط الأدباء، أديباً كبيراً وشاعراً مجيداً يقول عنه السيد حسن الصدر ما نصه:
الشيخ محمود مغنية من أهل الغور والتحقيق في المطالب العلمية والحقائق الواقعية، قلّ في معاصريه من العرب من وصل الى مقامه في نيل المطالب. (2)
أما السيد محسن الأمين العاملي فقال عنه: كان الشيخ محمود مغنية عالماً فاضلاً أديباً كريم الأخلاق حسن السجايا. (3)
وفي ميدانه الأدبي يسجل له الأستاذ علي الخاقاني هذه الكلمات ويبين لنا فيها مدى قوة تأثير شعره وإجادته في هذا الميدان فيقول:
إن الشيخ محمود مغنية يسمعنا بشعره صوتاً من عالم أسمى ويعيد برائع بلاغته وعذوبته وتبيانه، عصر أبي تمام والبحتري، وإن شعره يتسامى إلى درجة لا تتسلق إلى وصفها الأفكار. (4)
ومن شعره هذه الأبيات التي أنشدها للسيد محسن الأمين فسجلها الأخير في موسوعته (أعيان الشعية) وهي مدح أهل البيت (ع) يقول فيها:
اللهُ والمصطـفى خير الخليقةِ لي *** وصنوه المرتضى مولى الأنامِ علي
من استغـــــاث بهم في كل نائبةٍ *** يمســــــك بحبلِ ولاءٍ غـير منفصلِ
يا ليت شعريَ هل تخفى مآثرهم *** وهنّ أشـــــــهر من نارٍ عـلى جبلِ
همُ الصراط همُ سفن النجاة همُ الـــــــــــــولاةُ والأنجمُ الهـــــــــادون للسبلِ
وقد تأثر الشيخ محمد جواد باتجاه والده الأدبي فكان مكباً في بداية حياته على الشعر وكتابته رغم أنه لم يعش مع والده طويلاً, فبعد أن عاد الشيخ محمود إلى لبنان من النجف الاشرف لم يطل به المقام في قريته اذ سرعان ما انتقل إلى جوار ربه عام 1916 ولم يتجاوز عمره الرابعة والأربعين عاماً.
أمه
كانت أمه قد سبقت أباه في مفارقة الدنيا حيث ماتت قبل أن يتوجه والده إلى النجف الأشرف وكان هو لا يزال صغيرا ويصف لنا الشيخ محمد جواد ما يذكره عنها فيقول:
أمي من أسرة هاشمية من آل شرف الدين ماتت وأنا في الثالثة أو الرابعة من عمري ولا أتذكر شيئاً من ملامحها وصفاتها ولا من علاقتي به واهتمامها بي سوى صور غامضة مبهجة.(5)
بعد وفاة والدته بقليل هاجر والده إلى النجف واصطحبه معه فبقي في النجف الأشرف أربع سنوات وفي هذه الفترة تعلم القراءة والخط والحساب ومبادئ النحو كما درس اللغة الفارسية واتقنها وهو ما يزال صغيراً وحين عاد إلى موطنه في جبل عامل كان قد نسيها تماماً لأنه لم ينطق بها أبداً، وكان سريع الحفظ فقد حفظ الكثير من القواعد ظناً منه:
أن العلم هو حفظ الكلمات المطبوعة في الكتاب عن ظهر قلب وكفى. كما يقول.
وكان يسعد حينما كان والده يكافئه بقطعة من النقود على ما حفظ، وعندما بلغ التاسعة قفل راجعاَ برفقة والده إلى لبنان
مات والده الشيخ محمود ــ كما بيّنا ــ وله من العمر عشر سنوات وقد خلّف الشيخ محمود ثلاثة أولاد وبنتاً واحدة، أما بالنسبة للبنت فقد تزوجت في حياة أبيها من الشيخ محمد تقي الصادق وهو أحد المجتهدين الكبار كما يقول الشيخ مغنية عنه, أما الذكور فهم: الشيخ عبد الكريم وهو أكبر الأبناء, ثم يأتي الشيخ محمد جواد, ومن ثم الأخ الأصغر واسمه أحمد.
لم يجد مغنية أمامه من ملجأ يلجأ إليه بعد وفاة أبيه سوى منزل أخيه الشيخ عبد الكريم، فانضم مع أخيه الصغير أحمد إلى عائلة أخيهما ولم يظهر من الشيخ عبد الكريم أي تقصير تجاه أخويه فكان لهما بمنزلة الأم والأب والأخ ولكن بعد سنتين قرر الشيخ عبد الكريم أن يرحل إلى النجف الأشرف من أجل طلب العلم كعادة أسلافه وبالفعل فقد سافر. أما زوجته فقد تركت المنزل وذهبت إلى بيت أبيها وهنا تبدأ محنة مغنية ...
رحلة الشقاء والبؤس
رافقت هذه الرحلة الشيخ مغنية لسنوات طويلة إذ لم يبق له معيل يفي بمتطلبات حياته حتى الطعام كان محروماً منه ولا يحصل عليه إلّا بصعوبة بالغة ومعاناة شديدة فيمر عليه أحياناً أكثر من يوم وهو لم يتناول أي شيء من الطعام !
ولندع مغنية يصف لنا بنفسه هذه الفترة المريرة من حياته فيقول:
كنت أقضي الأيام طاوياً لا أذوق الطعام، إلا حبّات من الحمص المقلي، أو من الفستق آكلها مع القشور أشتريها من دكان القرية، حتى هذه كان يحرمني منها صاحب الدكان لعجزي عن وفاء الدين القديم، وما زلت أذكر حتى الآن أني أمضيت ثلاثة أيام لم أذق فيها شيئاً.
وإلى جانب مشكلته مع الطعام ومعاناته القاسية في سبيل الحصول عليه فقد كان يعاني من مشكلة أخرى لا تقل عن أختها قساوة ومرارة وهي مشكلة البرد القارس في الشتاء العنيف وخاصة في الليل.
لقد كُتب عليه أن يصارع الحياة وقسوتها وهو لم يبلغ الثالثة عشرة من عمره، ويصف حالته المؤلمة بكلام موجع فيقول:
كنت أخشى فصل الشتاء والبرد, خاصة إذا غابت الشمس وأقبل الليل، كنت أقيم في بيت أبي القديم أجلس على الأرض وأثني ساقي واضعاً صدري على فخذي وساعدي على رأسي أغطي جسدي بعضه ببعض حتى أصبح كالصرة المربوطة عسى أن تخفّ وطأة البرد، فأصبت من جرّاء ذلك بمرض الروماتيزم ولازمني أكثر من 72 عاماً.
الهجرة إلى بيروت
بعد معاناة طويلة مع الفقر والجوع والاحساس بالغربة قرر مغنية أن يترك القرية وينتقل إلى العاصمة بيروت لعله يجد عملاً يسد به رمقه بعد أن ضاق ذرعاً بحياة البؤس في قريته المعدمة, لكنه لم يجد أية وسيلة تنقله إلى بيروت لأنه لا يمتلك شيئاً من المال فلم يجد أمامه إلا أن يذهب ماشياً رغم البعد الذي يفصل قريته عن بيروت.
بعد يومين قضاها سيراً على قدميه وصل بيروت عند الغروب وسار في الأسواق وأعجبه منظر (الترام) واستولت عليه الدهشة من منظره, لكنه لم يعرف تماماً إلى أين يتجه فهو غريب.. ضائع .. جائع
وأخيراً ابتسم له الحظ فالتقى بأحد أبناء قريته الذي استضافه في الغرفة التي تملكها عجوز ويسكن فيها أكثر من عشرين فرداً من ضمنهم العجوز وابنها وتضع حاجزاً بينها وبين الرجال !
خلال أربع سنوات قضاها كدحاً في العاصمة بيروت طرق مغنية وهو في حداثة سنّه كل الأبواب للحصول على عمل يسدّ رمقه، جرّب بيع الكتب والقصص وبيع المرطبات والعمل في فرن لبيع الكعك، ونجح في مهنة صناعة الحلوى بنفسه وأخذ يبيعها وكانت هذه المهنة هي نهاية المطاف في بيروت.
النفس الصابرة الأبية
لم يكن المراد من وراء وصف الجزئيات والحيثيات والتفاصيل التي مرّ بها الشيخ مغنية في سنيّ حياته الأولى سوى الإشارة إلى أن مثل هذه النفوس الكبيرة لا تعرف اليأس, بل تواجه الحياة بكل ما أوتيت من عزيمة وإرادة.
فرغم كل ما مر به مغنية من أحداث ومصاعب لكنه لم يستسلم للفقر ولا لقساوة الحياة واستطاع أن يصنع ذاته بذاته ويكوّن شخصيته ويبني قاعدة علمية ينطلق منها شأنه شأن العظماء والخالدين فالمجد ليس هبة يوهب لأحد بل هو غالٍ ثمنه التضحية والعمل والمشقة.
فطوال السنوات الأربع التي قضاها كادحاً في بيروت كانت روحه تهفو إلى النجف ونفسه تتوق إلى مجالس العلم والفقه فيها لكي يلتحق بركب عائلته ويصبح من العلماء كما كان أبوه وأجداده وقد عدّ سنوات البؤس التي قضاها في بيروت (نعمة من الله) حيث يقول: (من نعم الله عليّ أني نشأت يتيم الأبوين ولليتيم أكثر من صورة وكلها عواصف وقواصف لكن آثاره على الرغم من ذلك أضداد متنافرة فقد يؤدي اليتم إلى التسوّل وارتكاب الجرائم وقد يجعل الله فيه خيراً كثيراً فيصنع اليتيم كيانه من ألامه ويحقق ذاته من أوصابه تماماً كما تصنع الشعوب المغلوبة من أغلالها معولاً تحطم به السدود والقيود).
إلى مدينة العلم..
لم تكن رحلته إلى النجف بالهينة بل كانت تشوبها المصاعب والمخاطر خاصة أنه لا يملك الأوراق الرسمية ولا المبلغ الكافي لكنه يمتلك بدلها الإرادة والعزم لتحقيق طموحه, فالأمل فطرة أودعها الله في عبده, حتى لو تحطمت سفينة الإنسان في بحر يغشاه اليأس والألم، فإنه سيصل إلى ساحل النجاة بإيمانه وأمله بالله.
عقد مغنية العزم على السفر إلى النجف الأشرف سيراً على الأقدام إن اقتضى الأمر ذلك، وبعد رحلة طويلة محفوفة بالمغامرة والمخاطرة وصل إلى النجف الأشرف وذلك عام 1925 لتبدأ مرحلة مهمة في حياته وهي مرحلة الدراسة والعلم وهي من أهم مراحل حياته وأقواها.
التقى مغنية في النجف بأخيه الشيخ عبد الكريم وسكن معه في منزله وما أن استقر به المقام حتى بدأ بدراسة المقدمات كالأجرومية وقطر الندى على يديه, ثم انتقل إلى الأصول والفقه وكان من أبرز الذين شملوه بالرعاية الأبوية هو السيد محمد سعيد فضل الله الذي كان موضع ثقة الشيخ، فكان يسأله عن كل ما يصعب عليه فهمه ويرجع إليه في مسائل متفرقة وقد استفاد مغنية كثيراً من علومه وتوجيهاته وفضلاً عن هذين العلمين فقد درس مغنية بعد أن انتقل من المقدمات إلى مرحلة السطوح والبحث الخارج على يد السيد أبي القاسم الخوئي (رحمه الله), والشيخ محمد حسين الكربلائي, والسيد الحمامي, وكانت تربطه مع هؤلاء العلماء الثلاثة رابطة قوية وعلاقة وثيقة أكبر من علاقة الأستاذ بتلميذه كما يقول هو (6)
مع الكتابة
بدأ الشيخ محمد جواد يكتب المقالات وينشرها في مجلة (العرفان)، وتوالت كتاباته، أما الشعر فقد توقف عنه تماماً، و كانت النجف الأشرف منطلقة في عالم الكتابة، وبعد عشرة أعوام قضاها في النجف عاد جسده إلى وطنه لبنان أما روحه فبقيت في مجالس النجف وظل طوال حياته يحن إليها حتى أنه حين وافاه الأجل نقل جثمانه إليها ودفن فيها
ويصف الأيام التي قضاها في النجف على أنها من أروع أيام حياته وتجلى حبه العميق للنجف في كتاباته وفي أكثر من موضع فقد ألف كتاباً تحدث فيه عن علماء وشخصيات عملاقة خرجت من النجف أسماه (مع علماء النجف) كما كتب العديد من المقالات التي تناولت تاريخ النجف ومركزها العلمي والفكري منها: (العلم النجفي) و (مدينة النجف) و (النجف في ألف عام) و (حول النجف الاشرف) و (النجف الأشرف في القرن العشرين) و (حديث النجف وذكرياتها) إلى غيرها من المقالات التي تحدثت عن النجف في أكثر من جانب.
عاد مغنية إلى لبنان في عام 1936 عالماً دينياً في قرية (معركة) بقضاء صور وبدأ يمارس مهمته في نشر الوعي الإسلامي بإلقاء دروس في تفسير القرآن الكريم وسيرة الرسول (ص) وفضائل أهل البيت (ع) غير أن أيام البؤس والشقاء أبت أن تفارق الشيخ فعاش أيام (معركة) في ضيق شديد يقول:
(مرّ عليّ أسبوع أو أكثر وأنا اقترض الخبز لي ولعائلتي)! ورغم هذه الحياة الصعبة إلا أن الذي كان يعذب الشيخ أكثر هو انقطاعه عن الحياة العلمية والفكرية التي ألفها في النجف الاشرف، حيث يقرأ ويدرس ويناقش ويدرّس ويكتب ويؤلف وينمو شيئاً فشيئاً وفجأة يرى نفسه في قرية نائية معزولة لا توجد فيها مكتبة ولا كتاب ويصف حالته في تلك الأيام فيقول: (أ أنا في سجن أم منفى؟! أ أنا في محكمة أسمع فيها حكم الإعدام؟!).
رحلة القلم
بعد أربعة أعوام قاسية قضاها في قرية (معركة) غادرها إلى قرية (طير حيفا) وكان ذلك عام 1939 لتبدأ صفحة جديدة في حياة الشيخ في هذه القرية التي تقع بالقرب من الحدود الفلسطينية اللبنانية حيث قضى في هذه القرية عشرة أعوام تقريباً وكان في هذه القرية آمناً مستقراً وقد تحسنت أموره المادية ورزق بأول أولاده (عبد الحسين)
وكان له من هذه القرية رحلة انطلق منها ولكنها رحلة تختلف عن سابقاتها فق انطلق في هذه القرية في رحلته مع القراءة والكتابة وقد ساعدته أجواء الطبيعة الخلابة على التأمل والتفكير، لقد وجد في أجواء هذه القرية ما عوضه أجواء مجالس النجف الأشرف، لقد كان نهماً في قراءاته فإلى جانب كتب الفقه والأصول والأدب والفلسفة والتاريخ التي كان يقرأها فقد كان متابعاً لما تخرجه المطابع في مصر ولبنان والخليج من كتب في الدين والأدب والثقافة المتنوعة...
كان يقرأ لطه حسين والعقاد وتوفيق الحكيم ومحمد حسنين هيكل وشكيب أرسلان وأديب المهجر جبران، كما يقرأ لتولستوي ونيتشة وانجلز وشوبنهاور وشكسبير وبرناردوشو ويتابع أيضاً ما كُتب عن غاندي وأديسون، أما في مجال التأليف في تلك القرية ــ طير حيفا ــ فقد كتب رسالة في الضمان وثانية في الإرث وهما بحثان فقهيان وكتب في الأصول رسالة بعنوان (في مجهولي التاريخ) وبحثاً في (التضمين) وهو دراسة لغوية وألّف كتاباً بعنوان (المرأة) وصنف كتاباً في دعبل والكميت ثم وضع كتاب (المجالس الحسينية)، نُشر وأعيد طبعه مراراً كما وضع كتاب (الوضع الحاضر في جبل عامل)، وهو أول كتاب ينشر وكان ذلك عام 1947.
بيروت مرة أخرى
لقد كانت السنوات التي قضاها في هذه القرية خصبة وكان فيها مثمراً، لكنه كان يتطلع إلى المدينة وأجوائها و أوساطها فغادرها إلى بيروت عام 1948 ليكون قاضياً شرعياً, وفي عام 1949 عين مستشاراً في المحكمة الجعفرية العليا, ثم أصبح سنة 1951 رئيساً للمحكمة حتى سنة 1956, ثم بقي مستشاراً إلى أن تقاعد سنة 1968، ويحتاج هذا الفصل في حياته إلى استعراض طويل وتفاصيل مهمة واجه فيه كثيرا من الانتقادات اللاذعة والضغوط الشديدة إلا أنه لم يكن يبالي ما دام شعاره الحق ورائده العدل.
ويعبر الدكتور بطرس ديب رئيس الجامعة اللبنانية عنه بأنه: (لم يكن يخشَ في الحق لومة لائم)، وهذا ما أدى إلى محاربته من قبل أصحاب الباطل بعد أن يئسوا من ترغيبه بالمغريات ومن ثم إقصائه وقد سعد مغنية بهذا القرار لأن روحه الطاهرة النقية لا يمكن أن تعيش إلا في عالم السمو والفضيلة.
ثم أن هناك أمراً آخر سعد له وهو انصرافه إلى التأليف بشكل كامل منذ عام 1957 واستمر على ذلك حتى وافاه الأجل في 8 /12 /1979 ألف خلالها عشرات الكتب وربما كان عام 1966 من أخصب هذه الفترة وأثمرها حيث تمخضت عن كتابه الخالد: (فقه الإمام الصادق عليه السلام) ومن أهم كتبه: (تفسير الكاشف), وشرح (في ظلال نهج البلاغة), و(شرح الصحيفة السجادية), و(علي والفلسفة), و(الحج على المذاهب الخمسة) وغيرها.
التصدي للوجودية
ولم يقتصر نشاط مغنية العلمي والفكري على التأليف فقط فكان للمحاضرات التي يلقيها صدى واسعاً من قبل الناس والإقبال يشتد في كل محاضرة أكثر من سابقتها كما كانت لديه لقاءات كثيرة مع أكثر من عالم في أسفاره دار فيها حوار ونقاش وبحث وقراءة لأفكارهم ومحاولة الإقناع بالكلمة الطيبة وهذا هو منهجه وقد كتب كل هذا في بعض كتبه (7) وبعض جهوده في الحج، وفي عام 1977 ظهرت موجة المذهب الوجودي الذي سيطر على عقول الكثير من الشباب فما كان منه إلا أن يرد عليه بكتابه (الوجودية والغثيان) ثم تلاه بـ (فلسفة الأخلاق الاسلامية), ثم (الإسلام بنظرة عصرية).
مع الحسين (ع)
اعتاد الشيخ مغنية أن يذهب لزيارة الحسين (ع) في شهر محرم وعندما لم يستطع ذلك بسبب سنه ومرضه كان يذهب إلى حسينية النبطية وعندما حل شهر محرم عام 1400 للهجرة 1979م حضر مجلس العزاء في الليلة الأولى وأخذ يبكي ويبكي بحرارة أكثر من أي عام مضى وفي الليلة الرابعة طلب الحاضرون منه أن يلقي كلمة ولو قصيرة قبل المجلس فاعتذر بسبب مرضه فألحّ الحاضرون لكنه لم ينطق سوى بكلمات حتى وقع على الأرض مغشياً عليه وعندما اسعفوه وعملوا له تنفساً اصطناعياً إذ كان في المجلس أربعة أطباء عاتبهم الشيخ بعد ذلك وبكى لأنهم فوتوا عليه الفرصة لأن يتوفاه الله وهو يتكلم من على المنبر الحسيني وفي ذكرى عاشوراء الحسين، وتمنى لو أنه مات في الحسينية في أيام عاشوراء، وبعد خمسة عشر يوماً أي يوم 19/ محرم/ 1400 المصادف 8/12/1979 فاضت روحه إلى بارئها عن عمر يناهز الخامسة والسبعين وترك وراءه اثنين وستين كتاباً من تأليفه وآلاف الكتب في مكتبته الشخصية وفي يوم 22 محرم نقل جثمانه إلى العراق من مطار بغداد في موكب كبير إلى مدينة الكاظمية ثم إلى كربلاء المقدسة حيث زار الحسين جدثاً وطاف بقبره وهو مسجى وفي اليوم التالي انطلق موكب التشييع إلى النجف الأشرف يتقدمه المراجع والعلماء والأهالي بعد أن أعلنت الحوزة العلمية تعطيل دروسها وصلى على جثمانه المرجع الديني الأعلى السيد أبو القاسم الخوئي ليدفن بعدها في الصحن الحيدري الشريف.
محمد طاهر الصفار
...............................................................................
1 ــ أعيان الشيعة ج 10 ص 110
2 ــ تتمة أمل الآمل ص 396
3 ــ أعيان الشيعة
4 ــ شعراء الغري ج 11 ص 192 ــ 193
5 ــ تجاربي / محمد جواد مغنية ص 22 ف
6 ــ تجاربي ص 43
7 ــ تجاربي ص 365



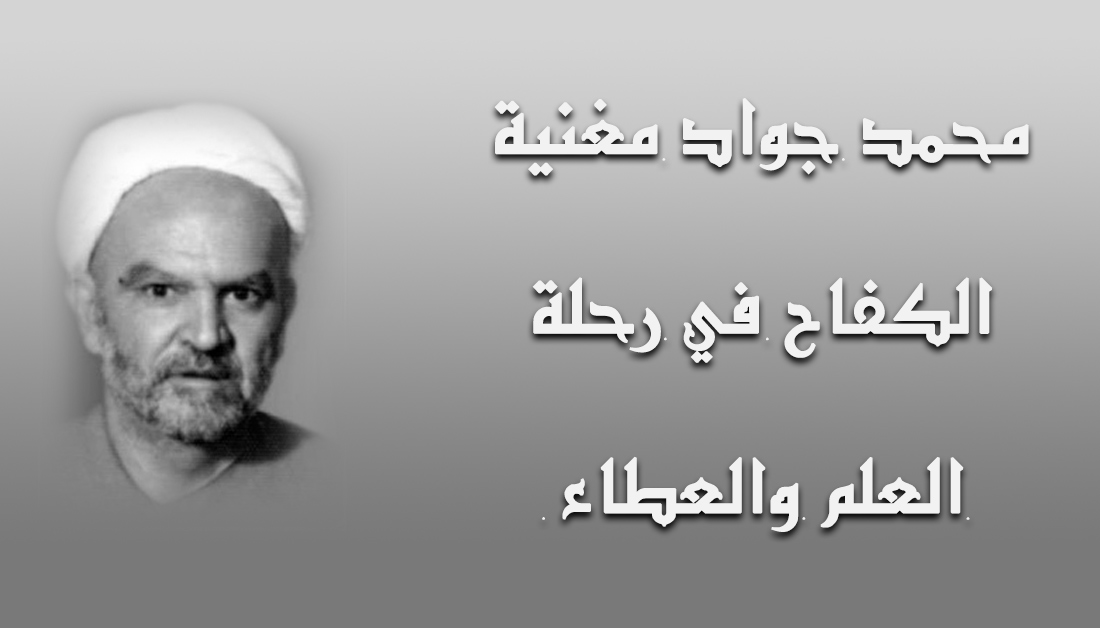












اترك تعليق