بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ( ١) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ( ٢) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ( ٣) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ( ٤) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ( ٥).
قوله تعالى: ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ) الناس ربّما يعملون عملاً أو يبتدؤون في عمل ويقرنونه باسم عزيز من أعزّتهم أو كبير من كبرائهم، ليكون عملهم ذاك مباركاً بذلك متشرّفاً، أو ليكون ذكرى يذكّرهم به، ومثل ذلك موجود أيضاً في باب التسمية فربّما يسمّون المولود الجديد من الإنسان، أو شيئاً ممّا صنعوه أو عملوه كدار بنوها أو مؤسّسة أسسّوها باسم من يحبّونه أو يعظّمونه، ليبقى الاسم ببقاء المسمّى الجديد، ويبقى المسمّى الأوّل نوع بقاء ببقاء الاسم كمن يسمّى ولده باسم والده ليحيى بذلك ذكره فلا يزول ولا ينسى.
وقد جرى كلامه تعالى هذا المجرى، فابتدأ الكلام باسمه عزّ إسمه، ليكون ما، يتضمنّه من المعنى معلّماً باسمه مرتبطاً به، وليكون أدباً يؤدّب به العباد في الاعمال والافعال والأقوال، فيبتدؤوا باسمه ويعملوا به، فيكون ما يعملونه معلّماً باسمه منعوتاً بنعته تعالى مقصوداً لأجله سبحانه فلا يكون العمل هالكاً باطلاً مبتراً، لأنّه باسم الله الّذي لا سبيل للهلاك والبطلان إليه.
وذلك أنّ الله سبحانه يبيّن في مواضع من كلامه: أنّ ما ليس لوجهه الكريم هالك باطل، وأنّه: سيقدم إلى كلّ عمل عملوه ممّا ليس لوجهه الكريم، فيجعله هبائاً منثوراً، ويحبط ما صنعوا ويبطل ما كانوا يعملون، وأنّه لا بقاء لشيء إلّا وجهه الكريم فما عمل لوجهه الكريم وصنع باسمه هو الّذي يبقى ولا يفنى، وكلّ أمر من الاُمور إنّما نصيبه من البقاء بقدر ما لله فيه نصيب، وهذا هو الّذي يفيده ما رواه الفريقان عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم إنّه قال: { كلّ أمر ذي بال لم يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر الحديث }. والأبتر هو المنقطع الآخر، فالأنسب أنّ متعلّق الباء في البسملة ابتدأ بالمعنى الّذي ذكرناه وقد ابتدأ بها الكلام بما أنّه فعل من الأفعال، فلا محالة له وحدة، ووحدة الكلام بوحدة مدلوله ومعناه، فلا محالة له معنى ذا وحدة، وهو المعنى المقصود إفهامه من إلقاء الكلام، والغرض المحصّل منه.
وقد ذكر الله سبحانه الغرض المحصّل من كلامه الّذي هو جملة القرآن إذ قال تعالى:( قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللهُ ) الآية المائدة ١٥ - ١٦. إلى غير ذلك من الآيات الّتي أفاد فيها: أنّ الغاية من كتابه وكلام هداية العباد، فالهداية جملة هي المبتدئة باسم الله الرّحمن الرحيم، فهو الله الّذي إليه مرجع العباد، وهو الرحمن يبيّن لعباده سبيل رحمته العامّة للمؤمن والكافر، ممّا فيه خيرهم في وجودهم وحياتهم، وهو الرحيم يبيّن لهم سبيل رحمته الخاصّة بالمؤمنين وهو سعادة آخرتهم ولقاء ربّهم وقد قال تعالى:( وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ) . الاعراف - ١٥٦. فهذا بالنسبة إلى جملة القرآن.
ثمّ إنّه سبحانه كرّر ذكر السورة في كلامه كثيراً كقوله تعالى:( فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ) يونس - ٣٨. وقوله:( فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ ) هود - ١٣. وقوله تعالى:( وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ ) التوبة - ٨٦. وقوله:( سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا ) النور - ١. فبان لنا من ذلك: أنّ لكلّ طائفة من هذه الطوائف من كلامه ( الّتي فصّلها قطعاً قطعاً، وسمّى كلّ قطعة سورة ) نوعاً من وحدة التأليف والتمام، لا يوجد بين أبعاض من سورة ولا بين سورة وسورة، ومن هنا نعلم: أنّ الأغراض والمقاصد المحصّلة من السور مختلفة، وأنّ كلّ واحدة منها مسوقة لبيان معنى خاصّ ولغرض محصّل لا تتمّ السورة إلّا بتمامه، وعلي هذا فالبسملة في مبتدأ كلّ سورة راجعة إلى الغرض الخاصّ من تلك السورة.
فالبسملة في سورة الحمد راجعة إلى غرض السورة و المعنى المحصّل منه، والغرض الّذي يدلّ عليه سرد الكلام في هذه السورة هو حمد الله باظهار العبوديّة له سبحانه بالإفصاح عن العبادة والاستعانة وسؤال الهداية، فهو كلام يتكلّم به الله سبحانه نيابة عن العبد، ليكون متأدّباً في مقام إظهار العبوديّة بما أدبّه الله به وإظهار العبوديّة من العبد هو العمل الّذى يتلبّس به العبد، والأمر ذو البال الّذي يقدم عليه، فالابتداء باسم الله سبحانه الرحمن الرحيم راجع إليه، فالمعنى بإسمك أظهر لك العبوديّة.فمتعلّق الباء في بسملة الحمد الابتداء ويراد به تتميم الإخلاص في مقام العبوديّة بالتخاطب. وربّما يقال : انّه الاستعانة ولا بأس به ولكنّ الابتداء أنسب لإشتمال السورة على الاستعانة صريحا في قوله تعالى:( وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) .
وأمّا الاسم، فهو اللفظ الدالّ على المسمّى مشتقٌ من السمة بمعنى العلامة أو من السمّو بمعنى الرفعة وكيف كان فالّذي يعرفه منه اللّغة والعرف هو اللفظ الدالّ ويستلزم ذلك، أن يكون غير المسمّى، وأمّا الاسم بمعنى الذات مأخوذاً بوصف من أوصافه فهو من الأعيان لا من الألفاظ وهو مسمّى الاسم بالمعنى الأوّل كما انّ لفظ العالم (من اسماء الله تعالى) اسم يدلّ على مسمّاه وهو الذات ماخوذة بوصف العلم وهو بعينه إسم بالنسبة إلى الذات الّذي لا خبر عنه الّا بوصف من اوصافه ونعت من نعوته والسبب في ذلك أنهم وجدوا لفظ الاسم موضوعاً للدالّ على المسمّى من الألفاظ، ثمّ وجدوا أنّ الأوصاف المأخوذة على وجه تحكي عن الذات وتدلّ عليه حالها حال اللفظ المسمّى بالاسم في أنّها تدلّ على ذوات خارجيّة، فسمّوا هذه الأوصاف الدالّة على الذوات أيضاً أسماء فانتج ذلك انّ الاسم كما يكون أمراً لفظيّاً كذلك يكون أمراً عينيّاً، ثمّ وجدوا انّ الدالّ على الذّات القريب منه هو الاسم بالمعنى الثاني المأخوذ بالتحليل، وانّ الاسم بالمعنى الأوّل إنّما يدلّ على الذات بواسطته، ولذلك سمّوا الّذي بالمعنى الثاني إسماً، والّذي بالمعنى الأوّل اسم الاسم، هذا ولكن هذا كلّه أمر أدّى إليه التحليل النظريّ ولا ينبغي أن يحمل على اللغة، فالاسم بحسب اللّغة ما ذكرناه.
وقد شاع النزاع بين المتكلّمين في الصدر الأوّل من الاسلام في أنّ الاسم عين المسمّى أو غيره وطالت المشاجرات فيه، ولكن هذا النوع من المسائل قد اتّضحت اليوم إتّضاحاً يبلغ إلى حدّ الضرورة ولا يجوز الاشتغال بها بذكر ما قيل وما يقال فيها والعناية بإبطال ما هو الباطل وإحقاق ما هو الحقّ فيها، فالصفح عن ذلك اُولى
وأمّا لفظ الجلالة فالله أصله الإله، حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، وإله من أله الرجل ياُله بمعني عبد، أو من أله الرجل أو وله الرجل أي تحيّر، فهو فعال بكسر الفاء بمعنى المفعول ككتاب بمعنى المكتوب سمّي إلهاً لأنّه معبود أو لأنّه ممّا تحيّرت في ذاته العقول، والظاهر أنّه علم بالغلبة، وقد كان مستعملاً دائراً في الألسن قبل نزول القرآن يعرفه العرب الجاهليّ كما يشعر به قوله تعالى:( وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللهُ ) الزخرف - ٨٧، وقوله تعالى:( فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا ) الانعام - ١٣٦.
وممّا يدلّ على كونه علماً أنّه يوصف بجميع الأسماء الحسنى وسائر أفعاله المأخوذة من تلك الأسماء من غير عكس، فيُقال: ألله الرّحمن الرّحيم ويقال: رحم الله وعلم الله، ورزق الله، ولا يقّع لفظ الجلالة صفة لشيء منها ولا يؤخذ منه ما يوصف به شيء منها.
ولمّا كان وجوده سبحانه، وهو إله كلّ شيء يهدي إلى إتّصافه بجميع الصفات الكماليّة كانت الجميع مدلولاً عليها به بالالتزام، وصحّ ما قيل إنّ لفظ الجلالة اسم للذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال وإلّا فهو علم بالغلبة لم تعمل فيه عناية غير ما يدلّ عليه مادّة إله.
واما الوصفان: الرحمن الرحيم، فهما من الرّحمة، وهي وصف انفعالي وتأثّر خاصّ يلمّ بالقلب عند مشاهدة من يفقد أو يحتاج إلى ما يتمّ به أمره فيبعث الانسان إلى تتميم نقصه ورفع حاجته، إلّا انّ هذا المعنى يرجع بحسب التحليل إلى الإعطاء والإفاضة لرفع الحاجة وبهذا المعنى يتّصف سبحانه بالرحمة.
والرحمن، فعلان صيغة مبالغة تدلّ على الكثرة، والرحيم فعيل صفة مشبّهة تدلّ على الثبات والبقاء ولذلك ناسب الرحمن ان يدلّ علي الرحمة الكثيرة المفاضة على المؤمن والكافر وهو الرّحمة العامّة، وعلى هذا المعنى يستعمل كثيراً في القرآن، قال تعالى:( الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ) طه - ٥. وقال( قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا ) مريم - ٧٥. إلى غير ذلك، ولذلك أيضاً ناسب الرحيم أن يدلّ على النعمة الدّائمة والرّحمة الثّابتة الباقية الّتي تقاض على المؤمن كما قال تعالى:( وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ) الاحزاب - ٤٣. وقال تعالى:( إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ) التوبة - ١١٧. إلى غير ذلك، ولذلك قيل: ان الرّحمن عامّ للمؤمن والكافر والرّحيم خاصّ بالمؤمن.
وقوله تعالى: ( الْحَمْدُ لِلَّهِ ) ، الحمد على ما قيل: هو الثناء على الجميل الاختياريّ والمدح اعمّ منه، يقال: حمدت فلاناً أو مدحته لكرمه، ويقال: مدحت اللؤلؤ علي صفائه ولا يقال: حمدته على صفائه، واللّام فيه للجنس أو الإستغراق والمال هيهنا واحد.
وذلك انّ الله سبحانه يقول:( ذَٰلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ) غافر - ٦٢. فأفاد أنّ كلّ ما هو شيء فهو مخلوق لله سبحانه، وقال:( الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ) السجدة - ٧ فأثبت الحسن لكلّ شيء مخلوق من جهة أنّه مخلوق له منسوب إليه، فالحسن يدور مدار الخلق وبالعكس، فلا خلق إلّا وهو حسن جميل بإحسانه ولا حسن إلّا وهو مخلوق له منسوب إليه، وقد قال تعالى:( هُوَ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ) الزمر - ٤. وقال:( وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ) طه - ١١١. فأنباء أنّه لم يخلق ما خلق بقهر قاهر ولا يفعل ما فعل بإجبار من مجبر بل خلقه عن علم واختيار فما من شيء إلّا وهو فعل جميل اختياريّ له فهذا من جهة الفعل، وأمّا من جهة الاسم فقد قال تعالى:( اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ) طه - ٨. وقال تعالى:( وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ) الاعراف - ١٨٠. فهو تعالى جميل في أسمائه وجميل في أفعاله، وكلّ جميل منه.
فقد بان انّه تعالى محمود على جميل اسمائه ومحمود على جميل أفعاله، وأنّه ما من حمدٍ يحمده حامد لأمر محمود إلّا كان لله سبحانه حقيقه لأنّ الجميل الّذي يتعلّق به الحمد منه سبحانه، فللّه سبحانه جنس الحمد وله سبحانه كلّ حمد.
ثمّ إنّ الظاهر من السياق وبقرينة الالتفات الّذي في قوله:( إِيَّاكَ نَعْبُدُ ) الآية أنّ السورة من كلام العبد، وأنّه سبحانه في هذه السورة يلّقن عبده حمد نفسه وما ينبغي ان يتأدّب به العبد عند نصب نفسه في مقام العبوديّة، وهو الّذي يؤيّده قوله:( الْحَمْدُ لِلَّهِ ) وذلك إنّ الحمد توصيف، وقد نزّه سبحانه نفسه عن وصف الواصفين من عباده حيث قال:( سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ ) الصافّات ١٥٩ - ١٦٠. والكلام مطلق غير مقيّد ولم يرد في كلامه تعالى ما يؤذن بحكاية الحمد عن غيره إلّا ما حكاه عن عدّة من أنبيائه المخلصين، قال تعالى في خطابه لنوح عليه السلام :( فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ) المؤمنون-٢٨. وقال تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام :( الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ) ابراهيم - ٣٩. وقال تعالى لنبيّه محمّد صلى الله عليه و آله وسلم في بضعة مواضع من كلامه:( وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ) النمل - ٩٣. وقال تعالى حكاية عن داود وسليمان عليه السلام :( وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ ) النمل - ١٥. وإلّا ما حكاه عن أهل الجنّة وهم المطهّرون من غلّ الصدور ولغو القول والتأثيم كقوله:( وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) يونس - ١٠.
وأمّا غير هذه الموارد فهو تعالى وإن حكى الحمد عن كثير من خلقه بل عن جميعهم، كقوله تعالى:( وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ) الشورى - ٥ وقوله :( وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ ) الرعد-١٣.
وقوله :( وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ) الاسراء - ٤٤. إلّا أنّه سبحانه شفّع الحمد في جميعها بالتسبيح بل جعل التسبيح هو الأصل في الحكاية وجعل الحمد معه، وذلك أنّ غيره تعالى لا يحيط بجمال أفعاله وكمالها كما لا يحيطون بجمال صفاته وأسمائه الّتي منها جمال الأفعال، قال تعالى:( وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ) طه - ١١٠ فما وصفوه به فقد أحاطوا به وصار محدوداً بحدودهم مقدرّاً بقدر نيلهم منه، فلا يستقيم ما أثنوا به من ثناء إلّا من بعد أن ينزهّوه ويسبحّوه عن ما حدّوه وقدّروه بافهامهم، قال تعالى:( إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) النحل - ٧٤، وأمّا المخلصون من عباده تعالى فقد جعل حمدهم حمده ووصفهم وصفه حيث جعلهم مخلصين له، فقد بان أنّ الّذي يقتضيه أدب العبوديّة أن يحمد العبد ربّه بما حمد به نفسه ولا يتعدّى عنه، كما في الحديث الّذي رواه الفريقان عن النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم : { لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك الحديث } فقوله في أوّل هذه السورة: الحمد لله، تأديب بأدب عبوديّ، ما كان للعبد أن يقوله لولا أنّ الله تعالى قاله نيابة وتعليماً لما ينبغي الثناء به.
وقوله تعالى: ( رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم ِمَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ) (وقرا الأكثر ملك يوم الدين) فالرب هو المالك الّذي يدبّر أمر مملوكه، ففيه معنى الملك، ومعنى الملك (الّذي عندنا في ظرف الاجتماع) هو نوع خاصّ من الاختصاص وهو نوع قيام شيء بشيء يوجب صحّة التصرّفات فيه، فقولنا العين الفلانيّة ملكنا معناه: أنّ لها نوعاً من القيام والاختصاص بنا يصحّ معه تصرّفاتنا فيها ولولا ذلك لم تصحّ تلك التصرّفات وهذا في الاجتماع معنى وضعيّ اعتباريّ غير حقيقي وهو مأخوذ من معنى آخر حقيقي نسمّيه أيضاً ملكاً، وهو نحو قيام اجزاء وجودنا وقوانا بنا فإنّ لنا بصراً وسمعاً ويداً ورجلا، ومعنى هذا الملك أنّها في وجودها قائمة بوجودنا غير مستقلّة دوننا بل مستقلّة باستقلالنا ولنا أن نتصرّف فيها كيف شئنا وهذا هو الملك الحقيقيّ.
والّذي يمكن انتسابه إليه تعالى بحسب الحقيقة هو حقيقة الملك دون الملك الاعتباريّ الّذى يبطل ببطلان الاعتبار والوضع، ومن المعلوم أنّ الملك الحقيقيّ لا ينفكّ عن التدبير فإنّ الشيء إذا افتقر في وجوده إلى شيء فلم يستقلّ عنه في وجوده لم يستقلّ عنه في آثار وجوده، فهو تعالى ربّ لما سواه لأنّ الربّ هو المالك المدبّر وهو تعالى كذلك.
واما العالمين: فهو جمع العالم بفتح اللام بمعنى ما يُعلَم به كالقالب والخاتم والطابع بمعنى ما يقلب به وما يختم به، وما يطبع به يطلق على جميع الموجودات وعلى كلّ نوع مؤلّف الأفراد والاجزاء منها كعالم الجماد وعالم النبات وعالم الحيوان وعالم الانسان وعلى كلّ صنف مجتمع الأفراد أيضاً كعالم العرب وعالم العجم وهذا المعنى هو الأنسب لما يؤل إليه عدّ هذه الاسماء الحسنى حتّى ينتهي إلى قوله مالك يوم الدين على أن يكون الدين وهو الجزاء يوم القيمة مختصّا بالانسان أو الإنس والجنّ فيكون المراد بالعالمين عوالم الإنس والجنّ وجماعاتهم ويؤيّده ورود هذا اللفظ بهذه العناية في القرآن كقوله تعالى :( وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ) آل عمران - ٤٢. وقوله تعالى :( لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ) فرقان - ١، وقوله تعالى:( أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ) الاعراف - ٨٠.
وأمّا مالك يوم الدين: فقد عرفت معنى المالك وهو المأخوذ من الملك بكسر الميم، وامّا المَلِك وهو مأخوذ من المُلك بضمّ الميم، فهو الّذي يملك النظام القوميّ وتدبيرهم دون العين، وبعبارة اُخرى يملك الأمر والحكم فيهم.
وقد ذكر لكلّ من القرائتين، ملك ومالك، وجوه من التأييد غير أنّ المعنيّين من السلطنة ثابتان في حقّه تعالى، والّذي تعرفه اللغة والعرف أنّ الملك بضمّ الميم هو المنسوب إلى الزمان يقال: ملك العصر الفلانيّ، ولا يقال مالك العصر الفلانيّ إلّا بعناية بعيدة، وقد قال تعالى: ملك يوم الدين فنسبه إلى اليوم، وقال ايضاً:( لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ) غافر - ١٦.
الميزان في تفسير القران / ج1




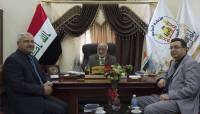













اترك تعليق