إنّ علم الأخلاق من أشرف العلوم إن لم يكن أشرفها؛ إذ إنّ قيمة المرء في الحقيقة تُقدّر بأخلاقه وأعماله، لا بجسمه ولا بعلمه ولا بماله، ففي الحديث النبوي الشريف: «إنّ الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنّما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»[1]، ومن كلام الإمام علي عليه السلام: «قيمة كلّ امرئ ما يحسنه»[2].
وإنّما الأُمم الأخلاقُ ما بقيتْ فإن هُم ذهبتْ أخلاقُهم ذهبوا [3]
حيث اهتمّت الدراسات الإنسانية والاجتماعية والتربوية بدراسة الأخلاق في الطبيعة الإنسانية عبر التاريخ، وعلى مرّ العصور، وحتى الوقت الحاضر؛ لأنّها ترتبط بالممارسات السلوكية الأخلاقية للإنسان حيثما وُجِد؛ لذلك فقد اهتمّت الأديان السماوية والمذاهب الفكرية الفلسفية بدراستها، وتعددت حولها الآراء، واختلفت
مناهج البحث فيها، من حيث تنوّع طُرق وأساليب عرضها، والوسائل المتّبعة فيها.
وقد بذل العلماء والباحثون في شؤون التربية والقيم الدينيّة والأخلاقية، جهوداً كبيرة متواصلة للتوصّل إلى حلّ المشكلات الاجتماعية في ظل الظروف الراهنة لبناء الإنسان والمجتمع على أُسس سليمة وصالحة، ولم تتوقّف هذه الجهود قديماً وحديثاً ولا زالت مستمرّة، إلّا أنّها لم تتّفق على نقاط مشتركة يمكنها أن تكون ميزاناً ومعياراً للجميع؛ وذلك لاختلاف العلماء والمفكرين في عقائدهم الفكرية، ودراستهم للتاريخ والمجتمع، وفي واقعنا الإسلامي تعتبر القيم الأخلاقية والمفاهيم التربوية من أُصول الدين المبني على علاقات إنسانية طيبة في التربية والتعليم، وقال الحكماء: «إنّ اعتدال الإنسان في الأخلاق قد يكون السبب وحده في سعادته»، ولقد جعل رسول صلى الله عليه وآله الأخلاق أساس الدين بقوله: «الدين حُسن الخلق»[4]. بل ذهب عليه الصلاة السلام وآله الكرام أبعد من ذلك، فقد جعل مكارم الأخلاق الغاية من بعثته الشريفة: «إنّما بعثت لأُتمم مكارم الأخلاق»[5].
وتعتبر النهضة الحسينية هي امتداد لفكر الرسول صلى الله عليه وآله ومنهجه الأخلاقي، حيث تعتبر الملحمة الحسينية التي سُطِّرت بأنامل أخلاقية في كربلاء المقدّسة هي منهج مكمّل لأخلاق بيت النبوّة، امتدت أبعد من ذلك هي النهضة الأخلاقية، لتشمل كافة مفاصل الحياة التربوية والاجتماعية والدينية والأخلاقية والاقتصادية، وأصبحت دستوراً أخلاقياً يقتدي به الثوار الشرفاء في العالم؛ لأنّها تعكس واقعاً أخلاقياً يستفيد منه المفكّرون في عصر العولمة والحداثة، وبالإمكان اعتمادها في بناء منهج تربوي جديد ومعاصر، وفي التقنيات التربوية الحديثة وطرائق التدريس الجديدة.
الحسين عليه السلام قائداً وشهيداً
نشأ الحسين عليه السلام نشأته المباركة في بيت النبوّة ومنزل الوحي، رضع درّ الإيمان من أُمّه فاطمة البتول عليها السلام، وتغذّى بغذاء التنزيل على مائدة جدّه الرسول صلى الله عليه وآله، وزُقّ العلم زقّاً من يد والده الكرار عليه السلام، وورث الشجاعة والنجدة والشمم والإباء من هؤلاء الكرام عليهم السلام؛ فكان عليه السلام مثالاً لكلِّ خُلُقٍ فاضل، ورمزاً لكلِّ صفة كريمة، وقد بلغ من إبائه وشهامته عليه السلام أنّه لـمّا بايع الناس معاوية في العام الذي سموه عام الجماعة، وبايعه الحسن عليه السلام على شروط شرحها التاريخ لم يفِ له معاوية ولا بواحدة منها. طلب معاوية البيعة من الحسين عليه السلام، فامتنع ولم يبايع، واكتفى منه معاوية بالسكوت والسكون، ولما آل الأمر لولده الفاجر يزيد ترفّع الحسين عليه السلام عن بيعته، وشرح للناس مساوءه، حتى إذا كان من أمر الكوفيين ما كان وخرج عليه السلام من الحجاز إلى العراق، وأخذ الطريق الأعظم في سيره فقيل: لو تنكبت الطريق كما فعل ابن الزبير؟ فأجاب: «لا والله، لا أفارقه حتى يقضي الله ما هو قاضٍ»[6]. فأبت نفسه الكريمة أن يفارق الطريق المألوف عزّة وإباء، وسار فيه بالرغم على الأُمويين وأذنابهم.
قصد الحسين عليه السلام الكوفة وعلى وجهه الكريم نور النبوّة وأُبّهة الرسالة ووقار الولاية، وهيبة الإمامة، وسيماء جدّه المصطفى بين عينيه، ونفس أبيه المرتضى بين جنبيه، في ذلك الموكب تحف به أسرته وإخوته وبني أعمامه، وكفاك بموكب يسقي ألف فارس وألف فرس، مما كان يحمله من الماء، وذلك عند ملاقاة الحر بن يزيد الرياحي وأصحابه الكوفيين في الأرض القاحلة التي لم يكن فيها ماء ولا كلاء، نادى الحسين عليه السلام أهل بيته وأصحابه: «اسقوا القوم وأرووهم من الماء، ورشفوا الخيل ترشيفاً»[7].
كان أعداء الحسين عليه السلام على يقين من إبائه، وعدم خضوعه لطاغيتهم، ولكنّهم لما رأوه عليه السلام بقي وحيداً فريداً بينهم بعدما قتلوا أصحابه وإخوته وأولاده وبني أعمامه أرادوا أن يبرّروا أعمالهم أمام الرأي العام من أنّهم لا يريدون قتله، وإن جلّ إرادتهم منه البيعة ليزيد فحسب، فعرضوا عليه الأمان، عرض ذلك عليه عمر بن سعد عن عبيد الله بن زياد، فأبى عليه السلام ذلك، وقال: «لا والله، لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، ولا أقر إقرار العبيد»[8]. ثمّ خاطب القوم وقال في خطبته: «ألا وإنّ الدّعي ابن الدّعي قد ركز بين اثنتين بين السلّة والذلّة، وهيهات منّا الذلّة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون»[9].
وهكذا كانت عزّة الحسين عليه السلام، هكذا كان إباء الحسين عليه السلام دعامة قائمة بذاتها، وعمود من الإسلام وهو محوط بنسب كريم ليس في الدنيا أزكى وأطهر وأطيب منه ما دام الله قد نزهّه وطهّره، ودرج في حجور المصطفى صلى الله عليه وآله والمرتضى والبتول عليهما السلام، وترعرع في بيت الرسالة ومهبط الوحي، وكان ريحانة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله في دنياه وسيد شباب أهل الجنة في آخرته، حاول معاوية أن يقيد الإمام الحسين عليه السلام ببيعة ليزيد، أو يضمن على الأقل سكوت الإمام الحسين عليه السلام عن يزيد، فلم يُغنى بطائل.
ويروي المؤرّخون عدّة مواقف للحسين عليه السلام مع معاوية حين أخذ يعدّ الأمر لابنه يزيد من بعده، وقد أراد معاوية أن يحمل الحسين عليه السلام على البيعة ليزيد بحرمان بني هاشم جميعاً من عطائهم، حتى يبايع الحسين عليه السلام، فلم يتحقق له ما أراد حتى مات معاوية والحسين عليه السلام باقٍ على موقفه من الإنكار لبيعة يزيد، حين مات معاوية وكثير من الناس ـ وعامّة أهل العراق بنوع خاص ـ يَرون بغض بني أُمية وحبّ أهل البيت عليهم السلام لأنفسهم ديناً.
فقد اكتشف المجتمع الإسلامي ما فيه الكفاية من عورات الحكم الأُموي، وذاق طعم عذابه وخبر ألوانه من تعسّفه وظلمه بالأرزاق، ولم يكن يزيد في مثل تروي أبيه وحزمه واحتياطه للأُمور، ولم يلتزم أُسلوب أبيه في الاحتفاظ بالغطاء الديني، مدلاً على أفعاله وتصرّفاته، ولم يكن بين الحسن والحسين عليهما السلام من جهة وبين يزيد من جهةٍ أُخرى أيّ عهد أو ميثاق، وهكذا؛ فقد انزاحت بموت معاوية جميع الأسباب التي كانت تحول بين الحسين عليه السلام وبين الثورة والنهضة في عهد معاوية، لقد كان يزيد من أبعد الناس عن الحذر والحيطة والترويّ، كان إنساناً صغير العقل متهوراً سطحي التفكير، لا يهمّ بشيء إلّا ركبه. وأُسلوبه في معالجة المشاكل التي واجهته خلال حكمه يعزز وجهة النظر هذه، وتدل بعض الملاحظات التي ذكرها المؤرّخون عن حياته العاطفية، إنّ هذا النزق والتهور هي سمات أصيلة في شخصيته، ونشأة يزيد المسيحية جعلته أضعف ما يمكن بالعقيدة التي يريد أن يحكم الناس باسمها ـ أعني الإسلام ـ وحياة التحلّل التي عاشها قبل أن يلي الحكم، وقد جعل تلهُّف يزيد على أخذ البيعة له من كبار وزعماء المعارضة له وعلى رأسهم الحسين عليه السلام، فقد كان أكبر همّه حين آل الأمر إليه بعد موت أبيه، هو بيعة النفر الذين أبوا على معاوية بيعة يزيد، فكتب إلى الوليد بن عتبة والي المدينة كتاباً يخبره بموت معاوية، وكتاباً آخر جاء فيه: «وأمّا بعد، فخذ حسيناً وعبد الله بن عمر وابن الزبير بالبيعة أخذاً ليس فيه رخصة، يبايعوا والسلام»[10].
وقد آثر أن يتخلّص من الوليد بالحسنى حين دعاه إلى البيعة، وقال له: «مثلي لا يبايع سرّاً، ولا يجتزأ بها منّي سرّاً، فإذا خرجت للناس ودعوتنا للبيعة معهم كان الأمر واحداً»[11].
ما كانت هجرة الحسين عليه السلام إلّا لمحض الدعوة الإصلاحية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودلّ على هذا صريح قوله عليه السلام: «وإنّي لم أخرج أشراً ولا بطراً، ولا مفسداً ولا ظالماً، وإنّما خرجت لطلب الإصلاح في أُمّة جدِّي، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأسير بسيرة جدِّي رسول الله»[12]. هاجر إلى مكّة المكرمة وهي مهبط الوحي ومبعث الرسالة، وفيها موسم الحج العام، ويجتمع فيه كلّ عام من البلاد الإسلامية جمع غفير، فقصدها ليبثّ هناك دعوته وينشر رسالته، فيحملها عنه كلّ مسلم، ويبلغ بها الجهات النائية لينقذ الإسلام من الهوَّة التي أنزلها به الأُمويون وأتباعهم، فإنّ معاوية ابتدع في الدين وشق عصا المسلمين، ووضع الأحاديث الكاذبة، وجعل أمر الأُمة الإسلامية بيد رجال ذوي مطامع قادهم إلى الشهوات لا إلى الدين، لم تثنهم عن ذلك خشية من الله.
أيزيد يتقلّد زمام الخلافة؟! ما أعظمها من محنة! ليقف أبو الأحرار في وجه جيش الشرك الذي يريد القضاء على الدين الإسلامي، ويطلب يوماً بيوم بدر، وفتحاً بفتح مكّة، وهيهات صرخ أبو عبد الله عليه السلام صرخة الحق، ونشر راية الإخلاص، ووقف محامياً عن دين جدِّه، الذي تحمل الأذى في نشره وإبلاغه ﴿إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الله فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآَنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ الله فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾[13].
قُتِل الحسين عليه السلام فأكبر الناس مقتله واستعظم الجميع تلك الحادثة، واستبشع الكل تلك المجزرة حتى الذين اشتركوا في ذلك الإثم وأشهروا السلاح على آل الرسول أحجموا عن الإقدام، وأعظموا حزّ رأس الإمام من أجل ذلك، خشي خلفاء بني أُميّة ثورة الناس عليهم، واتخاذ أعدائهم لتلك الحادثة المروعة سلاحاً عليهم، فخنقوا كلّ صوت ارتفع بالشكوى، ولم يكفّهم ذلك، بل جعلوا من شتم الحسين عليه السلام وأشياعه على المنابر قبل كلّ صلاة وبعدها سُنّةً يتوارثونها خَلَفهم عن سَلَفِهم، محاولين بذلك ستر تلك الجريمة، وإلقاء التبعة على المقتول، وإفهام السذّج والبسطاء أنّه قُتِل بحق؛ لئلّا ينتبهوا إلى فظاعة الجريمة وجسامة الذنب بلا ريب.
القِيَم: معناها ومفهومها وأهمّيتها
لمحة تاريخية
يعود تاريخ القِيَم إلى قدم الإنسان، فقد غرست الجماعات الاجتماعية في نفوس صغارها قيمها وآراءها عن الصواب والخطأ، وإن نقل القِيَم هي جزء من حياة الإنسان، فالأفراد أو الجماعات يعلمون الخَلَف السلوك المناسب والسلوك الطيب أو غير الطيب أو غير المرغوب فيه، هذا التعليم يكون شعورياً أو لا شعورياً، «ويتّفق الفلاسفة ـ ومنهم إفلاطون وسقراط وأرسطو ـ منذ القدم وحتى الآن على أنّ الهدف من التعليم هو جعل الإنسان ذكيّاً وطيِّباً»، وفي القرن التاسع عشر أصبحت القيمة مبحثاً أساسياً من مباحث الفلسفة يعرف بمبحث القِيَم، وكان ذلك على يد الفيلسوف الألماني نيتشه والبراجماتيين، حسب ما أجمع عليه أغلب مؤرّخي الفلسفة كمبحث قائم.
ويُطرح سؤال هنا: هل كان مبحث القيم موجوداً قبل القرن التاسع عشر كمبحث قائم بذاته، أم كانت تطاله دائرة الإنكار؟ وللإجابة عن هذا التساؤل يمكن القول: إنّ القيم قديمة بقدم الإنسان نفسه، ولكنه لم يجعل لها الصدارة في أقواله أو تفكيره، رغم ما لها من أهمّية في حياته، لذلك في الفلسفات القديمة للقيم لا نعثر على مشكلتها المحورية.
إنّ الفلاسفة القدماء عالجوا مشكلات تندرج تحت مبحث القيمة، مثل: الخير والصواب والالتزام والفضيلة، فإذا رجعنا إلى فلسفات الإغريق ـ مثلاً ـ وجدنا هذه القيم موجودة ضمنياً في فلسفاتهم، فقد اهتمّ سقراط بالفلسفة عامة والأخلاق خاصة، كما ونجد القيمة في فلسفة إفلاطون في حديثه عن الخير الأقصى تتويجاً لعالم الـمُثل، ونراها عند أرسطو في محاولته تنسيق الكائنات على أساس غائي، وعليه؛ فإنّ القيمة لم تحتل مكان الصدارة في فلسفات الإغريق، أمّا العصور الوسطى، فنجد القيمة في فلسفة توما الأكويني تندرج تحت اسم الخير الأقصى أو الكمال، وتحتل القيم مكاناً بارزاً في الفلسفات الإسلامية متمثلة في فكر الفارابي وابن سينا، وفي التفكير الأخلاقي عند ابن مسكويه والغزالي وفلاسفة الصوفية، وكان همّهم أن يقيموا سلَّماً هرمياً للقيم على أساس ديني، بحيث ينظر للقيمة على أنّها تشكِّل الأساس العام لكلِّ مجالات العلوم والمعرفة الإنسانية.
أمّا في العصر الحديث، فلأنّ خير ما يعبّر عن فلسفة القيم مذهب كانْت، فالبعض يعدّه فيلسوفاً للقيمة على الأُصول؛ لأنّه يؤكِّد على أنّ عالم القيم عالم مغلق على ذاته بالنسبة للعقل الخالص، وليس مقفلاً بالنسبة للعقل العملي؛ ولذا كانت فلسفة القيم هي وراثة التراث الكانْتي، إنّ القيم تمثِّل جانباً رئيسياً من ثقافة أيّ المجتمع، فهي تمثِّل لبّ الثقافة وجوهرها، وأنّ القيم يمكن أن تُحدِّد وتُنظِّم النشاط الاجتماعي لكافّة أفراد المجتمع.
إنّ مفهوم القيمة من المفاهيم التي أهتم بها الكثير من الباحثين في مجالات مختلفة كالفلسفة، والتربية، والاقتصاد، وعلم الاجتماع، وعلم النفس وغير ذلك من المجالات، وما يهمّنا هو مفهوم القيمة في علم النفس، فقد اهتم علماء النفس الاجتماعي بكلّ جوانب سلوك الفرد في المجتمع، فعلم النفس الاجتماعي يركِّز عناية على سمات الفرد، واستعداداته واستجاباته، فيما يتّصل بتعاملات مع الآخرين، فموضوع القيم من المواضيع الأساسية في علم النفس الاجتماعي؛ ذلك لأنّ القيم تُعد من المحددات المهمة للسلوك الاجتماعي، إذ إنّ لكلّ مجتمع من المجتمعات فلسفته التي يتعامل بموجبها، وهكذا نجد أنّ القيم موجهات لسلوك الأفراد في المجتمع، وبها يحكم على أفعال الأفراد، وما هو مقبول اجتماعياً لدى المجتمع وما هو غير مقبول؛ ولذا عُرِّفت القيم بأنّها: أفكار أو تصورات توجّه أفعال الأفراد في المجتمع وتحكم سلوكهم وتكتسب صفة العمومية لديهم.
مفهوم القيم
لسان العرب عرّف القيمة بأنّها: مفرد القِيَم، «والقيمة: ثمن الشيء بالتقويم، تقول: تقاوموه فيما بينكم، ويُقال: كم قامت ناقتك؟ أي: كم بلغت؟... والاستقامة التقويم، لقول أهل مكّة: استقمت المتاع، أي: قومتهن، وفي الحديث الشريف: يا رسول الله، لو قومت لنا... فقال: (الله هو المقوّم). لو سعرت لنا، وهو من قيمت الشيء، أي: حددت قيمتها»[14]. فإنّ كلمة قيمة في اللغة العربية مشتقة من القيام، وهو نقيض الجلوس، والقيام بمعنى آخر هو العزم.
وللقيم مفاهيم متعدّدة، منها:
المفاهيم التي يتبنّاها الأفراد لتحديد ما هو مرغوب فيه ممّا يؤثِّر أخيراً في عملية انتقائهم واختيارهم للمثيرات للخارجية.
معتقدات أساسية بموجبها يفضل سلوك معيّن على سلوك آخر على مستوى شخصي أو اجتماعي.
المفاهيم الضمنية أو الصريحة الخاصّة برغبة معيّنة يمتلكها الفرد أو المجموعة، وتؤثِّر في عملية تفضيل خيار معين من بين الخيارات أو الأهداف المتاحة.
وهناك مَن يرى أنّ القيم معتقدات أساسية حول ما صح أو خطأ.
الأهداف التي يسعى الفرد إلى تحقيقها، وهي مرجع حكم للأفراد على أنماط سلوكهم.
مجموعة من الأحكام المعيارية المقبولة والخبرات المختلفة.
جمع قيمة، وتدلّ على أنواع المعتقدات التي يحملها شخص أو مجموعة أو مجتمع ويعتبرها مهمّة ويلتزم بها وتحدِّد له عادةً الصواب من الخطأ.
أنّها عبارة عن تنظيمات لأحكام عقلية انفعالية مصممة نحو الأشخاص والأشياء والمعاني وأوجه النشاط.
أنّ القيمة تكوين افتراضي يُستدلّ عليه من خلال التعبير اللفظي والسلوك الاجتماعي، وهي عبارة عن تنظيمات لأحكام عقلية انفعالية مصممة نحو الأشخاص والأشياء والمعاني وأوجه النشاط.
أنّها الشيء الذي يدلّ على أهمّية وقيمة أمر مهم من ناحية التقدّم والتأخّر، وهي نوع من المعايير والملكات لتشخيص الثمن المادي أو المعنوي للأشياء.
على الرغم من اختلاف التعاريف لمصطلح القيمة اختلافاً واسعاً، كان هناك إجماع واتّفاق على أنّ القيمة مجموعة الأحكام يصدرها الفرد على بيئته الإنسانية والاجتماعية والمادية، فهي نتاج اجتماعي استوعبه الفرد وتقبّله بحيث نستخدمها كمحكمات أو مستويات أو معايير، ويمكن أن تُحدّد إجرائياً في صورة مجموعة استجابات القبول أو الرفض إزاء مواضيع أو أشخاص أو أشياء أو أفكار.
أهمّية القيم
القيم تشكِّل قضية مهمّة شغلت الفكر الإنساني عامّة والتربوي خاصة، واهتمّت فيها الديانات والفلسفات والتنظيمات الاجتماعية، وكانت مركز اهتمام الأنبياء والرسل والمصلحين عبر التاريخ الإنساني؛ لأنّها تمثِّل جانباً رئيساً من الثقافة في أيّ مجتمع؛ لذلك لا يمكن أن ينهض مجتمع ويزدهر دون أن يعتمد على مجموعة من قيم الأخلاق التي تؤيده وتدعمه، فإنّ تنمية المجتمع مرهون بتنمية الثروة البشرية فيه، فالإنسان هو أساس ودعامة المجتمع ووسيلة تطويره، وهو أكرم المخلوقات على الله، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً﴾ [15].
فالثروة البشرية لا تنمو إلّا بواسطة أداة رئيسة هي التربية، التي تعتبر محور التقدّم وحجر الزاوية في كلّ تطوير وإصلاح، لأنّ أيَّ إصلاحٍ أو تغييرٍ لا يستند إلى التربية يزول ويضمحل، والتطوير واجب وضروري لمسايرة تقدم الحياة، ولا تستطيع التربية القيام بهذا الدور إلّا في ظل التعديل المستمرّ لنظم التعليم وأساليبه وأدواته، فعصرنا هو عصر ثورة المعرفة وتفجّرها، والناس لا ينمون ولا ينضجون فيه إلّا بالتعليم والتربية، كيف لا وتعتبر التربية بأنّها إعداد الفرد للحياة، بل هي الحياة نفسها؟!
ولقد لقيت دراسة القيم اهتماماً كبيراً منذ زمن بعيد على يد العديد من علماء الاجتماع وعلماء النفس، وروّاد الفكر، والدراسات الإنسانية، وقد بدأت تعريفات القيمة مجرّدة عن طريق مفاهيم الخير والكمال والعلو والغايات وما يجب أن يكون عليه، كما نجد أنّ عدداً من علماء النفس الاجتماعي يعرفون القيمة من خلال مصطلحات مرتبطة بالمفهوم، مثل الاهتمامات والسرور، والتفضيلات، والرغبات، والحاجات، وعوامل الجذب، وقد اهتمّ الباحثون خلال القرن التاسع عشر بتنوّع ظواهر القيم ونسبتها وتوقّفها على الأفراد وحالاتهم، أكثر ممّا اهتمّوا بوحدتها وطبيعتها الميتافيزيقية، ولقد احتلت نظريات القيمة المكانة الأُولى في ألمانيا حوالي عام (1900م)، وفي إنجلترا وأميركا حوالي (1910م)، أمّا فرنسا فقد ظل الأمر على عكس ذلك، بالرغم من بعض البحوث الهامّة التي نُشرت متفرّقة وكانت متضمّنة لهذا المفهوم.
القيم من المفاهيم الجوهرية في جميع ميادين الحياة التربوية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وهي تمس العلاقات الإنسانية بكافّة صورها؛ لأنّها ضرورة اجتماعية، ولأنّ لها معايير وأهداف لا بدّ أن تجدها في كلّ مجتمع منظّم، سواء أكان متخلفاً أم متقدّماً، فهي تتغلغل في الأفراد في شكل اتّجاهات ودوافع وتطلّعات، وفي بعض المواقف الاجتماعية تعبِّر القيم عن نفسها في شكل قوانين وبرامج للتنظيم الاجتماعي والنظم الاجتماعي.
معايير لتنمية القيم الأخلاقية في الأساليب التربوية الحديثة
إذا كانت مجتمعاتنا الإسلامية والعربية بحاجة ملحّة إلى التقدّم العلمي والمعرفي وإلى التطوّر المادّي في مجالات شتّى من الحياة، فإنّها أحوج ما تكون إلى الأخلاق المشتقة من القرآن الكريم والسنّة المطهّرة، وإنّ ما يصيب المجتمعات بشكلٍ عام من مفاسد، وما يفشو بين أفرادها من الجرائم والموبقات، إنّما يرجع إلى نقص القيم وخلل في البناء الخلقي أكثر من أن يكون نتيجة نقص في مجالات العلم والمعرفة، ولما كانت التربية تحتل الدور الأساس في بناء الجانب الأخلاقي للإنسان ووقايته من الأمراض الخلقية التي أصبحت ظاهرة تقتضي تجنيد المؤسسات التربوية لمقاومتها والانتصار عليها.
ونظراً لازدياد الشكوى العامّة على جميع المستويات من اهتزاز القيم وضعف المستوى الأخلاقي للطلاب، بل والأجيال الجديدة بصفة عامة، ولافتقار قسم كبير من المعلّمين إلى مواصفات المربِّي الناجح، واستجابة للدعوات والاستغاثات التي تنطلق من هنا وهناك، والداعية إلى العودة إلى أُصولنا الإسلامية والحضارية لنبني عليهما مؤسساتنا التعليمية ولنقف بوجه التيارات الفكرية والعلمانية والاستشراقية الوافدة، ولتحقيق أهداف مجتمعنا الإسلامي الأصيل، لما كان مدرسو التربية الإسلامية في مقدمة مَن يُنتظر منهم تربية الناشئة تربية أخلاقية قويمة، وإنّ قسماً كبيراً من مدرسي مادة التربية الإسلامية لا يربّون الناشئة بالقدوة الحسنة في مجال الأخلاق، فقد أكدت أكثر من دراسة أنّ قسماً من المعلّمين لا يجعلون من أنفسهم قدوة حسنة لتلاميذهم؛ إذ إنّ هؤلاء المعلّمين يحدّثون طلابهم في موضوع ولكن ذلك لا يظهر في سلوكهم.
ونظراً لضعف أساليب التدريس المعتمدة من أغلب المدرسين في الوقت الحاضر، فقد وجد الباحث أنّ هناك مشكلة تستحق الدراسة، ألا وهي ضرورة استلهام الأساليب التربويّة من حضارتنا الإسلامية الأصيلة، وعبر عصورها المشرقة، وبيان فاعليتها في مجال تدريس الأخلاق الإسلامية؛ وذلك لتكوين جيل قادر على مواجهة الهجمة الغاشمة التي تسعى إلى حجب نور الإسلام عن الإنسانية التعيسة، ومحاولة صرف بني البشر عن شاطئ الأمان الذي ما زالت تبحث عنه في ظلمات التيه والضياع، والتقليل من أثر تلك الهجمة الغاشمة، وضرورة الارتقاء بالتلاميذ لتمكِّنهم من فهم الأخلاق الإسلامية الأصيلة، وجعلها قيماً ثابتة توجّه بها حياتهم اليومية في البيت والمدرسة والمجتمع.
إنّ الفوز في السباق المعاصر بين الأُمم يعتمد على قدرتها على تربية أبنائها تربية تنبع من عقيدتها وقيمها، وتقي أبناءها من التلوث الفكري، وتتيح لهم حرية الفكر والتعبير والتطبيق في حدود النظم والقيم المرعيّة، وتستثمر أساليب العصر وتقنياته في إطلاق طاقاتهم الإبداعية، وتكون أجيالاً لا تقنع باستيعاب المعاصر فقط، ولكنّها تتطلّع أيضاً إلى المستقبل لتسهم في صنعه، فللعملية التربوية أهمّية خاصة في حياة المجتمع والأفراد، فالمجتمعات بحاجة إلى التربية لتعديل سلوكهم، وإكسابهم القدرات والمهارات المختلفة؛ وبذلك تسهم العملية التربوية بتأثير هام وفاعل في تقدّم الأُمم والشعوب من خلال بناء الإنسان ليتحمّل مسؤوليته في المجتمع والتربية في فراغ، ففي العملية التربوية يقوم أفراد إنسانيون بتوجيه أفراد إنسانيين نحو غايات معيّنة، مستعملين في ذلك وسائل معيّنة. ومن هنا كان تباين النظريات التربوية في المجتمعات المختلفة، فالتربية الماركسية تربية مادّية تسقط حساباتها كلّ المثل للقيم العليا؛ لأنّها لا تؤمن أصلاً بوجود مثل هذه القيم، فجلّ همّها إعداد الفرد ونموه نمواً متكاملاً، بحيث يصبح قادراً على مجابهة أيّ تغيير في وسائل الإنتاج، وفي المجمعات الغربية إذ تسود الديمقراطية تعد المهمة الأساسية للتربية ـ حسب زعمهم ـ تسهيل سبل تبادل الأفكار بين أفراد المجتمع الواحد، لكن التربية الديمقراطية تربية نفعية في أُصولها؛ لذا فإنّها لا تقيم وزناً للحقائق المطلقة، وبدلاً من ذلك فأنّها ترى أنّ الخبرة هي محك صدقها أو كذبها.
فالإيمان بالله ـ حسب المذهب النفعي ـ حقيقة إذ أدّى إلى نتائج مرغوب فيها كأن يشعر أبناء المجتمع بالتماسك والنتيجة المنطقية لهذه المقدمات: «أن يصبح الدين باطلاً في المجتمع الذي لا يجني أفراده فائدة منه»[16]. ولا شك في أنّ هذه المقولة مغلوطة من أساسها؛ لأنّها تجعل النتائج معياراً للحكم على الأسباب التي أنتجتها، وترفض أن تكون النتائج تبعاً للأسباب.
وتُعدّ التربية الأداة الرئيسة والركيزة المهمة في المجتمعات كافّة، والتي تعتمد عليها في تنشئة وتربية الأجيال وإعدادهم للحياة، ويزداد أثر التربية في الوقت الحاضر نتيجة للخصائص العصرية والحضارية التي يتميّز بها عالمنا المعاصر؛ إذ تهتم الدول جميعاً بالتربية الشاملة من أجل التنمية والنهوض بالحياة الاجتماعية على مستوى الفرد والمجتمع. ولا يمكن للتربية أن تحقق أهداف التنمية الاجتماعية المتوقعة وأهدافها المنشودة إلّا بنجاح العملية التربوية، لأنّ التربية عملية اجتماعية ثقافية تستمدّ مقوماتها وأُسسها وأهدافها من عقيدة المجتمع ونظمه الاجتماعية؛ إذ تتولّى بناء شخصيات الأفراد ليقوموا بأدوارهم المستقبلية في المجتمع، كما أنّ للعملية التربوية أهمية خاصة في حياة المجتمعات والأفراد، فالمجتمعات بحاجة إلى التربية لتحقيق التنمية بجوانبها المختلفة ـ الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعلمية ـ كما أنّ الأفراد بحاجة إلى التربية لتعديل سلوكهم وإكسابهم القدرات والمهارات المختلفة، وبذلك تسهم العملية التربوية بأثر مهم وفاعل في تقدّم الأُمم والشعوب من خلال بناء الإنسان ليتحمّل مسؤوليته في المجتمع، فالأُمم التي اعتمدت التربية والتعليم مدخلاً طيباً لتقدّم حضارتها وتطوير مجتمعاتها، حتى قال قائل: إنّ الألمان عندما انتصروا في الحرب السبعينية: «لقد انتصر معلّم المدرسة الألمانية». وقال قائل: إنّ فرنسا عندما انهزمت في الحرب العالمية الثانية: «إنّ التربية في فرنسا متخلفة».
وقال قائل: إنّ الأميركان لما غزا الروس الفضاء بإطلاقهم القمر الصناعي (سبوتنك): «ما دهى نظامنا التربوي والتعليمي؟!». فعادوا ينقحون ويطورون. وما نجاح اليابان المبكر ـ وهي الخاسرة في الحرب الكونية الثانية ـ في مختلف الميادين التكنلوجية والاقتصادية والاجتماعية بالدرجة الأساس، إلّا وهو اهتمامها في التربية والتعليم، وإلى نظام التعليم ومستوياته الممتازة، ولما كانت التربية تحتل المهمة الأساسية في بناء الجانب الأخلاقي للإنسان، ذلك لأنّ الأخلاق الفاضلة هي عنوان صلاح الفرد والمجتمع وسرّ بقائهما واستقامة حياتهما، ومصدر سعادتهما.
ولا شك أنّ المجتمع الذي يفتقر إلى الأخلاق الفاضلة بين أفراده هو مجتمع أقرب إلى قطيع الغاب، سرعان ما يلحق به الدمار والخراب، ولقد كانت في التاريخ البشري آيات وعبر إذ حمل التاريخ لنا في طياته أنّ أهم أسباب تقويض الأُمم القويّة ونهايتها كان في انحلال وتفكك نظامها الأخلاقي.
فالتربية هي التي تنقل إلى الأجيال الناشئة أخلاقيات آبائهم وأجدادهم ومثلهم وقيمهم، وتسهم بطابع خاص يميزهم عن غيرهم من أفراد المجتمعات الأُخرى في تصرّفاتهم وسلوكهم، وتعطيهم القدرة على التكيّف مع المواقف المختلفة على وفق مقتضيات النظام الأخلاقي السائد في مجتمعهم.
والتربية الأخلاقية في نظر الإسلام يعبّر عنها بأنّها تنشئة الطفل على المبادئ الأخلاقية وتكوينه تكويناً كاملاً من جميع النواحي، وذلك التكوين استعداد أخلاقي للالتزام بها في كلّ مكان وإشباع روحه بروح الأخلاق، وذلك بتكوين عاطفة وبصيرة أخلاقية ليكون سبّاقاً للخير أينما كان وحيثما وُجد، وذلك باستعمال جميع الأُسس والطرائق والأساليب التي تساعد على تحقيق وتكوين ذلك الإنسان الأخلاقي وتربيته على الخير، ولما كانت العملية التعليمية جزء من العملية التربوية التي تهدف إلى التنمية المتكاملة للشخصية الإنسانية بمختلف الأساليب والطرائق ليكون فرداً صالحاً في مجتمعه، وهي بذلك تشمل جميع الجوانب الروحية، والعقلية، والخلقية، والاجتماعية والوجدانية والجمالية، والبدنية، فعملية التعليم إذا زالت عنها السمة التربوية أصبحت مجرّد حشو وتكديس لمعلومات لا تعيد في تشكيل الشخصية أو تعديل اتجاهاتها بالشكل الإيجابي المرغوب فيها، والحاجة الماسّة تظهر دائماً (للمربّي الناجح) الذي يمكنه القيام بعمليتي التربية والتعليم معاً، فيساعد على تكوين الشخصية السوية المتكاملة لا المعلّم الذي يقتصر أثرة على تلقين الدروس والمعارف، فللتعليم دور أساس في تحريك المجتمعات الإنسانية عن طريق التنمية الاجتماعية والاقتصادية. فالمفكرون ينظرون إلى التعليم على أنّه أهم مصادر إعداد الطاقات الإنسانية المدرّبة، هذا إن لم يكن مصدرها الوحيد في إعداد هذه الطاقات.
ومن هنا؛ جاء اهتمام الأُمم المتقدمة بإعداد المعلّم وتدريبه لكونه المحرِّك الأوّل في المجتمع، والذي ينفرد في حالات تغيير بنيته حتى قيل: «أعطني معلّماً جيداً أعطيك المجتمع الذي تريد». ومن هنا؛ فإنّ المعلّم في مراحل التعليم العام بشكلٍ عام والابتدائي بشكلٍ خاصّ يبقى العنصر الفاعل والمتفاعل في العملية التربوية باعتباره يعمل على تربية وتنشئة الناشئة.
ولذا يُعد المعلّم هو حجر الزاوية في عملية التعلّم والتعليم؛ لأنّ مهماته تتعلّق بمختلف مجالات العملية التعليمية من إدارة وإرشاد تعليمي وفنّي ومعالجة مشكلات المتعلِّم، وسدّ الثغرات في المنهج الدراسي، والتوصّل مع أولياء الأُمور ومختلف أعضاء المجتمع، فالمعلّم هو الحافظ لتراث الحضارة والمسؤول عن نقله من جيلٍ إلى جيل، وهو الركن الأساس في العملية التربوية، إذ يستطيع استغلال كلّ الفرص في سبيل تهيئة الظروف من أجل تكوين الخبرات والمهارات عند التلاميذ، وإحداث التغيير في الأفراد نحو الاتجاه الذي يمكّنهم من التكيّف مع ذواتهم ومجتمعهم ومتغيّرات العصر الذي يعيشونه، فبإمكان الفرد أن يقوم بتأليف الكتب ووضع البرامج التعليمية، إلّا أنّ ذلك لم يكن ذا فائدة تُذكر ما لم يوجد المعلّم القادر على تطبيق ذلك في الحياة العملية، كما أنّ المعلّم في أية مرحلة من مراحل التعليم مسؤول عن تكوين جيل قادر على تحمّل المسؤولية لخدمة وطنه، فالمعلّم يؤدّي أثراً مهمّاً في تكوين شخصيات تلاميذه، ومن ثمّ تحقيق نموهم الكامل، ولـمّا كان المعلّم عنصراً أساسياً في العملية التربوية؛ فإنّ نجاح هذه العملية مرهون بالدرجة الأُولى بتوفير معلّم جيد الإعداد، يتمكّن من ترجمة مناهج التعليم وبرامجه المختلفة إلى خبرات تربوية ناجحة، يتفاعل معها المتعلمون، فتنمو شخصياتهم بجوانبها المختلفة، المعرفية والمهارية والوجدانية والاجتماعية؛ لذا فإنّ مهمة المعلّم في التربية الأخلاقية تحتاج إلى إعداد ومران ومعارف يتمكّن من خلالهما إيصال المتعلمين إلى المرحلة المطلوبة من التنشئة الأخلاقية التي تتوافق مع عقيدة المجتمع الذي يعيش فيه المعلّم.
أمّا طريقة التدريس، فهي واحدة من أركان العملية التربوية والتي لا تستغني عنها أيّ عملية تعليمية، فإذا تصورنا أنّ العملية التربوية التعليمية تتطلّب مدرساً يلقي الدرس وطالباً يتلقّى الدرس، وبينهما مادّة دراسية، فالطريقة التدريسية تشكِّل الركن الرابع في هذه العملية، وإنّ نجاح التعليم يرتبط إلى حدّ كبير بنجاح الطريقة، وتستطيع الطريقة السديدة أن تعالج كثيراً ضعف المنهج وضعف الطالب وصعوبة الكتاب المدرسي، وغير ذلك من مشكلات التعليم.
وإذا كان المدرسون يتفاوتون بمادّتهم وشخصياتهم، فإنّ التفاوت بينهم من حيث الطريقة أبعد أثراً وأجل خطراً، فالعملية التربوية الثلاثة المذكورة بحاجة إلى وسيلة أُخرى ينساب عبرها المنهج وخبراته، وهي طريقة التدريس التي تعبِّر عن حالة التفاعل بين المدرس والطالب، ومن خلال هذا التفاعل يمكن إجراء عملية تقويم للعملية التعليمية كلّها؛ إذ يتحدّد الأداء الضعيف حتى يمكن تحسينه، ويمكن الوقوف على الأداء السليم حتى يمكن تدعيمه، والأداء الخاطئ إن وُجد يُحذف، ونصل إلى أفضل فاعلية ممكنة للعملية التعليمية، فالطريقة التي يستعملها المدرس تساعد على إيصال المعلومات والمهارات إلى المتعلِّم، وتمكينه من استيعابها وتسهل العملية التعليمية، ولكي نوازن بين أفضلية المنهج والطريقة، يمكن أن نشير إلى القول الآتي: «منهج فقير بمحتواه، وجيد في طرائقه التدريسية لهو أفضل بكثير من منهج غني بمحتواه وجامد بطرائقه»[17].
طرائق التدريس تهدف بصفة عامة إلى تنظيم المواقف التعليمية، بما يؤدِّي إلى تنمية القدرة على التحكّم وتمكين المتعلمين من ممارسته اعتماداً على جهودهم الذاتية لتنمية شخصياتهم بجوانبها كافّة، وهذه المواقف التعليمية تقوم على التواصل الفعّال وحوار نشط بين المتعلِّم والمعلِّم بمهام الهداية والتوجيه وتنمية اهتمام المتعلِّم وبواعثه على التعلُّم وتمكينه من الإقبال عليه بشوق، ومن استثمار قدارته في مواجهة مشكلاته، وتنمية القدرات والمهارات والقيم الملائمة لها، وتطوير شخصية المتعلم. إنّ طرائق التدريس تؤدِّي وظيفة مهمّة وأثراً أساسياً في العملية التربوية؛ لأنّها تمثِّل حلقة الوصل بين المعلِّم والمتعلِّم.
والعملية التربوية والتعليمية لا تحقق النتائج المرغوب فيها، إلّا إذا توفّرت طرائق التوجيه والإرشاد والتدريس المناسبة، وعن طريق مربٍّ مؤهّل وقادر على توصيل المنهاج الدراسي إلى التلاميذ بطريقة ميسرة ومفهومه، ولـمّا كان أُسلوب التدريس هو الجزء الإجرائي من طريقة التدريس التي يعتمدها المدرس لنقل مادته العلمية وإيصالها، أو خبرات المنهج إلى التلاميذ كأُسلوب المحاضرة وأُسلوب المناقشة، التي يستعملها المدرس، وهي أساليب مشتقة من الأساليب الإلقائية، وإنّ مفهوم أُسلوب التدريس يمكن أن نعرّفه بأنّه: مجموعة الإجراءات والتدابير أو المسار الذي يسلكه المعلم في عملية التفاعل المتبادل بينه وبين المتعلمين وعناصر البيئة المختلفة، التي يهيؤها المعلِّم لإكساب طلابه المعارف والمعلومات والخبرات والمهارات والاتجاهات في مدّة زمنية محددة هي الدرس.
يعد قسم من التربويين طرائق التدريس وأساليب التدريس مصطلحين يدلّان على شيء واحد، في حين يكون الواقع مختلفاً، فالمدرس في طرائق التدريس يعنى بالإجراءات العامة التي يقوم بها المدرس في موقف تعليمي معيّن، بينما مصطلح الأساليب إجراءات خاصة يقوم بها المدرس.
إنّ سلوك التدريس بحكم طبيعته موجود دائماً في إطار من التفاعل الاجتماعي بين المدرس وطلبته، ولهذا فإنّ الأعمال التي يقوم بها المدرس أثناء قيامه بالتدريس يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالخصائص الشخصية للمدرس، وإنّ أساليب التدريس تؤثِّر في تحصيل الطلبة، فقد أُجريت دراسات أجنبية تناولت هذه العلاقة وأوضحت إحدى هذه الدراسات تأثير سلوك المدرس في تحصيل الطلبة، وإنّ أُسلوب التدريس الواحد ليس كافياً وليس ملائماً لكلّ مهام التعليم، وإنّ المستوى الأمثل لكلّ أُسلوب يختلف باختلاف طبيعة مهمة التعليم.
ومن كلّ هذا يتبين أنّ طرائق التدريس تُعد من الأدوات الفعّالة والمهمة في العملية التربوية؛ إذ إنّها تؤدّي أثراً أساسياً وفعالاً في تنظيم المواد الدراسية، وفي تناول المادة العلمية، ولا يستطيع المعلم أو المدرس الاستغناء عنها؛ لأنّ من دون طريقة تدريسية يتبعها المعلّم أو المدرس لا يمكن تحقيق الأهداف التربوية العامة والخاصة، وبما أنّ الطريقة تُحدَّد من المدرس أو المعلم معتمداً على قسم الأُسس مثل: المادة العلمية، المرحلة المدرسية، التلاميذ، والأهداف وغيرها من العوامل، وإن تفاعل المعلّم مع التلاميذ يعتمد على الطريقة التدريسية التي يبيّنها كلّ من المعلّم والمدرس. وهكذا فإنّ طرائق التدريس التي تُتّبع من قِبَل المعلّم وجميع ما لديه من أساليب وأنشطة تعمل على جذب انتباه التلاميذ، وجعلهم يرغبون في المادة العلمية ويترقّون إليها تُعدّ الأساس في نجاح المعلّم والمدرس في علمه، وعلى مدى إفادة التلاميذ من عمله.
أمّا المنهج، فهو من الأهمّية بمكان؛ إذ يُعدّ الأداة لتنشئة الأجيال تنشئة صالحة ومساعدتهم على تفتّح وتنمية استعداداتهم، ومواهبهم وقدراتهم، والمساهمة الفعّالة في تقدّم مجتمعهم.
الكاتب: م. م. سنان سعيد جاسم
مجلة الإصلاح الحسيني - العدد السابع عشر
مؤسسة وارث الأنبياء للدراسات التخصصية في النهضة الحسينية
________________________________________
[1] جامعة البصرة/كلّية التربية ـ القرنة ـ/قسم اللغة العربية، علوم تربوية ونفسية، الإرشاد النفسي والبرامج الإرشادية. النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم: ج8، ص11.
[2] الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص532.
[3] شوقي، أحمد، الشوقيات.
[4] اُنظر: الشنقيطي، محمد الأمين، أضواء البيان: ج 8، ص250.
[5] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج16، ص210.
[6] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص35.
[7] المصدر السابق: ج2، ص78.
[8] الأزدي، أبو مخنف، مقتل الإمام الحسين عليه السلام: ص118.
[9] ابن نما الحلي، جعفر بن محمد، مثير الأحزان: ص40.
[10] ابن الأثير، عليّ بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج4، ص14.
[11] المصدر السابق: ص15.
[12] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص329.
[13] التوبة: آية 111.
[14] ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج12، ص500.
[15] الإسراء: آية 70.
[16] آل عمرو، محمد بن عبد الله، مقال: نحو التوجيه الإسلامي للعلوم التربوية. http://www.tarbyatona.net/include/plugins/article/article.php?action=s&id.
[17] العتابي، محمد خضر، أثر أُنموذج آشور في اكتساب المفاهيم التاريخية لدى تلاميذ الصف الخامس الابتدائي، مجلة الأُستاذ، العدد 203: ص 1351.










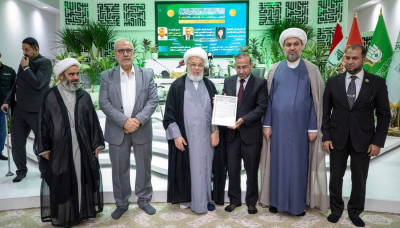





اترك تعليق