القرآن الكريم: كلام الله الموحى إلى رسوله الكريم( صلّى الله عليه وآله وسلّم)، أفئنّ مستلزمات فهم كلام الله هي نفسها مستلزمات فهم أي كلام عربيّ؟ أتسري قداسة النّصّ وقائله سبحانه إلى معانيه فلا ينالها إلاّ الخاصّة من البشر؟ أهذه المعاني من قبيل الرّحمة العامّة الّتي ينالها البرّ و الفاجر أم من قبيل الرّحمة الخاصّة الّتي كُتبت لعباد مخصوصين دون سواهم؟ في ذلك ثلاثة أقوال:
الأوّل: يرى أن القرآن الكريم كلام عربيّ، يتضمّن معارف عالية، ومسائل دقيقة "لا يختلف فيها الأذهان، من حيث التّقوى وطهارة النّفس، بل من حيث الحدّة وعدمها، وإن كانت التّقوى وطهارة النّفس معينين في فهم المعارف الطّاهرة الإلهيّة"[1] ، فهو إذن زاد معرفيّ، ينهل منه كلّ بحسب طاقاته العقليّة، ومواهبه الذّهنيّة، ولا شيء وراء ذلك.
الثّاني: يرى "أنّ خطابات القرآن ممّا يختصّ بأحباء الله المتألّهين، وأوليائه المقرّبين، لا المُبعَدين الممكورين، والجاحدين المٌنكِرين، ممّن ليس لهم نصيب من رزق معاني الآيات المبينة[2] ، إلاّ قشور الألفاظ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ ۖ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ...[3] إنّ أبا جهل ونظراءه، وشعراء الجاهليّة، مع عربيّتهم وبراعتهم في تلفيق الألفاظ، ونظم الأبيات، لم يسمعوا ولو حرفًا من هذا القرآن، ولم يفقهوا كلمة واحدة، لعدم حواسهم الباطنة ... تولّي أبي لهب، وأبي جهل، عن فهم القرآن، وعزلهم [4] عن السّمع مع عربيّتهم وقرابتهم الجسمانيّة، ليس لانصرافهم عن الصّرف واللغة، وتنحّيهم عن النّحو والفصاحة، ولا لانحرافهم عن أسلوب البلاغة، وعدولهم عن قوانين العبارة، ولا لأجل الصّمم في آذانهم، والعمى في عيونهم، وفقد القلب من صدورهم، ولكنّ العناية ما سبقت لهم بالحسنى، والله إنّ أبصار الجاحدين لأنّوار الحقّ لفي عيونهم، وإن أسماعهم في آذانهم، وإنّ قلوبهم في صدورهم، ثم والله إنهم وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ۚ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ[5]، أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ[6] ، عن إدراك الحقّ، فلأهل القرآن خاصّة أعين يبصرون بها، ولهم آذان يسمعون بها، ولهم قلوب يعقلون بها، دون غيرهم من الّذين هم عمي القلوب عن مشاهدة الأنّوار، صمّ العقول عن استماع ذكر الله وأحبائه، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ[7]،لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ[8]" [9].
الثّالث: يجمع بين القولين السّابقين، ويضع مراتب متعدّدة لفهم النّصّ القرآنيّ، فيختصّ كلّ صنف بمرتبة، يقول الزّركشيّ: "كتاب الله بحره عميق، وفهمه دقيق، لا يصل إلى فهمه إلا من تبحّر في العلوم، وعامل الله بتقواه في السّرّ والعلانية، وأجلّه عند مواقف الشّبهات، واللطائف والحقائق، لا يفهمها إلا من ألقى السّمع وهو شهيد، فالعبارات للعموم، وهي للسّمع، والإشارات للخصوص، وهي للعقل، واللطائف للأولياء، وهي المشاهدة ، والحقائق للأنبياء، وهي الاستسلام، ولكلّ منها وصف ظاهر، وباطن، وحدّ، ومطلع، فالظّاهر: التّلاوة، والباطن: الفهم، والحدّ: أحكام الحلال والحرام، والمطلع: أي الإشراق من الوعد والوعيد" [10]، أو يختصّ كلّ فرد بمرتبة تؤهّله لها إمكاناته الخاصّة، فيقول الطهرانيّ: "القرآن كتاب عميق، له درجات ومراتب، يتزوّد منه الجميع كلّ بقدر فهمه، ويمتلك في الوقت نفسه ظاهرًا واضحًا قابلاً لدرك عامّة النّاس، وباطنًا ذا منازل ودرجات، فكلّ يمضي فيه إلى درجة ومنزلة ما، لا يعدوها إلى غيرها من منازل القرآن، ولا يفهم معانيه العميقة وبواطنه. فضلاً عمّا يتطلّبه فهم باطن القرآن وحقيقته من التّزكية والطّهارة، فحقيقة القرآن وعمقه وباطنه ليست ممّا ينال بالمطالعة والقراءة فقط... فعلى من ينشد الوصول إلى حقيقة الطّهارة المطلقة متابعته والسّير على نهجه وخطّه، وبعبور عالم النّفس الأمّارة، ليقع ناظره على جمال الحضرة الأحديّة، ويصل إلى مقام التّوحيد المطلق. أي أنّ القرآن نفسه والعمل به سيأخذان بيده شيئَا فشيئَا، ودرجة فدرجة إلى الأعلى، ليفوز بالدّرجة العليا، ويحظى بالسّهم الأوفى. فالعلم بالقرآن يستوجب العمل به، وذلك العمل يستلزم ويستتبع علمَا أعلى، ثم أنّ ذلك العلم سيورث عملاَ أعلى، وهلّم جرَّا. فكلّ مرتبة، من مراتب العلم والعمل، في المرتبة الأدنى، تورث العلم والعمل في المرتبة الأعلى، حتّى يصلا إلى العلم المطلق، والعمل المطلق، أي العلم غير المتناهي والعمل الطّاهر الخالص المحض الّذي لا تشوبه شائبة، من أنانيّة، أو هوًى، أو نزوع إلى غير الله سبحانه".[11] يبدو للباحث أنّ القول الثّالث هو الرّاجح، لأنّه يراعي حقيقتين في النّصّ القرآنيّ:
إحداهما: أنّه كتاب هداية لعامّة البشر، وهذا يقتضي حدًَّا أدنى من الفهم يتيسّر لكلّ ذي لبّ يجيد العربيّة.
الأخرى: أنّه كتاب هداية لمن يؤمن به، مرتقيًا به في مسيرة تكامليّة إلى حيث الولاية الإلهيّة، والإيمان الّذي لا تشوبه شائبة، وهذا يقتضي إشراقات متدرّجة بحسب مراحل السّير إلى الله تعالى، قال ربّنا: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ[12]، ولعلّ ما رجّحناه يمكن أن يُلمَس في قول الغزاليّ: "الله عزّ وجلّ قال: فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ[13]، فظاهره تفسير واضح، وحقيقة معناه غامض، فإنّه إثبات للرّمي، ونفي له، وهما متضادّان في الظّاهر، ما لم يفهم أنّه رمى من وجه، ولم يرم من وجه، ومن الوجه الّذي لم يرم رماه الله عزّ وجلّ. وكذلك قال تعالى: قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ [14]، فإذا كانوا هم المقاتلين كيف يكون الله سبحانه هو المعذّب؟ وإن كان الله تعالى هو المعذّب بتحريك أيديهم فما معنى أمرهم بالقتال؟ فحقيقة هذا يُستمَد من بحر عظيم من علوم المكاشفات، لا يُغني عنه ظاهر التّفسير، وهو أن يعلم وجه ارتباط الأفعال بالقدرة الحادثة، ويفهم وجه ارتباط القدرة بقدرة الله عزّ وجلّ، حتّى ينكشف بعد إيضاح أمور كثيرة غامضة صدق قوله عزّ وجلّ: ، ولعلّ العمر لو أُنفق في استكشاف أسرار هذا المعنى وما يرتبط بمقدّماته ولواحقه لانقضى العمر قبل استيفاء جميع لواحقه، وما من كلمة من القرآن إلاّ وتحقيقها محوج إلى مثل ذلك، وإنّما ينكشف للرّاسخين في العلم من أسراره بقدر غزارة علومهم، وصفاء قلوبهم، وتوافر دواعيهم على التّدبّر وتجردّهم للطّلب ويكون لكلّ واحد حدّ في التّرقّي إلى درجة أعلى منه، فأمّا الاستيفاء فلا مطمع فيه، ولو كان البحر مدادًا، والأشجار أقلامًا، فأسرار كلمات الله لا نهاية لها، فتنفد الأبحر قبل أن تنفد كلمات الله عزّ وجلّ، فمن هذا الوجه تتفاوت الخلق في الفهم بعد الاشتراك في معرفة ظاهر التّفسير" . [15]
إنّ مستلزمات الفهم تختلف بحسب رؤيّة الدّارس، وحدود الفهم المتصوّر، فنقرأ للزّركشيّ تعريفه للتّفسير بأنّه "علم يُعرَف به فهم كتاب الله المنزل على نبيّه محمد (صلّى الله عليه وسلّم)، وبيان معانيه، واستخراج أحكامه وحكمه. واستمداد ذلك من علم اللغة والنّحو والتّصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات. ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والنّاسخ والمنسوخ" [16]، في حين نقرأ للآمليّ قوله: "إنّ المعرفة والمعروف من سنخ واحد، فإن كان المعروف محسوسًا يكفيه المعرفة الحسيّة، وإن كان متخيََّلاً أو موهومًا، يكفيه المعرفة الخياليّة والوهميّة، وإن كان معقولاً لا يكفيه إلاّ المعرفة العقليّة مع الانتفاع المقدّميّ من المعرفة الحسيّة والخياليّة، والوهميّة. وإمّا إن كان المعروف فوق ذلك، فلا يكفيه شيء منه أصلاً، بل لا بدّ من الشّهود القلبيّ، والخروج عن رهن الحسّ، وحبس الخيال، وقيّد الوهم، وحجاب العلم الحصوليّ العقليّ، وما إلى ذلك من الحجب الظّلمانيّة والنّورانيّة" [17]
إيـاد محمـّد علـــيّ الأرناؤوطيّ
[1] الميزان 3/ 48
[2] في المطبوع (المبين)، ويبدو أنّه خطأ مطبعيّ
[3] سورة الانفال 23
[4] في المطبوع (وإعزالهم)، والصّواب ما أثبتّه
[5] سورة البقرة 171
[6] الحج 46
[7] آل عمران 7
[8] الزمر 21
[9] مقدمة وتعليقات 86ـ 88
[10] البرهان 2/ 153
[11] نور ملكوت القرآن 2/ 30ـ 31
[12] العنكبوت69
[13] الأنفال 17
[14] التّوبة 14
[15] إحياء علوم الدّين 1/293
[16] البرهان 1/13
[17] علي بن موسى الرّضا والقرآن الحكيم 49ـ 50










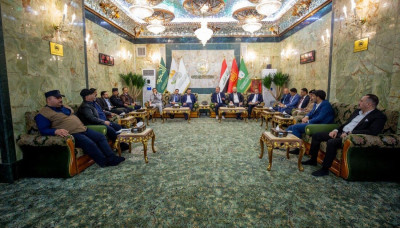





اترك تعليق