المبحث الأوّل: تعريفات[1]
تعريف الترغيب لغة واصطلاحاً
يُقصد بالترغيب في اللّغة: طلب الشيء والحرص عليه والطمع فيه[2]. وكذلك يعني التشويق والحث على فعل الشيء والرغبة والسؤال والطمع، ورَغَّبَه، أي: أعطاه ما رغب[3].
وفي الاصطلاح: كلّ ما يشوّق المدعو إلى الاستجابة، وقبول الحقّ والثبات عليه[4].
وعرّف النحلاوي الترغيب: «هو وعدٌ بصحبة تحبيب، وإغراء بمصلحة أو لذّة أو متعة آجلة مؤكّدة، خيرة خالصة من الشوائب، مقابل القيام بعمل صالح، أو الامتناع عن لذّة ضارّة، أو عمل شيءٍ ابتغاء مرضات الله، وذلك رحمة من الله لعباده»[5].
تعريف الترهيب لغة واصطلاحاً
يقصد بالترهيب لغة: الخوف والفزع[6].
وأمّا في الاصطلاح: فكلّ ما يخيف المدعو ويحذّره من عدم الاستجابة، أو رفض الحق، أو عدم الثبات عليه بعد قبوله[7].
وعرّفه النحلاوي: عبارة «عن وعيد وتهديد بعقوبة، تترتّب على اقتراف إثم أو ذنب ممّا نهى الله عنه، أو التهاون في أداء فريضة ممّا أمر الله به»[8].
تعريف المنهج لغة واصطلاحاً
ورد في قواميس اللّغة أنّ كلمة (منهج) تدلّ على الطريق الواضح المستقيم.
قال ابن فارس: «النون والهاء والجيم أصلان متباينان، الأوّل: النهج، الطريق، ونهج لي الأمر: أوضحه، وهو مستقيم المنهاج والمنهج: الطريق أيضاً...»[9].
وقال في الصحاح: «النهج: الطريق الواضح، وكذا المنهج والمنهاج، وأنهج الطريق، أي: استبان، وصار نهجاً واضحاً بيِّناً، ونهجت الطريق: إذا أبنته وأوضحته»[10].
وأمّا اصطلاحاً: «هو مجموعة الركائز والأُسس المهمّة التي توضّح مسلك الفرد أو المجتمع أو الأُمّة لتحقيق الآثار التي يصبو إليها كلّ منهم»[11].
تعريف التربية لغة واصطلاحاً
إذا رجعنا إلى معاجم اللّغة العربية وجدنا لكلمة التربية أُصولاً لغوية ثلاثة:
الأصل الأوّل: رَبا يربو بمعنى: زادَ ونما، فتكون التربية هنا بمعنى النمو والزيادة، كما في قوله تعالى: ﴿يَمْحَقُ الله الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾[12]، ﴿وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾[13]، ﴿وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّباً لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ الله﴾[14].
الأصل الثاني: رَبى يربي على وزن خفى يخفي، وتكون التربية بمعنى: التنشئة والرعاية، كما في قوله تعالى: ﴿قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيداً وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ﴾[15]، ﴿وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً﴾ [16].
الأصل الثالث: ربّ يربّ بوزن مدّ يمدّ بمعنى: أصلح الشيء، وتولّى أمره، وساسه وقام عليه ورعاه.
وأمّا تعريف التربية اصطلاحاً، فهي: العمل الذي يساعد الكائن الحي على أن ينمّي استعداداته الجسمية والفكرية، ومشاعره الاجتماعية والجمالية والأخلاقية؛ من أجل إنجاز مهمّته الإنسانية ما استطاع إلى ذلك سبيلاً[17].
وكذلك تعني عملية التدريب والاكتساب التي ينمو الكائن البشري بفعاليتها، ليصل إلى درجة الكمال الممكن في جسمه وعقله وروحه وسلوكه الاجتماعي[18].
أي: إنّ التربية تعني المؤثّرات الموجّهة، التي يراد منها أن تصوغ الإنسان وتوجّه سلوكه نحو الأفضل في كلّ نواحي الحياة، فتشمل حينئذٍ كلّ العوامل والأساليب التي تدخل في نطاق الفعاليات التهذيبية، والتمارين التي يتمّ اكتساب فضائل الحياة بموجبها، لذا فإنّ التربية هي النشاط الحياتي الذي يكسو الحياة الخير والصلاح[19].
وأمّا مفهوم التربية في كلام الأئمّة المعصومين عليهم السلام فهي لا تشتمل على تربية الأطفال فقط، بل تشمل تربية الأُمّة الإسلامية جمعاء في كلّ أشكالها، كتربية الأصحاب، وتربية الأزواج، وإنّ حياة أئمّة أهل البيت عليهم السلام حافلة بتربية وتعليم وتوجيه المسلمين إلى التقرّب إلى الله تعالى، والترغيب فيه، والحثّ على طاعته، فهم يتوسّلون لذلك بكلّ السبل، وشتّى الوسائل، ولم يقتصر برنامجهم التثقيفي على إلقاء الدروس فقط، بل تضمن السلوك العملي بالإضافة إلى الخطب، والوصايا، والكتب، كما حفظ لهم التاريخ بعض كلماتهم القصار، وهي لا تساويها مطوّلات غيرهم؛ لما اشتملت عليه من كنوز المعرفة، وعلاج الكثير من أمراضنا الاجتماعية، والدعوة إلى الحقّ والفضيلة، ففي أحاديث الإمام الحسين عليه السلام في التربية والأخلاق حين سُئل عن خير الدنيا والآخرة فكتب عليه السلام: «بسم الله الرحمن الرحيم، أمّا بعدُ، فإنّه مَنْ طلب رضا الله بسخط النّاس كفاه الله أُمور النّاس، ومَنْ طلب رضا النّاس بسخط الله وكله الله إلى النّاس، والسّلام»[20]، وسُئل عن معنى الأدب فقال: «هو أن تخرج من بيتك فلا تَلقى أحداً إلّا رأيت له الفضلَ عليك»[21].
المبحث الثاني: الترغيب والترهيب
إنّ الدين الإسلامي يشتمل على أكمل المناهج للحياة الإنسانية، ويحتوي على ما يسوق البشرية إلى السعادة والرفاه، هذا الدين عُرفت أُسسه وتشريعاته عن طريق القرآن الكريم، وهو ينبوعه الأوّل، ومعينه الذي يترشّح منه، والقوانين الإسلامية التي تتضمّن سلسلة من المعارف الاعتقادية والأُصول الأخلاقية والعملية، نجد منابعها الأصيلة في آيات القرآن العظيم.
قال تعالى: ﴿إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾[22]، وقال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾[23]، فالترغيب والترهيب يُكمّل أحدهما الآخر، فالترهيب يُستخدم في علاج السلوك المنحرف، وذلك أنّ النفس إن لم تؤدّب انقادت إلى الأهواء، ففسدت في طبعها، وأصبح الترهيب في هذه الحالة ضرورة ملحّة، وكذلك الترغيب فهو ضروري حتى تتوازن النفس؛ لأنّ الترغيب معناه الأمل والرجاء في وعد الله، وكلّما عملت النفس عملاً خيراً، كان لا بدّ من تبيان ثماره وعطاياه ومنحه[24].
ولهذين الأُسلوبين أُسسهما النفسية، فهما يعتمدان على إثارة الانفعالات، ومنها المحبّة والخشوع والرجاء والخوف، وفيهما أيضاً موازنة بين العواطف، فلا يطغى الخوف على الأمل، فيقنط المذنب من عفو الله ورحمته.
وهما أُسلوبان مناسبان لطبيعة النفس الإنسانية، فالإنسان يخاف ويرجو، ويحبّ ويكره، فضلاً عن ذلك، فإنّ هذين الأُسلوبين مناسبان للفروق الفردية، فمن الناس مَن يصلح معه الترغيب، والثواب، ومنهم مَن يصلح معه الترهيب والعقاب لتعديل سلوكه، وتعليمه، ومنهم مَن يحتاج إلى الأُسلوبين معاً[25].
وعليه، فإنّ أُسلوبي الترغيب والترهيب من الأساليب المؤثّرة نفسياً في مختلف الأفراد، ويكون ذلك عن طريق الإيحاء والتحفيز، وإثارة نوازع الخير في النفس البشرية، واستغلال ميولها الفطرية فيما يفيدها ويحقّق سعادتها وسرورها، ويجنّبها ما يؤذيها ويكون مصدر شقاقها وآلامها[26].
كما أنّ طبيعة الترغيب والترهيب في المنهج الإسلامي تتّسم باللامحدودية، فنجد القرآن الكريم إذا وضع مشوّقاً للسلوك الحسن، فإنّ هذا المشوّق ليس مجرّد جائزة تقديرية يزول أثرها في الحياة الدنيا، وليس درجة فخرية يتلاشى سرورها فور استلام مرسومها، بل هو يسمو إلى أن يبلغ درجة أعظم من ذلك دائمة وثابتة، وفي المقابل حين يضع القرآن الكريم مثبّطاً عن السلوك السيّئ، سواء كان وقائياً أو علاجياً؛ فإنّه يجعل العقاب المادي حميماً وجحيماً، وكذلك العقاب المعنوي، فهو إعراض الله وسخطه، وهذا ممّا لا يطيق بشر أن يتحمّله[27].
وممّا يزيد فاعلية الترغيب والترهيب في التربية الإسلامية، كونهما يتعاملان مع جوانب عديدة في الإنسان، فلا يخاطبان عقله فقط، وإنّما يناشدان روحه، ويلمسان وجدانه؛ فيدخلان النفس الإنسانية من منافذها، كما أنّهما يستندان إلى رصيد من الإيمان، وكلّما كان هذا الرصيد أكبر زاد تأثيرهما وقوي[28].
منهج الترغيب والترهيب في القرآن
إنّ للقرآن الكريم أهدافاً أساسية إذا عرفناها عرفنا بعض جوانبه الغامضة علينا، ومن أهدافه الأساسية تربية الإنسان وتزكيته وتعليمه وإصلاحه، وقد أشار إلى هدفية التزكية والتعليم بقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾[29]، فالآيات التي تُتلى على الأُميين تهدف إلى تزكيتهم، ثمّ تعليمهم الكتاب والحكمة، فالتزكية هي تنظيف النفس البشرية من رواسبها الجاهلية، سواء كانت من نوع الأفكار الباطلة، أو المعتقدات الفاسدة، أو الأخلاق السيّئة.
والتزكية مشتقّة من الزكاة وهي الطهارة، وأساس التزكية تقوية الإرادة والتحكّم في الأهواء والشهوات، بينما يهدف التعليم إلى إضافة المعارف الجديدة للإنسان؛ لدفع عجلة البشر إلى الأمام، وهذا يُشبه إلى حدٍّ كبير العلاقة بين تنظيف أرض زراعية من الأدغال والحشائش الضارّة، لتتسنّى زراعتها بالبذور المفيدة والأشجار المثمرة، فالشجرة المثمرة هي العلم، ولكنّه لا ينفع من دون تنظيف الأرض الإنسانية وصفحة النفس من الأخلاق الفاسدة والأفكار الباطلة، وهنا تكمل عملية التزكية والتعليم، وتأتي الواحدة متمّمة للأُخرى، وبهذا الجمع بين التزكية والتعليم يوجّه القرآن الناس إلى الحقّ، وهذه وسيلة تربوية تدعونا إلى التدبّر في آيات الله تعالى؛ لأنّها حقائق تربوية يتعرّض لها كتاب الله، لتثبيت المسؤولية الشخصية في نفوس الأُمّة ﴿إِنَّ الله لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾[30].
فهذا القانون الاجتماعي الذي تُشير إليه هذه الآية يربط بين الحضارة وبين تطوير الصفات النفسية، ويقول: كلّما كان بناء قوم أكثر من هدمهم تقدّمت بهم الحضارة، ولا يكثر البناء على الهدم على صعيد الواقع إلّا بعد وجود نفسيّة مناسبة على صعيد الذات، وهذا أُسلوب تربوي يتّبعه القرآن الكريم في تزكية النفس بما يتناسب معها من الآثار العاطفية والتوجّه الفكري والزخم الإيماني، إنّه أُسلوب يربط بين الفكرة الموظفة والهدف المنشود.
فهذا الأُسلوب التربوي وغيره من الأساليب التي يتّبعها القرآن الكريم تُعد مناهج علمية للتربية سبق البشرية جميعاً في استخدامها، ومنها أُسلوب الترغيب والترهيب الذي يدفع بالإنسان إلى عالم الرقي والكمال المنشود، ومنهج القرآن قاعدة شاملة ننطلق منها إلى تربية النفس والمجتمع، والتوصّل إلى النظام الكوني الأتمّ والأشمل، فالمهندس القدير مثلاً ينطلق من النظر إلى عمارة واحدة إلى معرفة القاعدة الهندسية التي قامت وفقها هذه العمارة، والطبيب الحاذق يستشف من وصفة طبّية القاعدة العلمية التي استند إليها ذلك الذي كتبها، وهكذا.
وآيات القرآن الكريم حافلة بأُسلوب الترغيب والترهيب المباشر وغير المباشر، فمرّة يتحدّث القرآن عن آيات يذكر فيها الجزاء والثواب والعقاب، فيرغّب في الثواب ويرهّب من العقاب، ومرّة يذكر العاقبة الحسنة للذين يخافون من الله تعالى، ومرّة يذكر العاقبة السيّئة للذين لا يخافون، بل يتعدّون حدوده تعالى، ولا يرغبون فيما عنده، ويذكر طريقة عقابهم في الدنيا والآخرة نتيجة أعمالهم السيّئة، ومرّة يذكر الذين يخافون والذين يرغبون ذكراً مباشراً، كلّ ذلك هو اتّباع لمنهج تربوي لصقل روح الإنسان وبنائه، وبيان الآثار التربوية لهذا المنهج، يقول تعالى في سورة الأنبياء: ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾[31].
فظاهر السياق أنّ ضمير الجمع في الآية يعود إلى بيت زكريا، وكأنّه تعليل لمقدّر معلوم من سابق الكلام، والمعنى أنّنا أنعمنا عليهم؛ لأنّهم كانوا يسارعون في الخيرات من الأعمال، ويدعوننا رغبةً في رحمتنا أو ثوابنا، ورهبةً من غضبنا أو عقابنا، ويدعوننا راغبين راهبين، وكانوا لنا خاشعين بقلوبهم[32].
وقد أشار الله (سبحانه) إلى ثلاث صفات من الصفات البارزة لهذه الأُسرة، وهي الخشوع الذي هو الخضوع المقرون بالاحترام والأدب، وكذلك الخوف المشفوع بالإحساس بالمسؤولية ﴿ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾[33]، فإنّ ذكر هذه الصفات الثلاث ربّما يكون إشارة إلى أنّ هؤلاء عندما يصلون إلى النعمة لا يبتلون بالغفلة والغرور كما في الأشخاص المادّيين من ضعفاء الإيمان، فهؤلاء لا ينسون الضعفاء والمحتاجين، بل يسارعون في الخيرات، ويتوجّهون إلى الله سبحانه في حال الفقر والغنى، والمرض والصحّة، فلا يبتلون بالكبر؛ لأنّهم كانوا خاضعين خاشعين أبداً[34].
فمن هذا المقطع من الآية نلاحظ المنهج التربوي للخوف والرهبة من الله تعالى، وكذلك الرغبة فيما عنده، وهما يدفعان بالإنسان إلى التحلّي بالأخلاق الحميدة وكسبها، ممّا يكون بناء يأخذ بيده إلى أعلى مراتب الرقي والسمو النفسي.
وقد ذكر القرآن الكريم في آية أُخرى من سورة البقرة منهجاً إلهياً للبشرية، يقول فيه موجّهاً الخطاب لبني إسرائيل: ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ﴾[35]، فقد ذكر سبحانه أوامر ثلاثة في هذه الآية، وهي: تذكر النعم الإلهية، والوفاء بالعهد، والخوف من الله، فتَذَكُّر النعم الإلهية يحفّز الإنسان للاتّجاه نحو معرفة الله سبحانه، وهو المنعم، وشكره، واستشعار العهد الإلهي الذي يستتبع النعم الإلهية يدفع الكائن البشري إلى النهوض بمسؤولياته وواجباته، ثمّ الخوف من الله وحده ـ دون سواه ـ يمنح الإنسان العزم على تحدّي كلّ العقبات التي تقف بوجه تحقيق أهدافه، والالتزام بعهده؛ لأنّ التخوّف الموهوم من هذا وذاك من موانع الالتزام بالعهد الإلهي، فالرهبة من الله تكسر كلّ حواجز الخوف من غيره، وقد تقدّم ضمير النصب المنفصل (إياي) على جملة (فارهبون) للحصر، أي: حصر الخوف بالخوف من الله وحده دون سواه[36].
وقد ذكر القرآن الكريم في سورة الشرح خطاباً للنبي صلى الله عليه وآله في الترغيب، حيث قال تعالى: ﴿فإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ * وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾[37]، وهذا الخطاب متفرّع على تحميله صلى الله عليه وآله الرسالة والدعوة منه تعالى، بما منّ عليه من شرح الصدر، ووضع الوزر، ورفع الذكر، وكلّ ذلك من اليسر بعد العسر، وعليه فالمعنى: إذا كان العسر يأتي بعده اليسر، والأمر فيه إلى الله لا غير، فإذا فرغت ممّا فرض عليك فأتعب نفسك في الله بعبادته ودعائه، وارغب فيه؛ ليَمنّ عليك بما لهذا التعب من الراحة، ولهذا العسر من اليسر.
فهذه دعوة وترغيب من الله تعالى لنبيّه فيما عند الله تعالى؛ لكي يقاوم النبي صلى الله عليه وآله المصاعب التي كانت تواجهه في تبليغ الدعوة والنهوض بها، وهذا المنهج قد اتّبعه القرآن الكريم في أغلب آياته، سواء كان بصورة مباشرةً كما مرّ من آيات، أو غير مباشرة، وهو كثير في القرآن، ونراه مجسّداً في الآيات التي تتحدّث عن المؤمنين وجزائهم الدنيوي والأُخروي، والكافرين ونتيجة أعمالهم وعقابهم في الدنيا والآخرة، فتركيز الأُسلوب القرآني على شخصية المؤمن وجزائه ترغّب وتحفّز الآخرين على الاقتداء به، وجعله أُسوةً لهم؛ لينهض عملهم وتفكيرهم للأفضل والأكمل، وكذلك التركيز على شخصية الكافر أو المنافق وخاتمته، بل وكلّ طريقة عَيْشه؛ لينفر منه العقلاء، ويكون ذلك سبباً في اختيارهم للأفعال التي تسير بهم نحو الرقي، وفي سبيل الخير وأعمال المعروف.
نخلص من ذلك كلّه إلى تركيز القرآن الكريم على مسألة الجزاء، فهو يركّز على أنّ المعاصي تحبط الحسنات في الدنيا والآخرة كالارتداد، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾، وكذلك الكفر والعناد يقول تعالى: : ﴿إنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآَيَاتِ الله وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ﴾[38]، ومن الطاعات يذكر ما يكفّر سيّئات الدنيا والآخرة، كالإسلام والتوبة يقول تعالى: ﴿قلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ الله إنَّ الله يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾[39]، ويذكر من الطاعات ما يكفّر بعض السيئات، ومن المعاصي ما يحبط بعض الحسنات، وما ينقلها من فاعلها إلى غيره كالقتل، قال تعالى: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ﴾[40]، ويذكر القرآن الكريم من المعاصي ما ينقل مثل سيئات الغير إلى الإنسان، قال تعالى: ﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾[41].
وغير ذلك كثيرٌ في القرآن الكريم، ممّا يبين عاقبة الذين كفروا وعاقبة الذين آمنوا، فالتأمّل والتدبّر في الآيات يُظهر أنّ في الأعمال من حيث المجازاة ـ أي: من حيث تأثيرها في السعادة والشقاء ـ نظاماً يخالف النظام الموجود بينها من حيث طبعها في هذا العالم، فعالم المجازاة ربما بدّل الفعل من غير نفسه، وربّما نقل الفعل وأسنده إلى غير فاعله، وربّما أعطى للفعل غير حكمه، إلى غير ذلك من الآثار المخالفة لنظم هذا العالم الجسماني، والقرآن يعلّل هذه الأحكام العجيبة الموجودة في الجزاء، كمجازاة الإنسان بفعل غيره، خيراً أو شرّاً، ويوضّحها بالقوانين العقلائية الموجودة في المجتمع، وفي سطح الأفهام للعامّة، وإن كانت بحسب الحقيقة ذات نظام غير نظام الحسن، فسينكشف للإنسان ما هو مستور عنه اليوم، يوم تُبلى السرائر، فالأُمّة الطالحة إذا غرقت في الرذائل والسيّئات أذاقها الله وبال أمرها، وآل ذلك إلى هلاكها وإبادتها، قال تعالى: ﴿أوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآَثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ الله بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ الله مِنْ وَاقٍ﴾[42]، ويُشير إلى الأُمّة الصالحة كذلك بنفس الأُسلوب فيقول تعالى: ﴿قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ الله عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ الله لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾[43]، فالفرد والأُمّة يُؤخذ بالحسنة والسيّئة، وإنّ الفرد ربّما ينعم بنعمة أسلافه ﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيّاً﴾[44]، كما أنّه يُؤخذ بمظالم غيره كآبائه وأجداده ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ﴾[45].
وبالجملة، إذا أفاض الله على أُمّة نعمة أو على فرد من أفراد الإنسان، فإن كان المنعم عليه صالحاً كان ذلك نعمة أنعمها عليه، وامتحاناً يمتحنه بذلك، كما حكى الله تعالى عن سليمان؛ إذ يقول: : ﴿قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ﴾[46]، فالآية تدلّ على أنّ نفس الشكر من الأعمال الصالحة التي تستتبع النعم، فهذا يرغّب الإنسان في الاستزادة منه.
وإذا كان المنعم عليه طالحاً كانت النعمة مكراً في حقّه، واستدراجاً وإملاءً يُملَى عليه، يقول تعالى: ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ﴾[47]، وهكذا في جميع جوانب القرآن الكريم الأُخرى.
المبحث الثالث: الترغيب والترهيب منهجٌ تربوي عند الإمام الحسين عليه السلام
يظلّ الحديث عن الإمام الحسين عليه السلام يشغف القلوب، ويجذب النفوس، ويستهوي الأحرار، ويستقطب المؤمنين... لماذا؟ إنّه الحسين عليه السلام، وما أدراك ما الحسين عليه السلام! إنّه صاحب الفضائل والمناقب، صاحب المقامات والمعارج، الذي يتمنّى الإنسان لو تكون له واحدة منها لتكفيه شرفاً ورفعةً، وفخراً وعزّةً... ولكن ثمّة محور في حياة الإمام عليه السلام لا يمكن التغاضي عنه، وهو كربلاء؛ حيث إنّها كانت مجمع فضائل الإمام عليه السلام، وخلاصة معالم شخصيته، فمَن أراد أن يقرأ الإمام الحسين عليه السلام لا يمكنه ذلك من دون الوقوف على كربلاء.
إنّها ملحمة أهل بيت النبوة عليهم السلام في مقارعة الطغيان، ومواجهة الضلال، إنّها الفرقان بين الحقِّ والباطل، إنّها الميزان في تشخيص الإيمان من الشرك والنفاق؛ من هنا كان الحديث عن الإمام الحسين عليه السلام، من أي زاوية، لا بدّ أن يُقرن بكربلاء، ولهذا صارت كربلاء الوجه البارز لحياة الإمام عليه السلام، والباب الواسع الذي يدخله الناس إلى رحاب الحسين عليه السلام، وها نحن نقف على أعتاب باب الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء، لنسلّط الضوء عبر سطور قليلة على منهج الإمام عليه السلام مع صحابته وأعدائه بالترغيب تارةً، والترهيب أُخرى؛ لنستلهم الدروس والعبر، فكلماته مدرسة لا يمكن الغياب عنها.
الحسين عليه السلام ومنهج الترهيب
في الأيّام التي التقى فيها الحسين عليه السلام الحر وهو يسايره، لم يترك الحسين عليه السلام إعلان منهجه الثوري، وكان عليه أن يعذر للقوم بما عنده من الحقائق، فخطب فيهم بصراحته المعهودة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جهة، وبتوعيتهم من جهةٍ أُخرى، فكشف لهم واقع النظام في الإثم والعدوان، وأعلن عن مكانته ودوره الرسالي، وشجب ظواهر الغدر والخيانة، واستنكر نقض العهد، وخلع البيعة، فقال: «أيّها الناس، إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال: مَن رأى سلطاناً جائراً، مستحلاً لحرام الله، ناكثاً لعهد الله، مخالفاً لسنّة رسول الله صلى الله عليه وآله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغيّر عليه بفعلٍ ولا قول كان حقّاً على الله أن يدخله مدخله.
ألا وإنّ هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان، وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد، وعطّلوا الحدود، واستأثروا بالفيء، وأحلّوا حرام الله، وحرّموا حلاله. وأنا أحق مَن غيّر، وقد أتتني كتبكم، وقدمت عليَّ رسلكم ببيعتكم، أنّكم لا تسلموني ولا تخذلوني، فإن تممتم عليّ ببيعتكم تصيبوا رشدكم، فأنا الحسين بن علي وابن فاطمة بنت رسول الله (صلّى الله عليه واله) نفسي مع أنفسكم، وأهلي مع أهليكم، فلكم فيّ أُسوة، وإن لم تفعلوا، ونقضتم عهدي، وخلعتم بيعتي من أعناقكم، فلعمري، ما هي لكم بنكر، لقد فعلتموها بأبي وأخي وابن عمي، والمغرور مَن اغترّ بكم، فحظّكم أخطأتم، ونصيبكم ضيّعتم»[48].
وكان لهذا الخطاب دلالته الثورية القاطعة، وفيه التعبير عن مكنونات ضمير الحسين في اضطلاعه بمهمّة التغيير دون سواه، فقد أورد فيه رواية رسول الله صلى الله عليه وآله في ضرورة التغيير بالقول والعمل لمبتدعات السلطان الجائر، المستحلّ لحرام الله، والناكث لعهد الله، والمخالف لسنّة رسول الله، والعامل بالإثم والعدوان.
وشرح بالإشارة الموحية ما عليه الحكم الأُموي من التزامه طاعة الشيطان، وتركه طاعة الرحمن، مع ما عليه الحاكمون الجائرون، من إظهار الفساد وتعطيل الحدود، والاستئثار، وتحليل حرام الله وتحريم حلاله.
وصرّح لهم بقدره الرسالي، بصفته أحقّ مَن يجب عليه التغيير، باعتبار موقعه القيادي، وقد استجاب لأنّ كتبهم قدمت عليه بالبيعة على ألّا يسلّم ولا يُخذل.
وهو بعد أحدهم في المواساة، نفسه مع أنفسهم، وأهله مع أهاليهم، ووِلْده مع أولادهم، لا يميّز نفسه وآله عنهم في شيء، فكلّهم أُسرة واحدة[49].
هذا هو نهج حفيد رسول الله محمد صلى الله عليه وآله في الدعوة والإصلاح، وأمّا نهج الباطل فهو نهج الشرب والسكر، الذي كان في عهد الخلفاء في الخفاء، أمّا في عهد يزيد ابن معاوية فقد خرجت هذه الظاهرة من طور الكتمان إلى طور الإعلان والإجهار، وكان يزيد بن معاوية أوّل خليفة يعلن عن هذا المنكر، ويتحدّى بذلك مشاعر المسلمين[50].
منهج الترغيب للحسين عليه السلام
حينما أنهى الحسين عليه السلام صلاته، قال لبقية أنصاره: «يا كرام، هذه الجنة فُتحت أبوابها، واتّصلت أنهارها، وأينعت ثمارها... وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله والشهداء الذين قُتلوا معه، وأبي عليه السلام يتوقّعون قدومكم، ويتباشرون بكم، وهم مشتاقون إليكم، فحاموا عن دين الله، وذُبّوا عن حرم رسول الله صلى الله عليه وآله»[51].
فتناخى أنصار الحسين عليه السلام فتوةً، وتطاولوا بسالةً ورجولةً، وقالوا للحسين عليه السلام ولحرمه: «نفوسنا لنفسك الفداء، ودماؤنا لدمك الوقاء، فوالله لا يصل إليك وإلى حرمك سوء وفينا عرق يضرب»[52].
وكان استباق أنصار الحسين عليه السلام إلى القتال مبارزةً، فكلّ مَن أراد القتال يأتي إلى الحسين عليه السلام فيودّعه ويستأذنه في القتال، قائلاً: السلام عليك يا بن رسول الله، فيجيبه الحسين عليه السلام: وعليك السلام، ونحن خلفك، ويقرأ قوله تعالى: : ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا الله عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَما بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴾[53].
أخذ أصحاب الحسين عليه السلام يسارعون إلى الميدان بحماس بالغ، فيقتلون ويقتلون واحداً تلو الآخر، على سبيل المبارزة تارةً وعلى سبيل الهجوم تارةً أُخرى، وبإزاء الدفاع بينهما، فكانت الملحمة الكبرى التي أتت عليهم جميعاً، وهم بين شاهرٍ سيفه، وطاعنٍ برمحه، ومسدّدٍ بسهمه في أفعالهم، وهم أيضاً ما بين تالٍ لقرآن، ومنذرٍ بالخطاب، ومرتجزٍ عند القتال في أقوالهم، وإذا اقترنت الأقوال بالأفعال، وتصافحت الضمائر والجوارح، وصدّق اللسان ما في الجنان، بلغ الهدف ذروته، وحقّق الرائد أُمنيته، وهكذا كان حالهم، فعمر بهم الميدان، حتى استؤصلوا بعد أن أبلوا في سبيل الله بلاءً حسناً، وعادوا مثلاً في المواساة والفداء.
ولم يسلم من أنصار الحسين عليه السلام إلّا ثلاثة: الضحاك بن عبد الله المشرفي، وعقبة بن سمعان مولى الرباب، زوجة الإمام الحسين عليه السلام، والمرقع بن ثمامة الأسدي، كما ذكر ذلك الطبري، ووثّقه شمس الدين[54].
هذا هو النهج التربوي للإمام في تربية أهل بيته وصحابته، من هنا كان لزاماً علينا الاهتداء والاسترشاد بطريق الإمام الحسين عليه السلام؛ لتفعيل حركة الإصلاح في أنفسنا أوّلاً، وفي المجتمع ثانياً، وبثّ هذه الثقافة في شتّى ميادين الحياة العلمية والعملية، في البيت، في المدرسة، في الجامعة؛ ليتسنّى لنا التغيير والإصلاح في المجتمع.
ثورة كربلاء منهاجٌ للترغيب والترهيب
إنّ الحسين عليه السلام حينما استقرّ المقام به في كربلاء، توجّه إلى مَن معه من الهاشميين والأنصار بشرح ما يدور حوله من البلاء، وإيراد ما رأى عليه المناخ السياسي، وواقع المسلمين، وتكفّل بالرّد على هذا الانحطاط بما يضمن الكرامة، فالحق لا يُعمل به، والباطل لا يُتناهى عنه، ولقاء الله هو السبيل وحده، والموت هو السعادة، ولا حياة مع الظالمين.
قال الحسين عليه السلام بعد حمده لله والثناء عليه: «أمّا بعدُ، فإنّه قد نزل من الأمر ما قد ترون، وإنّ الدنيا قد تغيّرت وتنكّرت، وأدبر معروفها، واستمرّت جداً، فلم يبقَ منها إلّا صبابة كصبابة الإناء، وخسيس عيشٍ كالمرعى الوبيل، ألا ترون أنّ الحق لا يُعمل به، وأنّ الباطل لا يُتناهى عنه؟! ليرغب المؤمن في لقاء الله محقّاً، فإنّي لا أرى الموت إلّا شهادة، ولا الحياة مع الظالمين إلّا برماً»[55].
وكان هذا الخطاب بمثابة المحرّك للوعي الديني في ضمائر أصحابه، والباعث على استقبال مشاعرهم سلباً وإيجاباً، ففاضت ردود فعلهم الإيجابية بانبعاثٍ ثوري، فيه الإصرار على الملحظ الفدائي، وفيه المواساة نيّةً وبصيرة، فيوالون مَن والاه، ويعادون مَن عاداه، وما كان ذلك إلّا نتيجة لتربية الإمام الحسين عليه السلام لصحابته والموالين له، وسنأخذ أحد الصحابة من أعيان أصحابه عليه السلام مثالاً لذلك، وهو الصحابي برير بن خضير الهمداني، وهو شيخ القرّاء في الكوفة، فقد قال: «والله، يا بن رسول الله، لقد منَّ الله تعالى بك علينا أن نقاتل بين يديك، تقطّع فيك أعضاؤنا، ثمّ يكون جدّك شفيعنا يوم القيامة»[56].
فالإمام الحسين عليه السلام، كان يواجه منكرات كبيرة لا يمكن الوقوف بوجهها والقضاء عليها إلّا بتضحيته بنفسه وأهله وأصحابه... وهكذا كان!
ولولا ثورة الإمام الحسين عليه السلام ضدّ يزيد لما بقي من الإسلام إلّا اسمه، و لانتشر الفساد والظلم والانحراف في كلّ شيء، وفي كلّ وقت؛ لكنّ استشهاد الإمام الحسين عليه السلام قد فضح فساد الحكم الأُموي، وأوضح التديّن المزيّف الذي كان يتظاهر به أمام الناس.
وعندما استُشهد الإمام الحسين عليه السلام وهو ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، وسيّد شباب أهل الجنة، وقدّم نفسه فداءً للإسلام، خلق ذلك تعاطفاً عارماً مع الحسين عليه السلام، وهو الأمر الذي أدّى إلى انتفاضات متتابعة بعد ثورة الإمام الحسين عليه السلام، للأخذ بثأره وثأر أهل بيته المظلومين.
وهكذا قدّم لنا الإمام الحسين عليه السلام درساً في التضحية والفداء بأغلى شيء، من أجل الدفاع عن الإسلام وثقافته وقيمه، ومحاربة المنكرات بمختلف أشكالها وألوانها وصورها.
منهج الترغيب للحسين عليه السلام ولادة شهداء للحرّية
إنّ محنة الاستضعاف في ملحمة الطف كانت محنة شديدة؛ لأنّ احتمال الظفر والنصر كان ضئيلاً جداً، ولم تكن المحنة في أنفسهم فقط، بل مُحنوا في أولادهم ونسائهم وممتلكاتهم، فكان الجميع يعلم أنّ نساءهم سوف تُسبى وتُسجن كبقية حريم الحسين عليه السلام، وكذلك أولادهم، وشملهم سوف يُشتّت، ودُورهم سوف تُصادر وتُحرق، وهكذا كلّ ما يملكونه سوف يُنسف تماماً، فهم عاشوا أيّاماً عديدة لهذا الامتحان، وأمّا الباقون فهم منكفؤون على أنفسهم، فمَن لم يكونوا أعداء، ولم يشاركوا في معسكر بني أُميّة وعمر بن سعد وعبيد الله بن زياد، فهم متخاذلون، منكبّون على أنفسهم على أقل التقادير، وكان بعض هؤلاء من الصحابة والتابعين ومن الأسماء اللامعة، بينما أصحاب الحسين عليه السلام عاشوا همّ طلاق الدنيا، وليس للحظة من اللحظات، وإنّما لعدّة أيّام، فتارة يُستشهد الإنسان فجأة، فهو يرى الحدث لحظات، ثمّ يُقتل، أمّا هنا فالأمر مختلف تماماً، فهم عاشوا الشهادة لأيّام وأسابيع؛ لأنّ قائدهم بشّرهم ونبّأهم بكلّ ما يجري عليهم وعلى عيالاتهم، وتراهم يجيبون إمامهم بقولهم: «والله، لا نخلّيك حتى يعلم الله أنّا قد حفظنا غيبة رسول الله صلى الله عليه وآله فيك، والله، لو علمت أنّي أُقتل ثمّ أُحيى ثمّ أُحرق حياً، ثمّ أُذرّ ويُفعل ذلك بي سبعين مرّة ما فارقتك»[57]، ويقول الآخر: «والله، لا نفارقك، ولكن أنفسنا لك الفداء، نقيك بنحورنا وجباهنا وأيدينا، فإذا قُتلنا كنّا قد وفينا وقضينا ما علينا»[58].
لقد كان لديهم اندفاع ونشاط وحيوية، ولم يُصِبهم أيّ زلزال أو اضطراب أو تملّل نفسي، وهذا هو العلو في همّة النفس ونجابتها، بل حتى نساؤهم كانت لهنّ هذه الامتحانات التي بدأت قبل محرم إلى ما بعد عاشوراء التضحية والفداء، فإنّ دعم هذه النسوة يزيد في الهمّة والقوّة للرجال.
إذاً، سؤدد شهداء الطف سببه هذا الامتحان الطويل، وفي كلّ ميادين النفس، ولم تكن لهم شهادة بأبدانهم ودمائهم فقط، بل شهادات علو نفساني، وفي ميادين كثيرة من فضائل النفس، فليس جهادهم كباقي الجهاد كما في شهداء بدر، فقد وعدهم الله بالنصر الدنيوي، ولكن شهداء الطف عاشوا شدّة الاستضعاف الذي يعبّر عنه بالقتل التدريجي، ونراهم يتمنّون القتل ألف مرّة، ليس فداءً لسيّدهم الحسين عليه السلام فحسب، بل لما دونه، لأهل بيته عليهم السلام، كما يقول زهير بن القين: «والله، لو وددت أنّي قُتلت، ثمّ نُشرت، ثمّ قُتلت، حتى أُقتل كذا ألف قتلة، وأنّ الله يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتية من أهل بيتك»[59].
نتائج البحث
أهمّ النتائج التي توصّلت إليها الباحثتان:
1ـ انتهج القرآن الكريم في سبيل هداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور وسائل وأساليب شتّى، كان من بينها الترغيب والترهيب، أحياناً الترغيب، وأُخرى الترهيب، وأحياناً الأُسلوبان معاً.
2ـ إنّ الإمام الحسين عليه السلام قد لخّص لنا ولكلّ الأجيال السابقة واللاحقة فلسفة نهضته المباركة، من خلال قوله الشريف: «وأنّي لم أخرج أشراً ولا بطراً، ولا مفسداً ولا ظالماً، وإنّما خرجت لطلب الإصلاح في أُمة جدي صلى الله عليه وآله أُريد أن آمر بالمعروف، وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدّي وأبي»[60]، فالإمام الحسين عليه السلام لم يخرج طلباً للسلطة، ولا حبّاً بمنصب دنيوي أو كرسي زائل، بل خرج طلباً لإعادة النبض الدافق إلى وريد الرسالة الإسلامية، التي أنهكتها الأهواء والمطامع من قبل الحكام الذين حاولوا جاهدين طمس معالم تلك الرسالة السماوية الخالدة من جهة، وتفريغها من محتواها الروحي والفكري من جهة ثانية.
3ـ الإصلاح الذي دعا إليه الإمام عليه السلام قد استخدم أساليب متعدّدة مع مَن تعامل معهم في نهضته، وكان من أبرزها الترغيب والترهيب.
4ـ الترغيب والترهيب يحتاجان إلى داعية حكيم، وفي بحثنا المتواضع كان خير داعية من أهل بيت النبوة عليهم السلام، وهو الإمام الحسين عليه السلام؛ ليضع الأُمور في نصابها، فمَن لا يؤثّر فيه أُسلوب الترغيب وثوابه، يؤثّر فيه الترهيب وعقابه.
5ـ لا بدّ من الالتزام بمنهج القرآن الكريم ومَن سار على نهجه، من الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله والأئمّة الميامين عليهم السلام، ومَن نحن بصدده هو سيّد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام.
6ـ لتفعيل حركة الإصلاح في المجتمع لا بدّ من التثقيف، ونشر الوعي بين التلامذة في المدارس وطلبة الجامعات بنهضة الإمام الحسين عليه السلام وحركته، وبيان أسباب نجاحها، وكيفية امتدادها عبر مئات السنين.
الخاتمة
إنّ فكر أهل البيت عليهم السلام الذين تربّوا أو نهلوا من فكر القرآن الكريم، قد ربّى أجيالاً، وسَيُربّي إلى يوم القيامة، فلقد كان أهل بيت الرحمة عليهم السلام وما زالوا أساتذةً وقادةً إلهيين، فهذا أمير المؤمنين عليه السلام، وهو أوّل تلميذ تتلمذ على يد أعظم قائد وأُستاذ، وأكمل مربٍّ، فهو الذي كان يقول: «أدّبني ربي فأحسن تأديبي»[61]، وهو أيضاً بدوره مربٍّ لأمير المؤمنين عليه السلام، وَلَده وتلميذه وأخوه البار، بل هو نفسه وروحه التي بين جنبيه، فقد كان أمير المؤمنين عليه السلام يتعبّد مع الرسول صلى الله عليه وآله، وهو يراه يقف من المساء إلى طلوع الفجر على أطراف أصابعه لعبادة ربّه، وعندما يُسأل في ذلك كان يقول: أفلا أكون عبداً شكوراً؟! وكان هذا حاله إلى عشر سنوات، فأنزل الله تعالى عليه بعدها: ﴿طه * مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْءَانَ لِتَشْقَى﴾[62].
وهكذا سار أمير المؤمنين عليه السلام على نهج سيّد المرسلين صلى الله عليه وآله، وقد عبد الله لا رهبةً من ناره، بل رهبةً من جلال قدسه، ولا رغبةً في جنته، بل رغبة في رضى ربّه، ولقد سار الحسين بن علي عليهما السلام على نهج أبيه المرتضى وأخيه المجتبى عليهما السلام في جميع مراحل حياته ومواقفه العملية، مثالاً للإنسان الرسالي الكامل، وتجسيداً حيّاً للخلق النبويّ الرفيع في الصبر على الأذى في ذات الله، والسماحة والجود، والرحمة والشجاعة، وإباء الضيم، والعرفان والتعبّد، والخشية لله، والتواضع للحقّ، والثورة على الباطل، ورمزاً شامخاً للبطولة والجهاد في سبيل الله، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وأُسوة مُثلى للإيثار والتضحية؛ لإحياء المُثل العليا التي هي شريعة جدّه سيّد المرسلين، حتّى قال عنه جدّه المصطفى صلى الله عليه وآله: «حسين منّي وأنا من حسين...»[63]، معبّراً بذلك أبلغ التعبير عن سموّ هذه الشخصية العظيمة التي ربّاها بيديه الكريمتين صلى الله عليه وآله[64].
ومن الإمام الحسين عليه السلام ترشّحت رشحات للصحابة من أنوار سيّدهم ومربّيهم، ومغذّيهم بفكر الله تعالى وتهذيبه، فهذا زهير بن القين يقول للإمام الحسين عليه السلام ما نصّه: «قد سمعنا يا بن رسول الله مقالتك، ولو كانت الدنيا لنا باقية، وكنّا فيها مخلّدين، لآثرنا النهوض معك على الإقامة فيها»[65]. فأورثتهم المعرفة حبّاً ورغبةً، فكانوا مخلصين له، فاستخلصهم لنفسه، ولم يرضَوا عنه بدلاً، فلم يرضَ لهم إلّا جنّة الخلد التي أعدّها الله لعباده المقرّبين.
والحمد لله ربّ العالمين.
الكاتب: أ. د. فاطمة عبد الأمير الفتلاوي / م. د. زهـراء رءوف المـوسـوي
مجلة الإصلاح الحسيني – العدد السادس عشر
مؤسسة وارث الأنبياء للدراسات التخصصية في النهضة الحسينية
___________________________________________
[1] جامعة بغداد/كلّية التربية للعلوم الصرفة (ابن الهيثم).
الجامعة المستنصرية/كلّية التربية الأساسية.
[2] اُنظر: ابن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللّغة: ج2، ص415.
[3] اُنظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج1، ص422.
[4] اُنظر: زيدان، عبد الكريم، أُصول الدعوة: ص437.
[5] النحلاوي، أُصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع: ص287.
[6] اُنظر: ابن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللّغة: ج2، ص447.
[7] اُنظر: زيدان، عبد الكريم، أُصول الدعوة: ص437.
[8] النحلاوي، أُصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع: ص287.
[9] ابن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللّغة: كتاب النون.
[10] الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح: ص681.
[11] عبد الرزاق عفيفي ومعالم منهجه الأُصولي، مجلة البحوث الإسلامية: العدد58، ص300.
[12] البقرة: آية276.
[13] الحج: آية5.
[14] الروم: آية39.
[15] الشعراء: آية18.
[16] الإسراء: آية24.
[17] اُنظر: توق، محيي الدين، وعدس، عبد الرحمن، أساسيات علم النفس التربوي: ص6ـ14.
[18] اُنظر: الرفيعي، عبد الرحمن، وصلاح مراد، مقدّمة في التربية وعلم النفس: ص12.
[19] اُنظر: الكرباسي، محمد صادق، الظواهر التربوية في أشعار دائرة المعارف الحسينية: ص27.
[20] الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص167.
[21] لجنة الحديث في معهد باقر العلوم عليه السلام، موسوعة كلمات الإمام الحسين عليه السلام: ص895.
[22] الإسراء: آية9.
[23] النحل: آية89.
[24] اُنظر: الشرقاوي، حسن، الأخلاق الإسلامية: ص159، وص160
[25] اُنظر: الهاشمي، عبد الرحمن عبد علي، الترغيب والترهيب أُسلوب إسلامي في التعليم خصائصه وأُسسه النفسية، (ملخّص بحث، جامعة بغداد/كلية التربية ـ ابن رشد): ص40.
[26] اُنظر: عبد الله، عبد الرحمن صالح، المرجع في تدريس علوم الشريعة: ص226.
[27] اُنظر: كحالة، عمر: ج1، ص62.
[28] اُنظر: الأغا ، 1986: ص62.
[29] الجمعة: آية2.
[30] الرعد: آية11.
[31] الأنبياء: آية90.
[32] اُنظر: الطباطبائي، محمد حسين، الميزان: ج14، ص518.
[33] الأنبياء: آية90.
[34] اُنظر: الشيرازي، ناصر مكارم، الأمثل: ج8، ص320.
[35] البقرة: آية40.
[36] اُنظر: الشيرازي، ناصر مكارم، الأمثل: ج1، ص152.
[37] الشرح: آية8.
[38] آل عمران: آية22
[39] الزمر: آية55.
[40] المائدة: آية29.
[41] النمل: آية25.
[42] غافر: آية21.
[43] يوسف: آية90.
[44] مريم: آية50.
[45] النساء: آية9.
[46] النمل: آية40.
[47] القلم: آية45.
[48] الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص304.
[49] اُنظر: جعفر، مهدي خليل، الموسوعة الكبرى لأهل البيت عليهم السلام (الإمام الحسين عليه السلام): ص136.
[50] اُنظر: الخوارزمي، محمد بن أحمد، مقتل الحسين: ج1، ص182، واُنظر: لجنة الحديث في معهد باقر العلوم، موسوعة كلمات الإمام الحسين عليه السلام: ص278، نقلاً عن النهضة الحسينية ومأساة العطش: ص78.
[51] لجنة الحديث في معهد باقر العلوم، موسوعة كلمات الإمام الحسين عليه السلام: ص536.
[52] الشاكري، حسين، سيرة الإمام الحسين عليه السلام: ص121.
[53] الأحزاب: آية23.
[54] اُنظر: جعفر، مهدي خليل، الموسوعة الكبرى لأهل البيت عليهم السلام (الإمام الحسين عليه السلام): ص197.
[55] الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج3، ص307.
[56] ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج4، ص323.
[57] ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8، ص177. ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف على قتلى الطفوف: ص36.
[58] ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8، ص177.
[59] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ص331.
[60] لجنة الحديث في معهد باقر العلوم عليه السلام، موسوعة كلمات الإمام الحسين عليه السلام: ص354.
[61] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج16، ص210.
[62] طه: آية1ـ2.
[63] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج43، ص271.
[64] اُنظر: المجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام، أعلام الهداية (الإمام الحسين عليه السلام): ص18.
[65] الإربلي، علي بن أبي الفتح، كشف الغمّة: ج2، ص31، نقلاً عن: جعفر، مهدي خليل، الموسوعة الكبرى لأهل البيت عليهم السلام (الإمام الحسين عليه السلام): ص144.










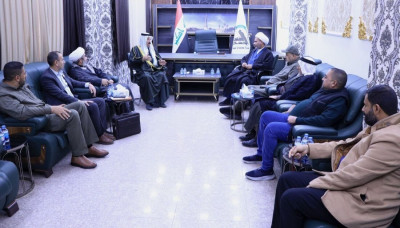








اترك تعليق